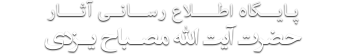ar_akhlag1-ch1_3.htm
القسم الأول
3
- المفاهیم الأخلاقیة العامّة فی القرآن الكریم
- الخیر والشر
- النور والظلام
- الحق والباطل
- البِرّ والفجور
- التقوى
- العلاقة بین التقوى والإحسان
- الصبر
- الإحسان، العدل والظلم
- كلمة قصیرة
المفاهیم الأخلاقیة العامّة فی القرآن الكریم
المفاهیم التی تستعمل فی الأفعال الأخلاقیة ولها قیمة أخلاقیة ومرغوبیة بالغیر هی مجموعة مفاهیم انتزاعیة عامّة، ومجموعة مفاهیم خاصّة تكون مصادیق لتلك المفاهیم العامّة. ونروم هنا دراسة المفاهیم القیمیة العامّة فی القرآن الكریم بمعناها الأخلاقی.
ومن البدیهی أنّ أوسع المفاهیم الأخلاقیة هما مفهوما (الصالح) و(السیّئ) فی مجال الأخلاق، أی فی الموارد التی تقع صفة للفعل الاختیاری للإنسان، وقد استعملت فی القرآن الكریم مفاهیم تعادل مفهومی (الصالح) و(السیّئ) فی مورد الأفعال الاختیاریة، كما أنّها تستعمل فی غیر هذه الموارد. وحینما تستعمل فی الأمور الأخلاقیة تلحظ ـ طبعاً ـ حیثیة الاختیار، وفی هذه الحالة تستعمل كصفة للفعل الاختیاری للإنسان، ولكنّ بعضاً آخر منها یختص بالأفعال الأخلاقیة ولا یستعمل خارج نطاق الأخلاق.
سنقوم هنا بدراسة المفاهیم الأخلاقیة العامّة فی القرآن الكریم بمقدار ما یسمح به المقال:
الخیر والشر
(الخیر) و(الشر) من جملة المفاهیم العامّة التی تستعمل فی غیر الأمور الأخلاقیة أیضاً، وقد استعمل لفظ (الخیر) فی القرآن تارة بمعنى (أفعل التفضیل) بمعنى (أخیَر) قد حذفت منه الهمزة، وتارة بنحو وصفی مجرّد عن المفهوم التفضیلی. وإذا سلّمنا أساساً بأن (خیر) مأخوذ من (أخیر) وله معنى تفضیلی دائماً فلابدّ أن نسلّم بانّه قد تجرّد عن هذا المعنى فی بعض الموارد، قال تعالى فی موضع:
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ.1
وفی موضع آخر:
وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْر فَلاَِنْفُسِكُمْ.2
فلفظ (خیر) فی الآیتین وأمثالهما لیس له مفهوم تفضیلی أولاً، ولیس صفة لفعل اختیاری، بل استعمل كصفة للمال وهو عین خارجی ثانیاً.
وقد اطلق الخیر بمفهومه التفضیلی على الله سبحانه. قال تعالى:
وَاللهُ خَیْرٌ وَأَبْقى.3
أو على السعادة الأبدیة التی هی نتیجة لأفعال الإنسان الاختیاریة من قبیل قوله تعالى:
وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقى.4
وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقى.5
لقد اُطلق (خیر) فی الموردین هذین على الأعیان ولیس من المفاهیم الأخلاقیة. الاّ أنّه قد استعمل فی آیات اُخرى كصفة للأفعال الاختیاریة، قال تعالى مثلاً:
فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً.6
انّ (خیر) فی هذه الآیة جاء كصفة لعمل اختیاری وهو «ردّ النزاع الى الله والرسول» فله إذنْ مفهوم قیمیّ وأخلاقی. الضابط العامّ هو أنّ لفظ (خیر) حیثما جاء صفةً للفعل الاختیاری للإنسان كان له مفهوم أخلاقی.
السؤال هنا هو: على أیِّ فعل من أفعالنا الاختیاریة یطلق (الخیر) وما هو معیار خیریّته؟
للجواب نقول: إنّ العمل الذی له دور ایجابی فی تحقیق كمال الإنسان، أی العمل الذی یسعى الإنسان بادائه للوصول الى مقصوده وغایته النهائیة سیكون خیراً بسبب تأثیره فی ضوء ذلك المطلوب بالذات والغایة النهائیة، أی لكونه سبباً وواسطة للوصول الى الغایة النهائیة والخیر بالذات فهو خیر بالواسطة ومطلوب بالغیر اصطلاحاً ومنه ینتزع معنى (القیمة الأخلاقیة).
ممّا ذكر نستنتج أنّ (الخیر) لیس ـ فی ذاته ومطلقاًـ معیاراً للقیمة الأخلاقیة، بل یكون أخلاقیاً مع ملاحظة القیود المذكورة، كما أنّ (الشر) یكون أخلاقیاً فیما لو أطلق على الفعل الاختیاری، والفعل الذی له دور سلبی فی تحقّق كمال الإنسان یكون (شرّاً).
فالشرُّ أیضاً یكون بملاحظة هذه القیود مفهوماً أخلاقیاً وذا قیمة أخلاقیة سلبیة وبكلمة اُخرى: اللاّقیمة.
النور والظلام
فی القرآن الكریم مفاهیم عامّة اُخرى تستعمل فی موارد الأفعال الاختیاریة وغیرها، ویُتوهّم أنّها بمثابة المعیار للقیم الأخلاقیة، ومنها مفهوم النور، والظلمة، والحق والباطل.
لقد بیّن القرآن فی الكثیر من الآیات أنّ المؤمنین والصالحین فی نور أو یدخلون النور أو یتضاعف نورهم، وعلى العكس یعیش الكافرون والطالحون فی الظلمة أو یدخلون الظلمة أو تشتد ظلمتهم. وفی بعض الآیات اُطلق مفهوم النور على الله، قال تعالى:
اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ.7
كما اُطلق النور على الأنوار الطبیعیة، قال تعالى:
هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَالْقَمَرَ نُوراً.8
وهكذا الظلمة قد استعملت فی الظلمة المادیّة، فمثلاً قال تعالى:
یَخْلُقُكُمْ فِی بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْق فِی ظُلُمات ثَلاث.9
وعلیه فانّ مفهومَیِ (النور) و(الظلمة) لیسا أخلاقیین فی مورد من الموارد المذكورة، لانّهما لم یستعملا كصفة للفعل الاختیاری للإنسان، ولم نلحظ فی القرآن الكریم مورداً آخر وصف فیه عمل اختیاری وأخلاقی بمفهوم (النور) أو (الظلمة) أبداً، وإن لاحظنا موارد تطبیقیة لـ (النور) و(الظلمة) فیمكن القول بأنهما وصفان لنتائج أفعال اختیاریة للإنسان، كقوله تعالى:
أَ وَمَنْ كانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ فِی النّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُماتِ لَیْسَ بِخارِج مِنْها.10
وقوله تعالى:
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِكُمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَیَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ.11
وتقول آیة اُخرى:
اللهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ.12
وبملاحظة استعمال مفهومی (النور) و(الظلمة) فی هذه الآیات كصفتین للنتائج الأخلاقیة یمكن القول: إنّهما لم یستعملا فی القرآن الكریم كصفتین للأفعال الأخلاقیة ومفهومین قیمیّین بالمعنى الأخلاقی أبداً.
الحق والباطل
لعلكم شاهدتم أشخاصاً یعرّفون معیار القیمة الأخلاقیة الایجابیة بانّه (الحق) ومعیار القیمة الأخلاقیة السلبیة بانّه (الباطل) ویحسبون أنّ العمل المتضمّن للقیمة الأخلاقیة من وجهة نظر الإسلام هو أن یكون (حقاً) والعمل الفاقد للقیمة هو أن یكون (باطلا). ولكن بالتأمّل فی الآیات القرآنیة یُعلم أنّ مفهومی الحق والباطل من المفاهیم العامّة ولا یختصان بالقضایا الأخلاقیة.
وقد أوضحنا فیما سبق13 أنّ الحق والباطل كأنّهما مشتركان لفظیان، ولهما من الإستعمالات المختلفة والكثیرة ما یشكل معها وجود مفهوم مشترك معها، وغایة الجهود فی هذا المجال تنتهی الى بیان المناسبات بین هذه المفاهیم المتنوعة وتبرّر الإنتقال من بعضها الى البعض الآخر.
لقد استعمل (الحق) تارة فی ذات الله تعالى، وتارة فی أفعاله، كما استعمل كمفهوم اعتباری محض فی بعض الموارد، كقوله تعالى:
وَالَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسّائِلِ وَالَْمحْرُومِ.14
أو من قبیل (حق الشفعة) و(حق الخیار) وأخیراً هناك إطلاق آخر لهذا اللفظ الى جانب الموارد المذكورة، وذلك فی مجال الأفعال الاختیاریة وهو: إنّ كلّ عمل اختیاری ذی هدف معقول یعتبر (حقاً) كما أنّ العمل الفاقد لهدف عقلائی ولا ینتهی بغایة مسوّغة یكون (باطلاً) وعلیه فانّ الأفعال الأخلاقیة التی تمثّل قسماً من الأفعال الاختیاریة للإنسان تعتبر من مجموعة الموارد المتعدّدة والمصادیق المتنوعة لمفهومَی (الحق والباطل).
ربما یتمسك الذین عرّفوا (الحق) و(الباطل) كمعیار للأخلاق فی اثبات هذه الدعوى بأن (الله حق):
ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ.15
أو بأن خلق السماء والأرض حق:
خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ.
ولكن لا یصحّ فی الحقیقة هذا الإستدلال ولا تلك الدعوى.
أمّا الإستدلال فلأنّا لو تأملنا لعرفنا أن لمفهوم الحق فی باب الأخلاق خصوصیته ویختلف تماماً عن مفهوم (الحق) الذی یطلق على الله أو خلق الأرض والسماء، فهذا الإستدلال ـ فی الحقیقة ـ مغالطة لا أكثر، كما أنّ إطلاق (الحق) فی عالَم الخلق والتكوین لا علاقة له بمفهومه القیمیّ والأخلاقی ولا یمكن أن یكون معیاراً له.
وأمّا الدعوى فلأن (الحق) و(الباطل) بمعنیَیهما القیّمین لا یمكن أن یكونا ملاكین ومعیارین للأخلاق والقیمة الأخلاقیة، إذ إنّهما بهذا الإعتبار لیسا سوى مفهومی (الصالح) و(السیّئ)، فكما لا یمكن القول: انّ ملاك صلاح الأعمال هو صلاحها، أو إنّ ملاك سوء الأفعال هو سوؤها فانّه لا یمكن القول: إنّ ملاك صلاح أو سوء الأفعال هو كونها حقاً أو باطلا.
فهذا القول یشابه الكلام المنسوب الى زرادشت الذی یُنقل أنه أوصى بـ (القول الحسن، والفعل الحسَن والتفكیر الحَسن) حیث لا یتضمن تعریفاً بالحُسن والصلاح ولا یبیّن معیاراً للقیمة الأخلاقیة.
المهم هو أن نعرف معنى الصالح، وأیّ عمل یكون عملاً صالحاً؟ وما هو معیاره؟ وفی نطاق هذا السؤال لا یمكن القول: انّ معیار صلاح العمل هو حقانیّة ذلك العمل، لأنّ هذا السؤال یتكرّر بصورة اُخرى هی: ما معنى (الحق)؟ فإذا لم یكن للفظ (الحق) فی مجال الأفعال الأخلاقیة مفهوم سوى مفهوم (الصالح)، إذنْ حینما نقول: إنّ الملاك فی الأفعال الأخلاقیة هو (حقانیّتها) فانّه یكون نظیر ما إذا قلنا: ملاك العمل الأخلاقی هو (الصلاح) حیث لا یعطی تعریفاً زائداً، ولا ملاكاً واضحاً للتطبیق.
نعم، إذا فسّرنا (الحق) بانّه الأمر الذی له تأثیر ایجابی فی وصول الإنسان الى المقصود النهائی فانّه سیتضمّن مفهوماً إضافیّاً، فعندما نقول: یجب أن یكون العمل (حقاً) فانّه یعنی أن تكون له نتیجة مطلوبة، وهذا یرجع فی الحقیقة الى ما قلنا فی الفصل الأول من أنّ أحد المبادئ المقرّرة فی أیّ نظام أخلاقی هو وجود الغایة، وفی جمیع القواعد الأخلاقیة سیكون هذا المبدأ ملحوظاً كغیره من المبادئ المقرّرة. وعلیه سوف لا نصل الى نتیجة واضحة من خلال مفهومَی (الحق) و(الباطل) لدى الكشف عن ملاك (الخیر) و(الشر) و(الحُسن) و(القُبح) فی الأفعال الأخلاقیة.
البِرّ والفجور
مفهوم (البِرّ) من المفاهیم الخاصّة بالأفعال الاختیاریة ولا یستعمل فی غیرها، وفی التعبیر القرآنی یكون مفهوم (البِرّ) أعمَّ المفاهیم فی مجال الأفعال الأخلاقیة حیث استعمل فی عدة موارد من سورة البقرة من قبیل قوله تعالى:
لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ.16
وقوله تعالى:
وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها.17
یستعمل لفظ (البِرّ) فی الأفعال الاختیاریة والأخلاقیة فقط بمعنى العمل الصالح، ولكنه یختلف عن مفهوم الصالح ـ الذی یرد كصفة للعمل الاختیاری وللاشیاء والأشخاص أیضاً ـ. فلا تُطلق صفة (البِرّ) على شخص أو شیء فی الخارج.
وفی مثل هذه الموارد یستعمل عادةً ألفاظ مثل (صالح) و(خیر) و(حسَن). وعلیه فانّ (البِرّ) یختص بالأفعال الصالحة لا مطلق الأمور الصالحة.
وإزاء لفظ (البِرّ) یصعب العثور على لفظ یقابله تماماً، ویشمل كلّ أضداده ویكون مثلاً كلفظ (السیّئ) مقابل (الصالح).
ویستعمل لفظ (الإثم) أحیاناً مقابل لفظ (البِرّ) كما قال تعالى:
وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوانِ.18
و(السیئة) تتضمن أیضاً مفهوماً مخالفاً لمفهوم (البِرّ) ولكنها على خلاف مفهوم (البِرّ) لا تختص بالأعمال الاختیاریة، كما أنها تطلق على نتائج الأعمال والحوادث نفسها كما فی قوله تعالى:
إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِها.19
فی هذه الآیة اطلقت السیئة على الحادث المؤسف.
واللفظ الآخر الذی استعمل مقابل (البِرّ) هو لفظ (الفجور)، حیث وُضع لفظ (فجّار) مقابل لفظ (الأبرار) فی عدد من الآیات، قال تعالى فی آیة:
كَلاّ إِنَّ كِتابَ الأَْبْرارِ لَفِی عِلِّیِّینَ.20
وقبل ذلك وبنحو التقابل قال تعالى:
كَلاّ إِنَّ كِتابَ الفُجّارِ لَفِی سِجِّین.21
لقد وُضع (الفجّار) فی الآیة مقابل (الأبرار) فی الآیة السابقة، وفی مواضع اُخرى أیضاً من سورة الدهر، والانفطار و.. ولكن من موارد استعمال لفظ (الفجور) المختلفة یمكن أن نفهم عدم تقابله للفظ (البِرّ) تماماً حیث یعتبر لمعناه حدود أضیق، ومن جهة اُخرى یستعمل أحیاناً مقابل لفظ (التقوى)، قال تعالى:
أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ كَالْفُجّارِ.22
وفیها یكون الفجّار والمتّقون متقابلَین.
ومن الألفاظ التی قد تستعمل مقابل لفظ (البِرّ) هو لفظ (جرم) وهو یشابه الألفاظ السابقة تقریباً، ولیس فی النقطة المقابلة للفظ (البِرّ) تماماً.
وبصورة عامّة ینبغی الإلتفات الى هذه الملاحظة ـ وترتبط بفقه اللغة ـ وهی:
فی اللغة قد یوضع لفظٌ لمعنى ولكن لم یوضع لفظ للمفهوم المقابل تماماً. فی هذه الحالة إذا شاؤوا وضع لفظ یقابل ذلك اللفظ فانّه لا یكون بكلّ معناه ضداً أو نقیضاً له، بل سیكون من مصادیق نقیضه، ویمكن القول: یوجد فی لفظ (البِرّ) مثل هذا الوضع، أی لم یوضع ولا یوجد فی اللغة العربیة مفهوم خاصّ یقابل (البِرّ) تماماً، ولذا لا مفرّ من استخدام ألفاظ اُخرى فی هذا المجال.
نستنتج ممّا ذكر أن مفهوم (البِرّ) هو أحد المفاهیم الأخلاقیة الخاصّة الأوسع فی عمومیتها، ومع ذلك لیس بوسعنا الإنتفاع بهذا المفهوم فی مجال الكشف عن الملاكات الأخلاقیة، لأنّا نفهم أن (البِرّ) یعنى العمل الصالح، ولكن لا یستفاد منه تعیین العمل الصالح، فلابد من الكشف عن معیار الصلاح من موضع آخر وحقائق اُخرى، بل (البِرّ) یعادل (الإحسان) فی الفارسیة تماماً.
وعن أصل اللفظ قام كبار اللغویین ببحوث وذكروا وجوهاً لا تخلو عن تكلّف فقالوا ـ مثلاً: إنّ البِرّ مشتق من مادة (البَرّ) التی تقابل (البحر)، والبَر یعنى الصحراء أو الأرض الیابسة الواسعة، وهذا اللفظ یدلّ على السعة وعلیه فانّ (البِرّ) یدلّ على التوسع فی الخیر وكثرة الأعمال الصالحة. الاّ أنّ هذا القول لا یخلو عن تكلّف لانّه إذا كان استعمال (البِرّ) بهذا اللحاظ فانّ البحر أوسع من البَر فیكون استعمال كلمة البحر فی الزیادة والكثرة أكثر شیوعاً. ومن جهة اُخرى لا ملازمة بین البَرّ وبین السعة والكثرة، فانّ العمل الصالح الواحد لا یفقد شیئاً من حقیقة البِرّ. إنّ البحث عن الأصل اللغوی بهذا النحو لا یساعد على تفسیر معنى اللفظ فحسب بل یكون أحیاناً مضلاّ أیضاً. إنّ مفهوم (البِرّ) ـ كما قلنا ـ یعنی الإحسان ومن المفاهیم الواضحة جدّاً، والبحث عن وجود أصل مشترك له مع (البَر) أو كلمة اُخرى لا یحلّ مشكلتنا. إنّ مفهوم (البِرّ) محكوم بالإشتراك اللفظی مع سائر المفاهیم التی تتركب من (ب) و(ر) وصفته بَرّ أو بارّ ویعنى الإنسان الصالح، ولا علاقة له بالبَر بمعنى الأرض الیابسة أبداً، فانّ هذا لفظ مشتق وذلك جامد.
كلّ ما یراه الناس صالحاً فهو (بِرٌّ) فی عرفهم، وبعض الناس ـ طبعاً ـ كانوا یعتبرون بعض الآداب والتقالید والرسوم المعتبرة فی المجتمع (بِراً) وإن كانت ناشئة من أصول أسطوریة بل من الخرافات.
والقرآن الكریم یعتمد هذا المعنى وهو أن قوام (البِرّ) لا یرجع الى التقالید والرسوم أو أمور ذات جذور خرافیة بل له أساس عقلی ومنطقی، ففی الجاهلیة كان بعض الرسوم مألوفاً بین العرب ویعتبرونه (بِراً) فمثلاً: كان من آدابهم أن لیدخلوا بیوتهم من أبوابها أیام الحج، ویعتقدون أنّ الشخص اذا أراد دخول البیت أیام الحج فمقتضى البِرّ هو أن یدخل عبر الجدار بدلاً عن الباب، وكان ذلك أمراً جاهلیاً باطلاً ولیس له أیّ أساس منطقی، ولذا تصدّى له القرآن وقال:
وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها.23
من هنا یتضح أنّ ما یعتقده بعض علماء الاجتماع من أنّ الأخلاق هی مجرّد أمر تعاقدی ولیست له أیة واقعیة، بل ینشأ من الآداب الاجتماعیة هو اعتقاد غیر صحیح فی الرؤیة الإسلامیة. و(البِرّ) فی هذه الرؤیة ذو أصل واقعی ومنطقی وعقلائی والأخلاق لیست مجرّد تقالید وآداب لا أساس لها، وعلیه لا یمكن ولا ینبغی اعتبار الأعمال الخرافیة بِراً وإن كانت مقبولة فی مجتمع مّا.
لقد استعمل لفظ (بِر) ومشتقاته من قبیل لفظ (بَر) ویجمع على (برَرة) و(أبرار) عشرین مرّة فی القرآن الكریم، ویوضع لفظ (فجّار) عادةً مقابل (أبرار) و(فُجور) مقابل لفظ (بِر).
التقوى
هناك مفاهیم عامّة وقیمیة اُخرى فی باب الأخلاق هی أخص من مفهوم (البِرّ) وأضیق منه، أحدها مفهوم (التقوى) الذی عرّف فی القرآن الكریم كعامل لسعادة وفلاح الإنسان وأكد على الإلتزام به بشدّة، قال تعالى فی بدایة سورة البقرة:
ذلِكَ الْكِتابُ لا رَیْبَ فِیهِ هُدىً لِلْمُتَّقِینَ.24
ثمّ ذكر الصفات البارزة للمتقین كالإیمان، والصلاة، والانفاق والیقین على التوالی، وأخبر أخیراً بأنّهم هم المفلحون.
أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.25
وفی آیات عدیدة اعتبر (التقوى) نفسه ومصادیقه والأعمال المتصفة به عاملاً للسعادة الأبدیة والاُخرویة ومُبیحاً للدخول فی الجنة، من قبیل:
إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنّات وَنَهَر * فِی مَقْعَدِ صِدْق عِنْدَ مَلِیك مُقْتَدِر.26
وفَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ.27
أو وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقى.28
وإِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفازاً * حَدائِقَ وَأَعْناباً.29
بناءً على ذلك یطلق (التقوى) كمفهوم عامّ على الكثیر من الأفعال الصالحة، بل یتّحد مع جمیع الأعمال الصالحة مصداقاً.
ومن حیث التحلیل المفهومی والبحث عن الأصل اللغوی فانّ لفظ (التقوى) كان فی الأصل (وَقْوى) واسم مصدر من (اتّقى ویتّقی) المشتق من مادة (الوِقایة) ومن هذه المادة تستعمل فی اللغة العربیة ثلاثة ألفاظ على نحو الترادف هی (تقوى)، (تُقاة) و(تَقیّة) وإن لم تستعمل (تَقیّة) فی القرآن الكریم بل استعمل (تُقاة) بدلاً عنها فی مورد التقیّة، قال تعالى:
إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً.30
فی هذه الآیة استعملت (تُقاة) بمعنى (تَقیّة) نفسها، وقد استعملت (التقیّة) فی نهج البلاغة بمعنى (التقوى)،31 وبعد عصر أمیر المؤمنین (صلوات الله وسلامه علیه) أصبحت (التقیّة) بین المسلمین ذات معنى خاصّ، واستعملت بمعنى اخفاء المذهب لدى مواجهة الخطر الذی یهدد الإنسان، وإن لم یوجد فارق فی الأصل اللغوی ـ كما ذكرنا ـ بین التقوى، والتقاة والتقیة.
ومادة الوقایة تستعمل فی الموارد التی یشعر الإنسان فیها بالخطر فیسلك سلوكاً خاصّاً صوناً لنفسه، فیقال فی هذه الحالة: (إنّه اتقى) أی إنّه حفظ نفسه وسلك ذلك السلوك الخاص. (التقوى) بهذا المفهوم وهو أن یقوم كلّ إنسان بعمل ما حینما یجتنب ویحذر شیئاً حفظاً لنفسه لیس مفهوماً أخلاقیاً، وفی الرؤیة القرآنیة تلاحظ فی مفهومه الأخلاقی خصائص اُخرى.
الخصیصة الاُولى: أن یكون الخطر المتحفَّظ منه صادراً من فاعل مختار، أمّا الخطر المتوجه من السماء أو العوامل الطبیعیة الاُخرى والذی یحذره الإنسان ویبادر لحفظ نفسه منه فلا علاقة له بالأخلاق.
الخصیصة الثانیة: أن یتوجه الخطر المذكور الى سعادة الإنسان الأبدیة والكمال اللائق به، لانّه فی الرؤیة الإسلامیة یكون مثل هذا الخطر العظیم والدائم هو الجدیر بالإهتمام من قبل الإنسان المؤمن.
الخصیصة الثالثة: إنّ الإنسان المتقی یتحلّى بالتقوى أمام الله فی الحقیقة ویخشى منه، لأن الرؤیة التوحیدیة تستدعی أن یعتقد الإنسان أنّ كلّ نفع وضرر یكون من الله، وإن كانت هناك عدة وسائط فانّ الموحّد یرى الفعل الإلهی وراء الأسباب والشرائط والمعدّات.
إذنْ إذا توجه خطر الى الإنسان المسلم فانّه یرى أنّ العلة الاُولى والفاعلة التی توجِّه ذلك الخطر إلیه هو الله سبحانه، فانّ تأثیر كائنات الوجود كافة ینشأ من الله عزّ وجلّ أساساً واستقلالاً.
بملاحظة هذه الخصائص وهذه الرؤیة التوحیدیة یكون التقوى فی الرؤیة الإسلامیة بهذا المعنى: أن یخشى الإنسان الخطر المتوجّه الى سعادته الأبدیة بسبب فعله الاختیاری أو تركه، وبما أن مقتضى الرؤیة التوحیدیة هو توجه هذا الخطر إلیه أخیراً من قبل الله تعالى فانّه یخشى الله الذی هو المؤثر الحقیقی، ویقوم بما یدفع هذا الخطر، ویطلق على من یمارس هذا العمل تجاه مثل هذا الخطر (المتقی) وعلى سلوكه الخاصّ هذا (التقوى)، بناءً على هذا یوجد دائماً خوف سابق فی مورد التقوى یدفع الإنسان نحو التحفّظ، وبما أنّ المؤثر الحقیقی هو الله فإنّنا عندما نصبُّ ذلك فی قالب اسلامی یصبح خوفاً من الله.
عندما یصدر عمل سیّئ منّا قد یكون ذلك منشأً للخطر علینا، ویعاقبنا الله علیه، أو بمعنى ألطف ـ كما یرى أولیاء الله ـ یكون موجباً للحرمان من رضوان الله والابتعاد عن لقائه، وهذا فی نفسه یكون منشأً للخوف لدى الأولیاء، ولیس من الضروری أن یكون خوف الإنسان من عذاب جهنم دائماً، فانّ مثل هذه العوامل ذو تأثیر أعمق فی نفوس المحبّین وأولیاء الله ویكون منشأً للخوف الأكبر. فی هذه الحالة تكون التقوى بمعنى التفات الإنسان جیّداً بأن لا یرتكب أعمالا تسبّب هذا الحرمان، أو ذلك العذاب ویسلك بنحو، ویقوم بأعمال أو یتركها لیكون فی مأمن من هذه الأخطار.
ویشمل (التقوى) فی مستوى أعلى ـ إضافةً الى الفعل أو ترك الفعل الخارجیّـ الفعل أو ترك الفعل القلبی والباطنی كالتحفّظ والاحتراز من الخیالات والتصورات الضارة بسعادة الإنسان.
انّ كلمة (التقوى) ومشتقاتها قد استعملت مائتین وعشرین مرّة فی القرآن الكریم، ولم یذكر متعلَّقها فی الغالب، أعنی فی أكثر من مائة مورد من قبیل: وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوى، إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ كلفظ الإیمان حیث ذكر فی الكثیر من الموارد فی القرآن بدون متعلَّق، وفی خمس وثمانین مورداً یكون متعلَّق (التقوى) هو لفظ (الله) أو (رب) أو الضمیر الراجع إلیهما، وبعبارات من قبیل (واتّقوا الله) أو (اتّقوا ربكم) أو (واتّقونِ) أو (واتّقوه) و...
وفی ثلاثة موارد ـ وكلها فی سورة البقرة ـ ذكر یوم القیامة كمتعلَّق للتقوى قال تعالى فی آیتین:
وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَیْئاً.32
وقال فی آیة:
وَاتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللهِ.33
وفی بعض الآیات ورد عذاب القیامة متعلَّقا لـ (التقوى) من قبیل الآیات:
أَ فَمَنْ یَتَّقِی بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ یَوْمَ الْقِیامَةِ.34
وفَاتَّقُوا النّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِینَ.35
ووَاتَّقُوا النّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْكافِرِینَ.36
ووَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقابِ.37
هنا یُسأل: بملاحظة المتعلَّقات المختلفة للتقوى هل یختلف مفهومها أو انّ لـ (التقوى) مفهوماً واحداً فقط؟
للجواب یجب أن نقول: كما أوضحنا سابقا انّ لـ (التقوى) مفهوماً واحداً فی موارد مختلفة مع متعلّقات متنوعة، لأنّا قلنا: إن التقوى من یوم القیامة أو النار وغیرها لیست ـ فی الحقیقة ـ غیر التقوى من الله وترجع كلها فی النهایة الى هذا المعنى، فقد جعل الله یوم القیامة لمحاسبة العباد، وأعدّ النار والعذاب لعقاب العاصین. فللتقوى إذنْ مفهوم واحد فی جمیع الموارد ولكن بلحاظات مختلفة نسبت تارة الى وسائط مختلفة وتارة الى المبدء الاصلی.
بناءً على هذا یوجد نوع من الخوف دائماً فی (التقوى) ولكن له عوامل متنوعة هی: التأمّل فی تعرض السعادة الى الخطر، أو الابتلاء بالشقاء والتعاسة أو التفكّر فی العذاب الإلهی الذی یرتبط بالنفس بواسطة واحدة ـ لأن العذاب یسبّب شقاء النفس وتعاسة الإنسان، أو التدبر فی الیوم الذی یتوجه فیه العذاب الى الإنسان ویسبّب شقاءه ویرتبط به بواسطتین. ولكن كما قلنا: ان جمیع هذه الأمور تنتهی بالخوف من الله، حاكم ذلك الیوم وعامل ذلك العذاب ومسبّب ذلك العقاب، وعلیه ترجع كلّ موارد التقوى التی تترتب على هذه المخاوف الى اتقاء الله أخیراً. فالمؤمن المتقی هو من یجعل الله نصب عینیه فی جمیع أعماله ویسلك بدقة تامّة بنحو یستجلب رضا الله، ویكون على انتباه كامل لئلاّ یرتكب أعمالاً تستتبع سخط الله وعدم رضاه. ومن زاویة اُخرى یمثّل العذاب ـ فی الواقع ـ النتیجة لأعمال وسلوك الإنسان نفسه، والخوف من الله هو ـ فی الحقیقة ـ خوف من النفس وأعمال وسلوك الإنسان نفسه، ولكن بما أن المدبِّر والمؤثر الحقیقی هو الله عزّ وجلّ فقد نسب الخوف الى الله أیضاً.
الملاحظة التی یمكن استفادتها من هذا الكلام هو أنّ دلالة (التقوى) على الخوف دلالة التزامیة لأن أصل (التقوى) هو حفظ النفس، ولكن من البدیهی أنّ الإنسان مادام لا یخاف شیئا فانّه لا ینبعث لدفع الخطر وحفظ النفس، إذْ إنّ الخوف هو الذی یدفع الإنسان لیجنب نفسه من الخطر، وعلیه فانّ استعمال (التقوى) فی الخوف استعمال فی معنى التزامی. ویمكن القول أیضاً: انّ مفهوم الخوف اُشرب فی (التقوى) ویعنی أنّ حفظ النفس یكون مقروناً بالخوف.
العلاقة بین التقوى والإحسان
من الضروری أن نذكّر هنا أنّنا حینما نقیس مفهومَی التقوى والبرّ أحدهما بالآخر نلاحظ انّهما مختلفان تماماً، ویكون لهذین اللفظین مفهومان مستقلان مع انّ (البِرّ) و(التقوى) قد استعمل أحدهما مكان الآخر فی الآیات القرآنیة، كما وضع (الأبرار) مقابل (الفجّار) فی آیات من قبیل قوله تعالى:
كَلاّ إِنَّ كِتابَ الأَْبْرارِ لَفِی عِلِّیِّینَ.38
وقوله: كَلاّ إِنَّ كِتابَ الفُجّارِ لَفِی سِجِّین.39
ومن قبیل:
إِنَّ الأَْبْرارَ لَفِی نَعِیم * وَإِنَّ الْفُجّارَ لَفِی جَحِیم.40
وفی آیات اُخرى استعمل (التقوى) و(الفجور) متقابلین بتعابیر مختلفة، ففی آیة استعمل (المتقین) مقابل (الفجار) قال تعالى:
أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ كَالْفُجّارِ.41
وفی آیة اُخرى وضع (التقوى) مقابل (الفجور) قال تعالى:
فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها.42
و نظراً لتشابه اللفظین من حیث تقابلهما مع (الفجور) نستنتج انّ (البِرّ) و(التقوى) متساویان ومتحدان فی المصداق وإن افترقا فی المفهوم، فكلّ ما كان مصداقاً لـ (البِرّ) هو مصداق لـ (التقوى) والعكس صحیح أیضاً. وتدلّ إحدى الآیات بوضوح على أن (البِرّ) هو (التقوى) فی الأصل، قال تعالى:
وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.43
كما یمكن استنتاج هذه الحقیقة من آیة اُخرى تدلّ أیضاً على اتحاد (البِرّ) و(التقوى) مصداقاً، قال تعالى:
لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبى وَالْیَتامى وَالْمَساكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسّائِلِینَ وَفِی الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَالضَّرّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.44
وفیها یذكر الله عزّ وجلّ مصادیق (البِرّ) أولاً، ثمّ یخبر بأن أولئك هم الذین یلتزمون الصدق وهم المتّقون ونستنتج أنّ من جاء بـ (البِرّ) فهو متّق، وأن البِرّ والتقوى متحدان مصداقاً.
ولكن تبدو هنا مشكلة هی انّ الله تعالى قال فی آیة اُخرى:
وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى.45
حیث عطفت (التقوى) على (البِرّ) وظاهر العطف هو تباین المعطوف مع المعطوف علیه، ولو كان هذانِ اللفظان متحدَین مصداقاً لما عطف أحدهما على الآخر.
ویمكن الإجابة عن هذا الإشكال بنحوین:
1 ـ ان (البِرّ) و(التقوى) وإن اتحدا مصداقاً الاّ أنّ مفهوم (البِرّ) مفهوم عام، ولا یفید غیر مطلق الصلاح، ولیس بإمكانه ارشادنا لتعیین المصداق ببیان أیّ عمل هو الصالح، بینما مفهوم (التقوى) أثرى مضموناً حیث یفهم منه ـ إضافةً الى المعنى المستفاد من (البِرّ) ـ الخوف من الله ویوم القیامة وعقاب الله تعالى والحرمان من رضوانه، وعلیه فانّ مفهوم التقوى یرشدنا الى طاعة الله، وبما أن قید (طاعة الله) غیر موجود فی مفهوم البرّ فنستنتج أنّ مفهوم (التقوى) هو الأثرى وفیه المزید من الخصوصیات والقیود، فیمكن أن یكون مفسراً لـ (البِرّ) كما ورد فی الآیة السابقة (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى) وتدلّ على أن (التقوى) أوضح من (البِرّ) إذ لم یكن معروفاً لدى الناس، ولذا كانوا ینحرفون شرقاً أو غرباً، ویدخلون البیوت من الخلف ویقول الله عزّ وجلّ انّ هذا لیس (بِرّاً) بل (البِرّ) أن تكونوا ذوی (تقوى)، وبما أنّ (التقوى) ذو مفهوم أوضح فانّه یمكن أن یعیّن مصادیقَ وخصوصیات وقیوداً أكثر وبصورة أفضل.
2 ـ لـ (التقوى) نوعان من الإستعمال:
النوع الأول ذو مفهوم واسع وشامل لكلّ فعل وترك مرضی لله تعالى.
والنوع الثانی ذو مفهوم أضیق حیث یلاحظ الجانب السلبی فقط، وهو عدم اقتحام الخطر والاحتراز منه والابتعاد عنه. ویكون تفسیر التقوى بعملیة الاحتراز عادةً بلحاظ المفهوم الثانی.
ففی المفهوم الأول یلاحظ الجانب الایجابی والسلبی معاً، وهو مفهوم یساوی مفهوم (البِرّ) مصداقاً، فی حین یلاحظ فی الثانی الجانب السلبی منه بصورة أكبر.
وعلیه فانّ مفهومَی (التقوى) و(البِرّ) من قبیل المفهومین اللذین یعطیان معنیین مختلفین إذا اجتمعا، ویتحدان معنى إذا افترقا فی الإستعمال (إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا).
أجل، إذا استعمل لفظ (التقوى) لوحده فانّه یشمل موارد (البِرّ) كلها، فی حین إذا تقارن معه فانّ (البِرّ) یدلّ على الجانب الایجابی و(التقوى) على الجانب السلبی، یكون الأول بمعنى أداء الأعمال الصالحة، والثانی بمعنى ترك الأعمال السیئة. وبالنظر الى هذه الملاحظة یوجد جواب آخر عن الإشكال المذكور، وهو أن یقال: إنّ المراد بالبرّ فی الآیة خصوص الأعمال الإیجابیة الحسنة، وبالتقوى ترك الأعمال السیئة. على أیّة حال، بملاحظة موارد الآیات یُقطع باتحاد (البِرّ) و(التقوى)مصداقاً، إذنْ یمكن القول: إنّ العنوان العامّ الذی یستعمل فی موارد الأخلاق الإسلامیة ویمكن الإستناد إلیه بهذا اللحاظ هو مفهوم (التقوى) الذی یفوق (البِرّ) فی سعة الإستعمال، فقد استعمل (البِرّ) عشرین مرّة و(التقوى) مائتین وعشرین مرّة تقریباً. كما أنّ القرآن الكریم أیّد معیاریته وأكد فی الآیة إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ46 على أنّ القیمة الوحیدة التی لوحظت فی الأفعال الاختیاریة هی التقوى، ویكتسبها كلّ فعل یدخل تحت هذا العنوان، فحتّى طلب العلم یكون ذا قیمة حینما یكون مصداقاً لـ (التقوى)، وهكذا اكتساب الثروة وبذلها ینبغی أن لا یخرج من نطاق (التقوى).
و(التقوى) مفهوم یلاحظ فیه المبادئ النفسیّة للفعل أیضاً، ویشیر فی ذاته الى المبدأ النفسیّ الذی یجب أن یصدر منه الفعل الاختیاری للإنسان، فی هذه المبادئ یلزم الإعتقاد بالله والقیامة، بل والنبوة، لأن من یخشى عقاب الله یوم القیامة یفكّر ما هو العمل المرضی عنده كی یقوم به، وأیُّ سلوك یسخطه كی یتركه حتّى أنّه یُعمل الدقة والوسوسة فی هذا الاتجاه، ولكن بما أنّ العقل فی نفسه لا یصل الى نتیجة فی هذا المجال فانّه سیهتدی بذاته الى (الوحی) و(الأنبیاء)، فاذا ثبت لدیه انّ الله قد أرسل من یعرّف الناس أیَّ عمل یجب أن یؤدوه أو یتركوه وبما أنّه یسعى لإنقاذ نفسه من الخطر، فسوف یؤمن به جزماً ویتبعه لكی تتحقّق سعادته.
وعلیه فانّ (التقوى) یتضمن مبادئ الأخلاق الإسلامیة أیضاً، كما یشیر الى اتجاه الحركة ویمكن طرحه كملاك وحید لقیمة الأفعال الاختیاریة للإنسان.
لـ (التقوى) إذنْ مقدّمات:
أولها: الإعتقاد بالله، لأنّ التقوى مُشرَب بخشیة الله، والخشیة لا تحصل بدون المعرفة والإعتقاد.
ثانیها: الإعتقاد بالقیامة والعقاب والثواب، لأنّ الإنسان إذا اعتقد بالله ثمّ ظن أنَّه رحیم فقط ولا یعاقب عاصیا أبداً فانّه لا یتورع عن الأعمال التی یهواها دون أن یعرف حكم الله فیها.
من هنا یُعلم لماذا یعدّ القرآن الكریم الإیمان من صفات المتقین عند تعریفهم حیث یقول فی مطلع سورة البقرة:
ذلِكَ الْكِتابُ لا رَیْبَ فِیهِ هُدىً لِلْمُتَّقِینَ * الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ.47
ذكر فی هذه الآیات الإیمان بالمبدأ والمعاد والنبوة من جملة صفات المتقین، وینبغی الإلتفات لیس المراد ـ فی الحقیقة ـ أنّ التقوى هو المنشأ لهذا الإیمان، بل العكس ولن یتحقّق التقوى بدون الإیمان.
وقد ذكر تفسیر آخر لهذه الآیة وهو أنّ التقوى على نوعین:
التقوى الفطریّة والتقوى الشرعیة، فقبل الإیمان بالله یمكن تحقّق التقوى الفطریّة فی الإنسان، وفی هذا النوع من التقوى یجتنب الإنسان أعمالاً سیئة ویقوم بأعمال صالحة یمیّزها العقل، هذا التقوى یكون سبباً لایمان الإنسان بالله. الاّ أن هذه الحقیقة واضحة وهی أنّ تقوى الله كقیمة أخلاقیة عامّة یتوقف على الإیمان بالمبدأ والمعاد ویلازم الإیمان مع الوحی والنبوة، وهذه القضیة هی تأكید آخر على أنّ الأخلاق الإسلامیة ناشئة من العقائد الإسلامیة.
هناك علاقة وطیدة بین سلوك الإنسان وعقائده، فالإعتقاد هو الذی یوجه سلوك الإنسان. أجل، توجد علاقة وطیدة بین الأعمال والإعتقادات أو بین ما نعتقد وجوب ادائه وبین معرفتنا عن عالم الوجود، فما لم توجد هذه الإعتقادات فلا توجد واجبات.
الصبر
المفهوم الآخر الذی یشابه مفهوم التقوى سعةً واستعمالاً هو مفهوم (الصبر) الذی تقسمه الروایات الى ثلاثة اقسام:
الصبر على الطاعة، الصبر على المصیبة والصبر على المعصیة.
إنّ مفهوم الصبر یفید هذا المعنى: كأن هناك عاملاً یجرّ الإنسان الى جهة ولكنه یقاومه. هذا العامل یمكن أن یكون باطنیا أو خارجیا. والعامل الباطنی مختلف، فأحیاناً یقتضی العامل الباطنی والرغبة النفسیّة نوعاً من العمل، ولكنه غیر مشروع فیبدی الإنسان المقاومة تجاهه ویجتنب ارتكابه، فیطلق على هذا النوع من المقاومة (الصبر عند المعصیة).
وتارة على العكس یقتضی ترك فعل نافع، لأن الإنسان یمیل للدعة والراحة ویفرّ ممّا فیه تكلیف وإلزام ومن أداء أعمال صعبة، ولذا لا یرغب عادةً فی امتثال أعمال شاقة وخطیرة كـ (الجهاد) مع انّ الله قد أوجب علیه الخروج الیه، والمؤمن الملتزم یقاوم عامل القعود والسكون الداعی لترك الجهاد فی باطنه ویصارعه بتحركه وتوجّهه نحو الجهاد، ویطلق على هذا النوع من المقاومة (الصبر على الطاعة).
وتارة تقع أحداث خارج وجود الإنسان وتترك آثاراً غیر محبّبة وتدفعه للقیام بأعمال تبعده عن طریق الحق، كما إذا نزلت به مصیبة مؤلمة، تقتضی أن یقوم بأعمال تنافی الوقار كأن یضج ویبدی جزعه أو ینتقم من مسبّب ذلك الحدث، فعلیه أن یقاوم ویجتنب الجزع والفزع ویضبط نفسه، ویطلق على هذا النوع من المقاومة (الصبر على المصیبة).
بملاحظة هذا التطبیق الواسع للفظ (الصبر) یمكن القول انّ أغلب الأفعال الأخلاقیة بل جمیعها تدخل ـ بلحاظ ـ تحت عنوان الصبر، كما یصدق علیها بلحاظین آخرین (التقوى) و(البِرّ).
أجل، هناك حیثیات مختلفة تلاحظ فی الأفعال الأخلاقیة، فبلحاظ الخوف من الله یكون القیام بها (تقوى)، وبلحاظ مقاومة العوامل المعارضة فی الباطن والخارج یكون (صبراً) وبلحاظ كونها مرغوبة بالذات یكون (بِراً).
وعلى هذا الأساس یمكن القول: إنّ الصبر أیضاً من المفاهیم الأخلاقیة العامّة التی تشمل حركات الإنسان وسكناته وأفعاله وتروكه الأخلاقیة كافة.
وكما قلنا فانّ (الصبر) قد استعمل فی مواضع مختلفة من القرآن الكریم مطلقاً فی الكثیر منها وبكلّ انواعه من قبیل قوله تعالى:
إِنَّ اللهَ مَعَ الصّابِرِینَ.48
ووَاللهُ یُحِبُّ الصّابِرِینَ.49
وفی موارد تطبیقیة اُخرى لوحظت جهة خاصّة وصبر خاصّ من قبیل قوله تعالى:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْص مِنَ الأَْمْوالِ وَالأَْنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصّابِرِینَ * الَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالُوا إِنّا للهِِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ.50
فقد لوحظ فیه الصبر على المصیبة، ومن قبیل قوله تعالى:
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ.51
ویفهم منه (الصبر) على الطاعة حیث یخاطب النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) بالصبر عند تنفیذ الحكم الإلهی وعدم ترك الساحة، وفی آیات اُخرى من قبیل قوله تعالى:
إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاّ تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.52
ووَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ.53
وغیره حیث تمّ بیان مفهوم الصبر ذاته ولكن بلفظ الإستقامة.
و(الاصطِبار) من مشتقات (الصبر) وهو ـ كما یقول اللغویون ـ مبالغة فی الصبر، وقد استعمل فی قوله تعالى:
وَاصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ.54
أی علیك بالإستقامة تجاه میل النفس للدعة، وعلیك بمزید من الصبر عند أداء العبادات التی یرافقها التحرك والسعی، بینما تدعو النفس للركون الى الدعة والسكون وقوله تعالى:
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْها.55
فالتدبر فی الصلاة والمحافظة علیها والإكثار منها واداؤها فی أوقاتها اصطبار علیها ومن الصبر على الطاعة، كما أنّ الصبر على القتال مع العدوّ والجهاد فی سبیل الله من هذا القسم أیضاً، وعلیه فانّ للصبر تطبیقات واسعةً ویعتبر من المفاهیم الأخلاقیة العامّة، ولكن (التقوى) أكثر الألفاظ شیوعاً، ویمكن اعتباره مفهوما عاما وقیمة أخلاقیة عامّة، ویشمل جمیع الموارد بدون استثناء ولا توجد قیمة فی عرضه، بل یلزم دخول القیم الاُخرى تحته لكی تعتبر قیماً أخلاقیة.
ویمكن القول أنّ القرآن الكریم إضافةً الى التقوى یطرح قیماً اُخرى كالعلم كقوله تعالى:
قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ.56
أویَرْفَعِ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجات.57
حیث یستفاد منهما أنّ العلم ذو قیمة مستقلة، ولكن بما أنّ كلّ علم لیس مطلوباً فی الإسلام، بل یتقید من جهة المتعلَّق وكیفیة التحصیل والإنتفاع به، ویكون قیّماً حال رعایتها وصیرورته مصداقاً للتقوى. إذنْ لیست قیمة العلم مطلقة، فلا یكون سبباً للسعادة فی بعض الموارد بل عاملاً للشقاء، قال تعالى:
وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِی آتَیْناهُ آیاتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِینَ * وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَْرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ.58
وفی الكثیر من الموارد یذمّ حملة العلم لانّهم لا یعملون بعلمهم، بل یسند إلیهم أفظع الجرائم، وأیة جریمة هی أكبر من صدّ الناس عن سبیل الله وإضلالهم؟! انهم استغلوا علمهم وتحركوا فی الجهة المعارضة للاهداف الإلهیّة. إنّ الهدف الإلهی من خلق الإنسان وبعث الرسل وانزال الكتب السماویة هو سیر الناس على طریق الحق، ولكن هؤلاء قد استقطبوهم الى طریق الباطل.
أجل، لقد قام بذلك ویقوم به علماء، وحسب الاصطلاح القرآنی (الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ)، قال تعالى:
فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ.59
ومن الواضح أنّهم بدون العلم لا یمكنهم القیام بذلك. إنّ أعظم الجرائم تنشأ من العلم أیضاً، ولذلك لا یمكن أن یكون ذا قیمة مطلقة، بل یكتسب قیمته من شیء آخر وهو أن یكون مصداقاً للتقوى، وبعبارة اُخرى إن قیمة العلم آلیة لا غائیة، فلتأثیره على تكامل الإنسان یكون مطلوباً، وباعتبار تأثیره فی انحطاط الإنسان لا یكون مطلوباً، فلذا لا یمكن طرحه كقیمة مطلقة. ینبغی القول مثلاً: إنّ العلم یملأ الوعاء الوجودی للإنسان ویوسّع ـ فی الحقیقة ـ وعاءه الروحی، سواءً أكان علما نافعا كالعسل أو مضراً كالسمّ القاتل، وفی الحالة الثانیة یكون خطره أشدّ من الجهل.
إذنْ تتبع قیمة العلم كیفیة الإنتفاع به، كالشجاعة والقوة فی الإنسان اللتین تمنحانه مزیداً من السعة والقوة قیاساً الى ضعفه، الاّ أنّ قیمتیهما لیستا مطلقتین، بل تعتمدان على كیفیة الإنتفاع بهما، كأن تستخدما فی الجهاد فی سبیل الله، وقد أشار سبحانه وتعالى الى الأمرین بقوله:
وَزادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ.60
فبالعلم اتّسع وعاؤه الروحی وبالقوة وعاؤه الجسمی، ولكن أین ینفع هذا الوعاء وما قیمته؟
یتوقف ذلك على النیة والمبدأ النفسانی فی تحصیل اتساعه ومورد استخدامه. إذنْ لا یمكن طرح (العلم) كقیمة أخلاقیة مطلقة بل هو كمال نسبی، بمعنى أنّ روح العالِم ذات سعة أكبر، ولكن لا ضمان لأن یكون العلم بذاته منشأً للسعادة فی النهایة. وعلیه فانّ ما له «قیمة أخلاقیة مطلقة » حسب الرؤیة القرآنیة هو التقوى.
الإحسان، العدل والظلم
من المفاهیم ذات الاستعمال الشامل تقریباً هو مفهوم «الإحسان»، ویمكن القول: انّ أفعال الخیر كافة تدخل تحت عنوان «العدل والإحسان»، قال تعالى:
إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْحْسانِ.61
للإحسان مفهومان: فهو یفید تارة معنى العطاء للآخرین، ویفید تارة مفهوماً عاماً بمعنى كلّ عمل صالح، فیشمل جمیع الأفعال الایجابیة والأخلاقیة القیّمة.
لقد وُضع العدل والظلم فی أصل اللغة كمفهومین متقابلین تماماً، ولكن فی الإستعمال الشائع والمتعارف یكون لأحدهما اختصاص أكبر بالمفهوم اللغوی الأصیل، ولذا لو تابعنا لفظَی العدل والظلم فی القرآن الكریم لم نجد التقابل الدقیق بین مفهومیهما، حیث لا یستعمل (العدل) فی كلّ مورد خال من الظلم، فالله سبحانه ذمّ الظالمین بتعابیر مختلفة من قبیل:
وَاللهُ لا یُحِبُّ الظّالِمِینَ.62
أو وَاللهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمِینَ.63
أو لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ.64
ولكن فی العبارات المقابلة لها لم تستعمل كلمة (العادلین) أبداً، ولا توجد عبارة (والله یحبّ العادلین) أو (یهدی القوم العادلین) وما شاكل، فی حین أنّ ما یقابل مفهوم الظلم ـ فی أصل اللغة ـ هو مفهوم العدل تماماً، وقد یوجد بدلاً منه مثل قوله تعالى إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ.65
وعلى العكس أیضاً استخدم مفهوم العدل فی مواضع ولكن فی الجهة المقابلة لم یستخدم مفهوم الظلم.
ویفید البحث الابتدائی فی موارد استعمال «العدل» فی القرآن أنه استعمل فی «العدل الاجتماعی» كقوله تعالى:
وَأُمِرْتُ لأَِعْدِلَ بَیْنَكُمُ.66
وإِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْحْسانِ.67
واعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى.68
أووَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا.69
أووَإِذا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.70
ووَلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَ آنُ قَوْم عَلى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى.71
یمكن القول أنّ المراد من جمیع موارد استعمال العدل فی القرآن هو العدل الاجتماعی تقریباً، والظلم لیس كذلك حیث استعمل فی موارد غیر اجتماعیة، كقوله تعالى:
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ.72
حیث استعمل الظلم فی المجال العقائدی والعملی، وقال فی موضع آخر:
رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا.73
أی ارتكبنا المعصیة، وقد استعمل الظلم مرّة اُخرى فی نطاق الحیاة الفردیة، بینما لا یستعمل مفهوم العدل عادةً فی موارد العقیدة والسلوك الفردی ودائرة الحیاة الخاصّة، فلا یقال: «إنّ التوحید لَعدلٌ عظیم» كما أنّه لا یعبّر عن العبادة والعمل الصالح بـ «العدل للنفس» وإن كان استعمال العدل بهذا النحو صحیحاً من الناحیة اللغویة ولا مانع فیه.
انّ مادة (العدل) تستعمل أحیاناً كمفهوم مذموم ویعنی الشرك تقریباً، وفی آیات عدیدة قال تعالى على سبیل الذمّ:
بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ.74
ومفهوم (القِسط) قد یقابل مفهوم الظلم ویرادف مفهوم العدل ظاهراً ـ رغم محاولة إثبات فروق بینهما ـ وعلیه فانّ القسط یعنى العدل فی أحد معانیه، ولكنه استعمل ضد «العدل» وبمعنى الظلم فی بعض الموارد، من قبیل قوله تعالى:
وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً.75
فیعتبر من الأضداد حسب الاصطلاح الأدبی.
كلمة قصیرة
ان (البِرّ) أشمل المفاهیم الأخلاقیة الإیجابیة التی استعملت فی القرآن الكریم، وفی المقابل یستخدم الفجور، والإثم، والفحشاء والجریمة. كما أنّ العدل والقسط مفهومان مترادفان وفی مقابلهما تستعمل مفاهیم الظلم، والطغیان والعدوان. كما یستعمل ـ عادةً الفسق، والفجور والظلم أحیاناً مقابل التقوى، وقد وضع الفجار والظالمون أحیاناً مقابل المتقین فی بعض الآیات.
هذا التشتت بین المفاهیم كما قلنا یرجع الى أنّ الألفاظ لیست متقابلة تماماً، وما یستعمل فی مقابلها هی فی الحقیقة مصادیق لنقیضها ومقابلها، ولا وجود لألفاظ تقابلها تماماً، وإن كانت موجودة فانّها غیر شائعة.
* * *
1 العادیات: 8.
2 البقرة: 272.
3 طه: 73.
4 الأعلى: 17.
5 النساء: 77.
6 النساء: 59.
7 النور: 35.
8 یونس: 5.
9 الزمر: 6.
10 الانعام: 122.
11 الحدید: 28.
12 البقرة: 257.
13 فی بحث الحكمة الإلهیّة وغائیة الأفعال الإلهیّة من بحث معرفة الله.
14 المعارج: 24 و25.
15 الحج: 6.
16 البقرة: 177.
17 البقرة: 189.
18 المائدة: 2.
19 آل عمران: 120.
20 المطففین: 18.
21 المطففین: 7.
22 ص: 28.
23 البقرة: 189.
24 البقرة: 2.
25 البقرة: 5.
26 القمر: 54 و55.
27 هود: 49.
28 النساء: 77.
29 النبأ: 31.
30 آل عمران: 28.
31 «قد أخملتهم التقیة وشملتهم الذلة» (نهج البلاغة: الخطبة 32).
32 البقرة: 48 و123.
33 البقرة: 281.
34 الزمر: 24.
35 البقرة: 24.
36 آل عمران: 131.
37 الانفال: 25.
38 المطففین: 18.
39 المطففین: 7.
40 الانفطار: 13 و14.
41 ص: 28.
42 الشمس: 8.
43 البقرة: 189.
44 البقرة: 177.
45 المائدة: 2.
46 الحجرات: 13.
47 البقرة: 2 ـ 4.
48 البقرة: 153.
49 آل عمران: 146.
50 البقرة: 155 و156.
51 الإنسان: 24.
52 فصلت: 30.
53 الشورى: 15.
54 مریم: 65.
55 طه: 132.
56 الزمر: 9.
57 المجادلة: 11.
58 الأعراف: 175 و176.
59 الجاثیة: 17.
60 البقرة: 247.
61 النحل: 90.
62 آل عمران: 57.
63 البقرة: 258.
64 البقرة: 124.
65 المائدة / 42.
66 الشورى: 15.
67 النحل: 90.
68 المائدة: 8.
69 الانعام: 152.
70 النساء: 58.
71 المائدة: 8.
72 لقمان: 13.
73 الأعراف: 23.
74 الانعام: 1.
75 الجن: 15.