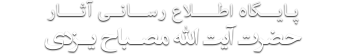ar_assale-ch03.htm
«الجزء الثالث»
«الدین والمفاهیم الحدیثة ، الرقابة الاستصوابیة»
المقدمة
ان المفاهیم الاجتماعیة والثقافیة مفاهیم انتزاعیة یُطلق كل واحد منها على مجموعة من العناصر والتركیبات، وهذه التركیبات بوصفها اموراً فوقیة تقوم على اساس قواعد خاصة بالامكان اعتبارها المنتج لهذه التركیبات. بناءً على هذا، من غیر الممكن لدى عرض المفاهیم الحدیثة فی اسواق الفكر وطرحها فی اوساط المجتمع، الاكتفاء بالاشارة الى البُنى الفوقیة والتغافل عن الاصل والجذور، لأنه فی مثل هذه الحالة ونظراً لوجود الاختلافات البنیویة إما یتعین تهدیم القواعد والاصول الثقافیة لذلك المجتمع كی یتقبل الامور الحدیثة، أو الحرمان من بعض المكتسبات النافعة لسائر الحضارات بسبب اعتراضات ابناء ذلك المجتمع وردود افعالهم الرادعة.
وفی بلادنا حیث یقوم اساس الحكم على الدین واحكامه الشاملة التی تهب السعادة، والشعب الایرانی المسلم لیس على استعداد بأی حال للمساومة على اصوله ومبادئه الدینیة أو التراجع عن الاسلام وقواعده الفكریة، یجب ان تُطرح المفاهیم الحدیثة بدقة وتمعُّن متمیزین، وان تخضع هذه المفاهیم للتجدید من حیث البنیة الفوقیة وكذلك من حیث المبانی، كی ینتفع المجتمع الاسلامی من الانجازات الفكریة والتجربیة لسائر المجتمعات الى جانب الاحتفاظ على الاصالة الثقافیة الذاتیة.
من هنا فقد جرى جمع طائفة من الاسئلة الموجهة لسماحة الاستاذ آیة الله
مصباح الیزدی «مدّ ظلّه» حول علاقة الدین بالمفاهیم الحدیثة وبعض التحدیات الفكریة الاخرى، ونقدمها بین یدی التوّاقین للثقافة الاسلامیة الاصیلة كما فعلنا فی الحلقتین السابقتین.
إصدارات مؤسسة الامام الخمینی(رحمه الله) للتعلیم والبحث
1 ـ الدین والثقافة
سؤال: ما هو الدین وما هی الثقافة؟ وما هی العلاقة التی تربطهما؟
جوابه: قدّم علماء الدین والاجتماع تعاریف متعددة لمفردتی الثقافة والدین، وان سردها ودراسة كلٍّ منها وعقد مقارنة بین الدین والثقافة وفقاً لكل واحد من هذه التعاریف من الصعوبة بمكان ومدعاة للملل، من هنا لنتفق أولاً على تعریف للدین والثقافة ومن ثم نلج المقطع الثانی من السؤال اعلاه.
أ ـ تعریف الدین
حاول علماء الدین ـ ونخصّ بالذكر المسلمین ـ تقدیم تعریف كامل للدین، كما قام علماء الاجتماع بدراسات ومطالعات كثیرة حول ما یعنیه الدین وموقعه بین مؤسسات المجتمع؟ هل ان الدین ركیزة اجتماعیة أم امر آخر لا یمكن اعتباره ركیزة اجتماعیة؟
على أیة حال، لا ضرورة لإیراد هذه المقدمة فالمهم بالنسبة لنا ایضاح مفهوم الدین الحق وبیان عناصره ومقوماته لكی نحكم فی ضوء وجودها أو فقدانها على ما إذا كان دینٌ مّا حقاً أم باطلاً. بناءً على هذا، حریٌ القول فی تعریف الدین ما من شأنه ان یشمل الدین الحق ویصدق على كافة الادیان الالهیة ذات الاصالة فی زمانها لكنها حُرّفت لاحقاً: «الدین مجموعة من المعتقدات القلبیة والوان من السلوك العملی المتطابقة مع تلك المعتقدات» ویشتمل فی بُعد العقائد على الایمان بوحدانیة الله وصفاته الجمالیة والجلالیة والایمان بالنبوة والمعاد، وتلك ما یُعبَّر عنها بـ «اصول الدین» أو «اصول العقائد» ویشمل فی بُعد السلوك كافة الاعمال التی تتطابق مع المعتقدات والتی تجری وفقاً للاوامر والنواهی الالهیة باتجاه عبودیة الله
سبحانه وتعالى. ویعبَّر عن هذا القسم بـ «فروع الدین».
بناءً على هذا، یمكن القول فی تعریف الاسلام باعتباره الدین الحق الوحید(1): «الاسلام عبارة عن مجموعة من المعتقدات القلبیة المنبثقة عن النزعات الفطریة والاستدلالات العقلیة والنقلیة، والتكالیف الدینیة المُنزلة من لدن الباری تعالى على نبی الاسلام(صلى الله علیه وآله) لغرض توفیر السعادة الدنیویة والاخرویة للبشر»، وهذه التكالیف تشمل كافة الشؤون التی لها دور بای نحو من الانحاء فی تحقیق سعادة الانسان فی الدنیا والآخرة.
ان هذا التعریف للدین، والاسلام على وجه الخصوص متعارف علیه ومقبول لدى المسلمین.
ب ـ تعریف الثقافة
ذكر علماء الاجتماع ما یقرب من خمسمائة تعریف لمفهوم «الثقافة» ومن الصعوبة بمكان التطرق لها على انفراد وتدارس نقاط القوة والضعف لكل من هذه المعانی ومقارنتها الى الدین، ونحن هنا نطرح ثلاثة تعاریف كلٌّ منها یشتمل على عدد كبیر
1. لدى السؤال لماذا الدین الحق واحدٌ لا اكثر؟ ینبغی القول: الدین ـ وكما تقدم ـ ذو شقین: العقائد والافعال المتطابقة معها، والعقائد فی حقیقتها تحكی عن الحقائق التی یزخر بها عالم التكوین، أی هنالك حقاً فی عالم الوجود إلهٌ واحدٌ له صفاته المختصّة به، وانبیاء هم حقاً مبعوثون من لدن الباری تعالى لهدایة البشر، وعالمٌ بعد هذا العالم یُسمى الآخرة. وهذه الامور بأسرها تعد ثمرة التأملات العقلیة المعمقة فی عالم الوجود التی تؤیدها الفطرة والكتب السماویة التی لم یطلها التحریف ومن بینها القرآن الكریم.
ومن ناحیة اخرى، ان الله تعالى الذی غایته من خلق الانسان بلوغه الخیر والكمال، قد وضع احكاماً وتكالیف بنحو تتحقق فیه مصلحة من مصالح الانسان بادائه لأیّ منها، وتُطوى خطوة فی طریق الكمال الانسانی، وكما یُعبّر فان «الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعیة»، ومن المسلّم به ان طریق الوصول الى تلك المصالح والكمالات سیوصد بتحریف هذه الاحكام أو تغییرها، وذلك سیتناقض مع الهدف الذی یتوخاه الله سبحانه وتعالى من الخلقة.
من هنا مادام الدین متضمناً لهذین الشقین وبعیداً عن ای تحریف، فانه سیكون الدین الحق، وبما ان الادیان باسرها هی من لدن الباری تعالى وهنالك حقائق متماثلة تؤلف الكون، اذن لا مجال لاحتمال وجود نوعین من الدین الحقّ على مر التاریخ یتناقضان فی جمیع تفاصیلهما أو بعضها.
من التعاریف ثم نتطرق بالبحث لعلاقة كلٍّ منها بالدین.
تعرَّف الثقافة فی بعض التعاریف على انها شاملة للعقائد والقیم والاخلاق وألوان السلوك المتأثرة بهذه العناصر الثلاثة، وكذلك الآداب والتقالید والاعراف الخاصة بمجتمع معین. وفی النمط الآخر من التعاریف تعتبر الاداب والتقالید اللبنة الاساسیة للثقافة، وتعرّف الظواهر المجرّدة للسلوكیات دون الاخذ بنظر الاعتبار مرتكزاتها العقائدیة على انها ثقافة المجتمع. واخیراً تعرَّف الثقافة فی طائفة اخرى من التعاریف بانها العنصر الذی یمنح حیاة الانسان المعنى والاتجاه.
ج ـ علاقة الدین بالثقافة
بعد معرفة الانواع الثلاثة من التعاریف للثقافة نقول:
اذا ما قیس الدین ـ بوصفه مجموعة من المعتقدات القلبیة والسلوكیات العملیة المتطابقة مع تلك المعتقدات ـ مع النمط الاول من التعاریف المتقدمة، فهو یعتبر جزءاً من الثقافة، لان الثقافة وفقاً لهذه الرؤیة تشمل العقائد القلبیة الدینیة وغیر الدینیة وتشمل كذلك السلوكیات والاخلاق والآداب والتقالید الدینیة وغیر الدینیة. من هنا یعتبر الدین جزءاً من الثقافة ویدخل فی منظومتها.
أما اذا قسنا الدین مع الصنف الثانی من التعاریف، فبما ان ظواهر السلوك والآداب والتقالید تعتبر وفقاً لهذا الصنف من التعاریف على انها الثقافة، فیمكن أن تعرف علاقة الدین بالثقافة باعتبارهما مجموعتین تشتركان فی بعض العناصر فقط، ووفقاً لهذه الرؤیة لا الدین یشكل جزءاً من الثقافة بشكل تام ولا الثقافة تدخل ضمن مجموعة الدین.
ربما یمكن القول ان تعریف الثقافة بالعنصر الذی یمنح حیاة الانسان المعنى والوجهة هو افضل ما یقال منطقیاً فی تعریف هذه المفردة، ولكن ینبغی وقبل كل شیء ان نوضح ما المراد من قولنا: ان هذا یمنح الحیاة معنى؟
لو قارنّا بعض تصرفات الانسان مع تصرفات الحیوانات سنجد تماثلاً فی طبیعة هذین النمطین من التصرفات بالرغم من بعض الفوارق الظاهریة، فعلى سبیل المثال: ان كلاً من الانسان والحیوان یسعیان حین الجوع وراء الطعام وسد الجوع والشبع، ولكن فی نفس الوقت بالرغم من حصول الانتقال المكانی وحالة الشبع لدى الانسان والحیوان على حدٍّ سواء ربما ینطوی تصرف الانسان على قیمة ما سواء كانت ایجابیة أم سلبیة، فاذا ما سرق المرء ـ مثلاً ـ طعام غیره وسدَّ جوعه به فان عمله هذا یعتبر سرقة وغصباً وتجاوزاً على حقوق الآخرین وهو برمته ینطوی على قیمة سلبیة.
وكذلك الامر فی المجتمع الدینی هنالك مجموعة من السلوكیات ذات قیمة ایجابیة أو سلبیة، فالغیبة وافطار شهر رمضان ـ على سبیل المثال ـ لهما قیمة سلبیة فی الاسلام، والمحافظة على السرّ والصیام لهما قیمة ایجابیة، والملاحظة الجدیرة بالاهتمام هنا هی: لماذا یعطی الناس فی المجتمعات الدینیة بعض الاشیاء قیمة سواء كانت ایجابیة او سلبیة ـ بالاضافة الى الامور التی یرى سائر الناس حسنها أو قبحهاـ؟ وبتعبیر افضل: ما هو مصدر الحسن والقبح؟
ان من ابرز المسائل الفلسفیة واكثرها جدلاً فی العالم هو هذا السؤال: هل القیم نابعة من العقود الاجتماعیة أم من امور واقعیة وتكوینیة؟ هل كون الامور القیمیة ذات معنى ناشئ عن العقد أم عن حقائق یرشدُ العقل والوحی الناسَ نحوها؟
من البدیهی ان هاتین الرؤیتین تولدان ثقافتین مختلفتین: ثقافة ترى تابعیة معنى القیم للعقد الاجتماعی، وبالتالی فانها ترى الاخلاق والامور القیمیة «نسبیة» ومتغیرة وتابعة لاهواء الانسان، وثقافة ترى تابعیة معنى القیم لامور واقعیة مستقلة عن إقبال الناس وإعراضهم. وهذه الامور الواقعیة هی التی ملأت عالم الكون بأسره ویمكن تشخیصها بارشاد من العقل والوحی ولا یَعتَریها التغییر بتغیر اذواق الناس.
بناءً على هذا، فكون حیاة الانسان ذات معنى انما ینجم عن طبیعة رؤیة الانسان
للكون والانسان، أو بتعبیر آخر انه تابع لـ «رؤیته الكونیة ومعرفته الانسانیة» فالرؤیة الكونیة بدورها تبلور «النظام العقائدی» و«النظام العقائدی» یبلور «النظام القیمی».
بما ان الافعال الاختیاریة للانسان تابعة لارادته وان ارادة البشر انما تصاغ فی ضوء طبیعة رؤیتهم والنظام القیمی الذی یحظى بقبولهم، فان سلوكیات الانسان ستكون هی الاخرى تابعة للنظام القیمی الذی یرتضیه.
وخلاصة القول، ان المعنى الذی یطبع حیاة الانسان منوط باداء افعال وممارسات یؤطرها نظام قیمی خاص بالمجتمع وتأتی فی ضوء معتقدات ذلك المجتمع ونظامه العقائدی. وبما ان الرؤیة الكونیة الحقة الوحیدة ـ استناداً للرؤیة الاسلامیة ـ وتبعاً لها النظام العقائدی والقیمی الصحیح هو الاسلام وحده، فاننا ـ اعنی المسلمین ـ نرى ان الدین هو العنصر الذی یمنح حیاة الانسان معناها ووجهتها. من هنا فان الثقافة فی الصیغة الثالثة من التعاریف الآنفة الذكر تنطبق على الدین، إلاّ ان نرى مركبات الثقافة اقل من مركبات الدین، كأن نرى ـ مثلاً ـ مركبات الثقافة هی النظام القیمی والسلوكیات السائدة فی المجتمع الدینی، وفی مثل هذه الحالة ستدخل الثقافة فی منظومة الدین وتكون تابعة له.
ولا یخفى أن القیم تعرَّف احیاناً فی البلد ذی المجتمع الدینی بمعنىً أوسع مدىً من القیم الدینیة، وفی مثل هذه الحالة سیبلور لدینا نمطان من القیم، الاول: القیم الثابتة التی لا تقبل التغییر وهی التی تنبثق عن المعتقدات الدینیة، والثانی: القیم المنبثقة عن الاعراف والتقالید والعقود الاجتماعیة وهی تقبل التغییر والتبدل، ولكن من الواضح جداً ان التغیر فی الطائفة الثانیة لا یمس بسوء القیمَ الثابتة التی لا تتغیر، وذلك لانبثاقهما عن مصدرین مختلفین.
* * * * *
2 ـ علاقة الدین بالحریة
سؤال: ما هی علاقة الدین بالحریة؟ وهل یجب اعتبار الدین مقدَّماً على الحریة أم العكس اذ تكون الاصالة للحریة، ویصبح الدین تابعاً لها؟
جوابه: لقد تصور البعض اصالة الحریة وتقدمها على كل شیء ومن بین ذلك الدین، لاننا اذا ما اعتبرنا الدین أصلاً والحریة جزءاً منه لن نكون احراراً لدى اعتناقنا للدین، وبتعبیر آخر ان الاقتناع باصل الدین ـ شأنه كأی عمل اختیاری آخر للانسان ـ انما یكتسب قیمته ویستحق الاجر والثواب الالهی عندما یكون عن حریة واختیار، واذا ما اعتبرنا الحریة فرعاً وتأتی بعد الدین فی شأنها فان لازم ذلك فقداننا الحریة عند ایماننا بالدین وبالتالی یصبح عملنا خالیاً من الاختیار، بینما یتعین ان یتم اختیار الدین بحریة وعن ایمان باعتباره عملاً اختیاریاً له جذوره فی صمیم قلب الانسان ولیس بالامر الذی یُمكن فرضه على أحد بالقوة والاكراه، من هنا یقول تعالى فی القرآن الكریم: (لا إِكْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ)(1).
بناءً على هذا فان الاصالة للحریة وهی مقدمة على الدین وان وجود الدین وشأنه انما یكتسب معناه فی ظل الحریة.
وحیث ان الحریة تتقدم الدین فی شأنها، والدین ولید الحریة ومتمخضٌ عنها فلا قدرة له أبداً على تقییدها، وذلك لعدم قدرة النتیجة والفرع على تقیید اصله ومصدره، وهو بفعله هذا انما یقضی على اعتباره ایضاً، وعلیه یجب ان یتمتع الناس فی الاوساط الدینیة بكامل الحریة، ولا حقّ لأحكام الدین وقوانینه فی تقیید الحریات.
ان شطراً من الاستدلال اعلاه كلامٌ حقٍّ وشطره الآخر لیس سوى سفسطة یسهل تشخیصها بقلیل من التأمل، فالشطر الاول من الاستدلال الآنف الذكر والقائل بان
1. البقرة: 256.
انتخاب الدین فی ظل اجواء وظروف حرّة هو الذی یحظى بالقبول ویتمیز بقیمته، ویتوسل بالآیة (لا إِكْراهَ فِی الدِّینِ) تأییداً لذلك لهو كلامٌ موجه، بید ان الشطر الثانی المتضمّن فی بقیّة الاستدلال والذی یوحی بوجوب صیانة الحریة بعد القبول بالدین بحیث لا یتسنى لاحكام الدین المساس بها، انما هو مغالطة لیس إلا.
ولایضاح الأمر اكثر حریٌ القول:
لقد جرى فی هذا الاستدلال الخلط بین مرحلتین أو شأنین من الحریة: أحدهما الحریة قبل اعتناق الدین، والآخر الحریة بعد اعتناق الدین، فتلك الحریة التی تمثل شرطاً فی الانتخاب والقدرة على الانتخاب تتقدم على الدین فی مرتبتها وینتفی الانتخاب الحر بدونها، أما الحریة التی تلی انتخاب الدین فستدخل فی اطار الدین وتتقید بحدوده. وبتعبیر آخر، بعد ان اختار الانسان الدین بحریة وارتضى الدین بمنظومته التی تشمل الشؤون العقائدیة والاحكام العملیة ایضاً واذعن لمستلزمات هذا القبول المتمثلة بالعمل والمسیر فی اطار هذه المعتقدات والاحكام العملیة، یكون قد جعل من نفسه تابعاً لاوامر الله تعالى ونواهیه بكل حریة.
ویقع نظیر هذا الأمر فی الكثیر من الشؤون الحیاتیة للناس، فعلى سبیل المثال: ان الناس ینضمون بحریة واختیار للعمل ضمن القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلی، لكنهم وبعد الالتحاق والقبول الحرّ بالقوانین والمقررات السائدة فی القوات المذكورة لا یجوز لهم تجاوز هذه القوانین والمقررات ولا یسعهم اتخاذ القرار بما یحلو لهم.
وتثار هذه المغالطة احیاناً بمسحة وصبغة دینیة واستناداً لبعض الآیات القرآنیة لتحظى بمزید من المقبولیة، والآیات من قبیل:
1 ـ «لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِر»(1).
2 ـ «وَما جَعَلْناكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً وَما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیل»(2).
1. الغاشیة: 22.
2. الانعام: 107.
3 ـ «ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ»(1).
4 ـ «إِنّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمّا شاكِراً وَإِمّا كَفُوراً»(2).
5 ـ «فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْیَكْفُرْ»(3).
انهم وباستدلالهم بهذه الآیات یصرخون باسم الحریة وكأنهم ـ والعیاذ بالله ـ احرصُ من الله على حریة الانسان! غافلین عن ان هنالك آیات تقابل الآیات الآنفة الذكر تصرح: «وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»(4)، أو الآیة: «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»(5).
وقد بیّن المفسرون باجمعهم تقریباً هذه الآیة بان قرار النبی مقدمٌ على ما یقرره الناس، واذا ما قرر امراً فلا یحق للآخرین مخالفته.
ربما یُتصوّر للوهلة الاولى وجود تضارب بین هذه الطائفة من الآیات، بید أن من كانت لدیه ادنى معرفة بالقرآن ومن خلال الرجوع الى سیاق الطائفة الاولى من الآیات وما قبلها وما بعدها یدرك عدم وجود أیة علاقة بین مورد هذه الآیات وبین موضوع الحریة لیقع تهافت بینهما، وانما هی فی مقام مواساة النبی(صلى الله علیه وآله)، فنظراً لان النبی كان مظهر الرحمة والرأفة الالهیة فقد كان كثیر القلق لعدم قبول الناس طریق الحق والاسلام وكان یتجرع الحسرات وكأنه یكاد یهلكُ نفسه، ففی مقام مواساته للنبی(صلى الله علیه وآله) یقول تعالى: «لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ»(6). لقد انزل الله سبحانه وتعالى الطائفة الاولى من الآیات لیهب النبی(صلى الله علیه وآله)الطمأنینة.
* * * * *
بناءً على هذا، فان القول بهزیمة الدین حیثما وقف بوجه الحریة انما یفتقد السند القرآنی ولا یمكن العثور على ما یؤیده من المصادر الدینیة، كما ان الطائفة الاولى من الآیات لا تثبت دعاوى ذوی الرأی المخالف وان استنباطاتهم هی من المصادیق البارزة لـ «التفسیر بالرأی».
1. المائدة: 99.
2. الانسان: 3.
3. الكهف: 29.
4. الاحزاب: 36.
5. الاحزاب: 6.
6. الشعراء: 3.
3 ـ الاسلام والمجتمع المدنی
سؤال: ما المراد من المجتمع المدنی مقارنة بالمجتمع الاسلامی؟ وهل للمجتمع المدنی موقعٌ فی الدین والمجتمع الدینی؟
جوابه: للاجابة على هذا السؤال ینبغی أولاً ان نقدّم توضیحاً لكلٍّ من مصطلحی «المجتمع المدنی» و«المجتمع الاسلامی» ومن ثم نتطرق للعلاقة بین المجتمع المدنی والمجتمع الاسلامی.
أ ـ المجتمع المدنی
للمجتمع المدنی معان متعددة، فقد طُرحت هذه المفردة قبل ما یقرب من الفین وخمسمائة عام وفی كل حقبة یظهر لها تفسیرٌ، وعلى هذا المنوال یأتی الوضع الراهن. على ایة حال، سنشیر الى ثلاثة من المعانی المتداولة والمتعارفة حالیاً للمجتمع المدنی لیتسنى لنا من خلالها العثور على الاجابة المطلوبة:
أ ـ المجتمع المدنی فی قبال المجتمع البدوی غیر المتحضّر: ویُطلق المجتمع المدنی هنا على المجتمع الذی یسود فیه القانون والضوابط على سلوكیات المواطنین ولیس لأحد فیه الحق بادانة أو معاقبة الآخرین وفقاً لمعاییره وذوقه الشخصی. وربما یسع القول ان الذین یركّزون على سیادة القانون فی المجتمع المدنی انما مرادهم هذا المعنى من المجتمع المدنی.
ب ـ یعنی المجتمع المدنی ذلك المجتمع الذی یتبنى ابناؤه الحد الاقصى من واجباتهم الاجتماعیة طواعیة وبهذا فهم یخففون من اعباء الحكومة. ان هذا المعنى من المجتمع المدنی ینسجم تماماً مع الاسلام، وان وجود مؤسسات التربیة والتعلیم ذات الطابع الشعبی والمستشفیات وسائر دوائر الخدمات ذات النفع العام لاسیما
الاوقاف یحكی بجلاء عن مدنیة المجتمع الاسلامی.
ج ـ المجتمع المدنی بمعناه المعاصر: وفیه یستقل جانبٌ من الحیاة العامة للناس عن الحكومة ویسیر فی اطار الجمعیات والنقابات والاحزاب والتنظیمات والمحافل الثقافیة... الخ وتؤدی دور الوسیط بین المواطن والحكومة. وللمجتمع المدنی فی ضوء هذا المفهوم طابع ثقافی خاص لا ینسجم نوعاً ما مع الثقافة الاسلامیة، وذلك لارتكازه على اسس خاصة وهی عبارة عن:
1 ـ العلمانیة (فصل الدین عن كافة المیادین الاجتماعیة) وهو یعتبر أول المرتكزات الفكریة للمجتمع المدنی، فاذا ما قیل ان هنالك مجتمعاً مدنیاً فذلك مما یعنی قدرتنا على التقنین بصیغته التأسیسیة، أی نتولى نحن التقنین فیما یخص اسس الحیاة بدءاً من میدانها الفردی وانتهاءً بالمیادین الاجتماعیة، والخطوة الاولى فی هذا المجال ان نتحرر حتى من القیود الدینیة على صعید كافة شؤون حیاتنا.
2 ـ محوریة الانسان «هیومانیزم»، المرتكز الآخر للمجتمع المدنی هو محوریة واصالة الانسان ومصالحه فی كافة المجالات وبمقتضى ذلك یوظف كلّ شیء لخدمة الانسان حتى الدین فهو مطلوب ویحظى بقیمته مادام یكفل للانسان راحته النفسیة ولا یتضارب مع مصالحه، وقیمة كلّ شیء انما تحدد فی ضوء منفعته للانسان.
3 ـ نسبیة القیم والمعرفة: فی ضوء هذه الرؤیة لیس ثمة معرفة أو قیمة مطلقة وثابتة، ففی البعد العلمی لیس لأحد القدرة على القول بان معرفته ورؤیته حق مطلق وان كانت تلك الرؤیة نابعة من حكم العقل القطعی أو النصوص الدینیة القطعیة وغیر المحرّفة.
وكذلك فی البعد القیمی فلیس هنالك قیمة ثابتة ومطلقة، وانما القیم تتغیر باختیار الناس وارادتهم، بل الغالبیة منهم، لذلك فان القیم التی ارساها العقل على مرّ الحیاة البشریة، أو القیم التی یرى الوحی اعتبارها وعدم قابلیة تغییرها، انما تحظى
بالاعتبار مادامت مقبولة لدى الاغلبیة وإلاّ تكون نسبیة ویمكن تنحیتها جانباً.
4 ـ محوریة الطبیعة (فی الحقوق)، والمنفعة (فی الاخلاق) والعقلانیة بمعناها السلبیّ الذی یطرد كلَّ ما لا یناله العقل العادیّ. كل هذه وسائل اخرى لهذا الاتجاه الفكری، ونترك الخوض فی تفاصیلها تحاشیاً للاطالة فی الحدیث.
الیوم وبعد التطورات التی هیمنت على مجمل الثقافة الغربیة فی التوجهات اللیبرالیة، یقال: یجب ان یتمتع الناس بالمزید من الحریة فی حیاتهم وتتقلص الالتزامات القانونیة ـ التی من شأنها تقیید الحریات ـ الى ادنى مستوى لها، وكما یعبَّر، یجب أن یكون تدخّل القانون «فی الحدّ الادنى»، بناءً على هذا یتعین ان یكون للدولة ادنى حدٍّ من التدخل فی شؤون الناس، فالدولة مكلفة باقرار النظام الاجتماعی والحیلولة دون وقوع الفوضى فقط كی ینال كل انسان فی ظل ذلك اقصى حدود الحریة.
الشعب هو الذی ینهض بالدور الاساس فی ادارة المجتمع حیث یمارس ذلك فی اطار الاحزاب، والتنظیمات، والمجالس والاتحادات أو الجمعیات وشركات القطاع الخاص، وتمتد دائرة هذا الدور لتشمل كافة الشؤون سواء الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة، والفنیة والعسكریة... الخ، فیتقلّص عبء الدولة ومسؤولیتها الى ادنى مستواها ولا یحق لها التدخل أو التصدی للامور إلاّ فی الحالات الضروریة التی لا قدرة للشعب علیها، وما علیها فقط إلاّ تمهید الارضیة الكفیلة بكافة النشاطات على اختلافها وتتولى الاشراف فقط لئلا تُمس حقوق الناس وحریاتهم، وتتحقق مشتهیات المواطنین على احسن وجه.
وكما تقدم القول فان الافتراض المسبق للمجتمع المدنی فی الغرب هو علمانیة الحكومة ـ أی عدم كونها دینیّة ـ وعلیه یتعین على الحكومة أن لا تُقحم الدین والقیم واحكام الدین فی أی شأن من شؤون المجتمع ولا یحق لها مساندة أی دین، بل علیها ان تكون منحازة ازاء الادیان جمیعاً.
وكما هو الحال فی الدول ذات التعددیة الدینیة بما ان رئیس الجمهوریة هو رئیس لكافة الشعب فلا یحق له الدفاع عن دین معین ـ وهذا بطبیعة الحال یتناقض مع دستورنا القائم على الدین الاسلامی الحق ویتعین العمل وفقاً للمذهب الشیعی(1) ـ ولا یمتدّ الدین الى أیٍّ من مؤسسات الدولة ومنظماتها ودوائرها، وان الدولة موظفة بان تحول دون تدخُّل الدین فی مختلف الامور المتعلقة بالحكومة، الأمر الذی یُشاهد الیوم فی امریكا وانجلترا بل وحتى تركیا.
أجل ان الافراد أو المؤسسات الخصوصیة وغیر الحكومیة یسعها ـ بطبیعة الحال ـ الاستعانة بالدین والابعاد الدینیة فی ادارة الدوائر الخاضعة لهم، بید ان هذه الامور لا علاقة لها بالدولة وهی خارجة عن دائرة شؤونها، لذلك بمقدور المؤسسات والمدارس الدینیة غیر الحكومیة ان تمارس فعالیاتها فی مثل هذه المجتمعات.
لا یخفى ان الدافع وراء فكرة اقامة مجتمع مدنی فی بعض الدول حیث یقترن بتخفیف اعباء الدولة وایكال العدید من الواجبات الى الشعب ربما یكون بوجود اقتصاد مریض فی بلد ما حیث تسعى الدولة للتغلب على المشكلات من خلال الخصخصة وتسلیم مرافق الدولة الى القطاع الخاص وتقلیص تصدی الدولة للامور، وربما ینادی التجار والمؤسسات المالیة بالدفاع عن المجتمع المدنی تحت شعار اللیبرالیة الاقتصادیة وتقلیص قوانین الدولة ومقرراتها سعیاً وراء المزید من الارباح، ولعل هنالك دوافع اخرى تستدعی فرصة اخرى لتناولها بالبحث.
على ایة حال، مسیر المجتمع المدنی فی الغرب انما یقوم على اساس فقدان الدین لدوره فی الشؤون الاجتماعیة، والقانون هو ما یختاره الناس، ولا حقَّ للدین بالتدخل فی مقدراتهم السیاسیة.
1. استناداً للمادة الثانیة عشرة من دستور الجمهوریة الاسلامیة: الدین الرسمی لایران هو الاسلام والمذهب الجعفری، وهذه المادة تبقى الى الابد غیر قابلة للتغییر. واستناداً للمادة الثانیة من الدستور فان نظامنا یقوم على اساس الاسلام ومعجون به، واستناداً للمادة الرابعة: یجب ان تكون الموازین الاسلامیة اساس جمیع القوانین والقرارات المدنیة والجزائیة والمالیة والاقتصادیة والاداریة والثقافیة والعسكریة والسیاسیة وغیرها.
ب ـ المجتمع الاسلامی
لقد صوّرت ابحاث علم الاجتماع الاواصر التی تجمع ابناء كل مجتمع بانها تقوم على اسس متباینة، فمنها من تتآصر على اساس الدم أو العرق، واخرى على اساس المصالح الطبقیة، وبعضها على اساس الوطنیة والقومیة، ویتآصر البعض الآخر على اساس اللون، فیما تجتمع اخرى على اساس الاتجاه الفكری، وهنالك أوامر قومیة وقبَلیة كانت قائمة منذ القدم بین البشر ایضاً.
ان بعض هذه الاواصر ضعیف والآخر قوی، وبعضها لا أساس له ومتواضع فی قیمته فیما یتمیز الآخر بسموه وقیمته. فالآصرة التی تقوم على اساس سحنة البشرة والدم والعرق ـ مثلاً ـ وایِّ تمایز طبیعی آخر ـ أی غیر اختیاری ـ متواضعة فی قیمتها، أما الآصرة التی تقوم على اساس المعتقدات والقیم الاخلاقیة والغایات العملیة المشتركة فهی تفوق بقیمتها الآصرة القبَلیة، حتى یصل الأمر الى الآصرة التی تتبلور على اساس الایمان المشترك، فالسبب فی سمو الایمان باعتباره محوراً للتضامن الاجتماعی هو ان قوام الایمان ـ وعلى العكس من سائر المحاور ـ بالوثاق القلبی والعقیدة والعمل، أی البناء الوجودی للانسان برمّته.
لقد جعل الاسلام من الایمان المشترك اساساً للتضامن الاجتماعی بین اتباعه، وأقام بینهم آصرة ولائیة وإلهیة مستخدماً مفهوم «الأمّة» للتعریف بهم: «وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ»(1).
ان الانتماء للامة الاسلامیة أو الخروج منها انما یتحقّق فی ضوء الایمان بالولایة الالهیة أو رفضها، فمن یبایع امام المسلمین وعبر هذا الطریق یؤمن بولایة الله واحكامه یُعد عضواً فی المجتمع الدینی، ومَنْ لم یبایع أو نكث البیعة فهو مفارقٌ للامة الاسلامیة.
الشرط الآخر للانتماء للامة الاسلامیة هو الشعور بالمسؤولیة والتكلیف، وان
1. المؤمنون: 52.
ابناء الامة الاسلامیة یراودهم هاجس اداء تكالیفهم قبل ان یفكروا باستیفاء حقوقهم، وعلى هذا الاساس تُرجّح التكالیف الدینیة على المصالح الفردیة والفئویة والمهنیة والطبقیة... الخ.
ان قائد الامة الاسلامیة یتحمل مسؤولیة المساعدة على تكامل الجماهیر وتوجیه الامة، وینبغی ان لا یتركز هدفه على مجرد ادارة المجتمع ـ بمعنى المحافظة على الواقع القائم أو إقرار النظم الاجتماعی لإنعاش احوال الناس فی هذا العالم ـ بل یتحتم علیه السیر بالمجتمع قُدُماً نحو التكامل ایضاً.
من الفوارق الجوهریة بین النظریة الدینیة ونظریة الغرب العلمانیة فیما یتعلق بأمر الحكومة والرؤیة الاجتماعیة، هو هذا الفارق فی الغایات، فهدف الحكومة الغربیة لا یتعدى توفیر المتطلبات الأولیة ـ من مأكل ومسكن وملبس... الخ ـ وبالتالی التنمیة والتطور، بید ان الحكومة الدینیة تنشد بالاضافة الى هذا الهدف هدفاً اسمى وارفع وهو عبارة عن توفیر مقومات تنامی الفضائل والكمالات الانسانیة وإعداد الظروف المؤاتیة لعبادة الله وتذلیل العقبات التی تحول دون عبودیة الحق تعالى وازالة سلطة الطواغیت. والهدف الاول ـ تحقیق الازدهار المادی وبسطه ـ انما یكون مقبولاً ـ فی الحقیقة ـ باعتباره مقدمة وآلیة لبلوغ الهدف الثانی ویدخل فی اطار لا یتناقض مع مهمة بلوغ الهدف الثانی ـ وهو الهدف السامی للانسان ـ بناءً على هذا یتعین مراعاة القیم والاحكام الاسلامیة بدقة متناهیة لدى تحقیق الهدف الاول ایضاً.
لنرَ الآن هل بالامكان تقدیم معنىً للمجتمع المدنی ینسجم مع المجتمع الدینی؟
ج ـ مكانة المجتمع المدنی فی المجتمع الإسلامی
بادئ ذی بدء حریٌ بنا التذكیر باستحالة المواءمة بین المجتمع الدینی والمجتمع المدنی الغربی فی ضوء الاسس التی یقوم علیها الثانی، لان الفرضیة المسبقة
للمجتمع الدینی هی سیادة الدین والاحكام الالهیة فی كافة المجالات الفردیة والاجتماعیة، بینما الفرضیة القائمة فی المجتمع المدنی الغربی هی فصل الدین ورفض حاكمیته فی الاصعدة الاجتماعیة، وهنالك تناقض وتضاد تام بین هاتین الرؤیتین.
بناءً على هذا اذا ما استطعنا الحصول على معنىً لمجتمع مدنی تُرسى قواعده على اساس مقتضیات مجتمعنا وفی ضوء مفهوم «الامة» وضروریاتها من قبیل «الامامة» و«الولایة» اصبح بالوسع المواءمة بین هذین المفهومین. فلابد فی البدایة من تدارس ما الذی نصبو الیه من المجتمع المدنی وما هو الهدف من اقامته؟
یبدو ان الاهداف المتصوَّرة من إقامة المجتمع المدنی فی اوساط الامة الاسلامیة فی هذا العصر هی عبارة عن:
1 ـ حصول الجماهیر على حقوقها.
2 ـ استقطاب المشاركة الجماهیریة فی الاعمال والارتقاء بالقدرة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للامة.
3 ـ الاستعانة بالافكار والرؤى فی تصحیح المناهج والقرارات والخطط وتطویرها.
4 ـ الحد من المفاسد الاداریة والاجتماعیة والحیلولة دون تجاوز الدولة على الشعب.
5 ـ القیام بالواجبات الاجتماعیة من قبیل النصیحة لائمة المسلمین والأمر بالمعروف والنهی عن المنكر.
6 ـ ارشاد الجماهیر وتربیتها.
7 ـ التخفیف من اعباء الدولة فی تصدیها للامور ومسؤولیاتها.
فی ضوء الاهداف الآنفة الذكر والتی تمثل فی واقع الأمر مهام المجتمع المدنی، یتسنى وعبر التمسك بضروریات الانتماء للامة، إقامة المجتمع المدنی فی صلب
الامة الاسلامیة. فالمجتمع المدنی یخلق بین ابناء مؤسساته أواصر من شأنها بلوغ الاهداف اعلاه، غیر أن أواصر الامة الاسلامیة هی التی تسود تلك الاواصر، وهذا یعنی رجحان التزام الافراد بالامة الاسلامیة وقیادتها على التزامهم بمؤسسات المجتمع المدنی أولاً، وان اهداف ومهام المجتمع المدنی لیست على حدٍّ سواء باجمعها، فتلك الطائفة من المهام التی تصب باتجاه توفیر المزید من مصالح الامة تترجح على الطائفة التی تصب باتجاه تلبیة المصالح الفردیة والفئویة المحضة.
لیس من الضروری ان یكون المجتمع المدنی علمانیاً لغرض بلوغ اهدافه، اذ ان التزامه الدینی لا یمثل عقبة امام نیله غایاته، وانما هذا الالتزام الدینی یحول دون الانفلات المطلق والحریة فی التقنین الاساسی فی كافة ابعاد الحیاة الانسانیة، فعملیة التقنین الاساسی فی الامة الاسلامیة لیست بالامر الذی یتم وفقاً لرغبات الناس، لما یقتضیه ذلك من اهمال للاحكام والقوانین التی شرعها الباری تعالى. بناءً على هذا، یتعین ان تحصل عملیة التقنین فی المجتمع الاسلامی فی اطار القوانین الاسلامیة القطعیة وان لا تتنافى مع الاحكام الالهیة. وبتعبیر آخر، بعد أن ارتضى الناس الانتماء للامة الاسلامیة بحریة ومدّوا ید البیعة لقائدها، فانهم یتمسكون بمقتضیات ذلك ـ وهی التحرك فی اطار الموازین الاسلامیة ـ ومَثلُ هذا كأیِّ تضامن اجتماعی آخر یفرز التزامات بالنسبة لابناء المجتمع.
ان شرعیة كافة المؤسسات فی نظام الحكومة الدینیة ومن بینها المجتمع المدنی مستمدة من الله سبحانه الذی هو ولی الكون بأسره ومدبّره، وعلیه فالذین تصوروا وجود مصدرین للشرعیة فی دستور الجمهوریة الاسلامیة، احدهما من الاسفل یصوغ جمهوریة النظام، والآخر من الاعلى یحقق اسلامیته، انما هم خاطئون جداً.
ان جمهوریة النظام أمرٌ یتعلق بكفاءة النظام، واسلامیته تتعلق بشرعیته. وان المجتمع المدنی یستمد شرعیته من النظام الدینی فیما یستمد النظام الدینی كفاءته من المجتمع المدنی، وفی مثل هذه الحالة لن یحصل تناقض بینهما (المجتمع المدنی
والمجتمع الدینی) وسیوظّف المجتمع المدنی باتجاه تطبیق احكام الدین واضطراد كفاءة النظام الاداری والارشادی فی المجتمع الاسلامی، ویحافظ فی نفس الوقت على الحقوق والمصالح المشروعة لابنائه ایضاً.
لعل الذین یتّخذون مدینة النبی منطلقاً للمجتمع المدنی الذی ینشدونه یحملون مثل هذه الرؤیة، لان المجتمع المدنی اذا ما استُلهم من مدینة النبی اذ ذاك ستسود المجتمع القیم والاحكام الاسلامیة الواردة فی مثل هذا التعریف للمجتمع المدنی، وحقاً ستكون التضحیة بالنفس فی محلّها من اجل اقامة مثل هذا المجتمع.
* * * * *
4 ـ المرونة والعنف فی الاسلام
أ ـ بحث فی التساهل والتسامح
سؤال: ماذا یعنی التسامح والتساهل الدینی؟ وهل ان روایات من قبیل «بُعثتُ بالحنفیّة السمحة السهلة»(1) تدل على امكانیة ان یتحلى الناس والحكام بالتسامح والتساهل لدى عملهم باحكام الدین؟
جوابه: من الامور التی ینبغی ان تحظى بالاهتمام فی مضمار الثقافة والفكر، صیاغة المعانی بشفافیة وازاحة الغموض عن المفاهیم وتجنب استخدام المفردات الفضفاضة. فاذا لم یتضح المعنى الدقیق للمفردات ودائرتها، ربما یصبح ذلك سبباً لسوء الفهم وبالتالی یجعل الكلام أو المقالة مضلّلة، لذلك ومن خلال معرفة هذا الأمر ینبری البعض وعبر استخدامهم للمفاهیم الغامضة لتضلیل مخاطبیهم لیتسنى لهم عن هذا الطریق تحقیق منافعهم الشخصیة والفئویة والتصیّد بالماء العكر.
من هنا، فان انجع السبل للحیلولة دون اساءة الفهم، صیاغة مثل هذه المفاهیم بشفافیة وتسلیط الاضواء على حدودها، ومفردتا «التسامح والتساهل» من هذا القبیل.
من الناحیة اللغویة تعنی التسامح والتساهل ابداء اللیونة، والمجاملة والعمل بما ینسجم مع رغبة الطرف المقابل والتهاون. فلننظر ما اذا كان هذا المعنى خلیقاً بأن یُلصق بالدین أم لا؟ واذا لم یكن الأمر كذلك فایُّ منحىً یتخذه الحدیث النبوی المتقدم وامثاله؟
من الظاهر للعیان عدم صحة الصاق التسامح والتساهل بالمعنى الآنف الذكر بالدین وتعذُّر القبول به، لان احكام الدین انما شُرعت بالاساس لضمان منافع
1. بحار الأنوار: 67/ 166.
الانسان الدنیویة والاخرویة، وثمة علاقة علیّة وتكوینیّة وحقیقیّة بین العمل الدقیق والكامل بهذه الاحكام وتحقق تلك المنافع التی شأنها كأی نتیجة اخرى یتوقف حصولها على توفیر المواد الاولیة والظروف الخاصة بها. فبلوغ المنافع الفردیة والاجتماعیة للانسان اخرویها ودنیویها منوط ایضاً بالعمل الدقیق والصحیح بتلك الاحكام ودون نقص أو تهاون.
ان الاسلام دین جامع وشامل اوضح بدقة الواجبات المنوطة بالمسلمین فی كافة المجالات العبادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، ومن بین ذلك اهتمامه بطبیعة تعامل المسلمین مع بعضهم وتعاطیهم مع المعاندین والمشركین. وهو یدعو المسلمین للالتزام بالحدود والقیم الالهیة فی علاقاتهم، ولم یكتف الاسلام بعدم القبول بادنى تسامح أو تساهل فی الالتزام بهذه الحدود والعمل بالتعالیم الالهیة، وانما نهى بكل صراحة عن التساهل والتهاون فی تطبیق القوانین والاحكام الالهیة، فعلى سبیل المثال، الخطاب الوارد فی القرآن الكریم والموجَّه للمسلمین فیما یتعلق بتطبیق حد الزنا:
«الزّانِیَةُ وَالزّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»(1).
استناداً للآیة المتقدمة یجب عدم التأثر بالعواطف حین تطبیق الحد الالهی، والتمهید لانتشار الفساد من خلال التهاون فی تطبیق الحدود الالهیة، ففی مثل هذه الحالة سیطال الانحراف المجتمع الدینی والانسانی.
كما وضعت الاحكام الاسلامیة ضوابط معینة للتعامل مع المعاندین والمشركین ولا تسمح بادنى تهاون أو مجاملة بشأنهم، فعلى سبیل المثال ایضاً، یأمر القرآن الكریم فی ظل ظروف خاصة:
1. النور: 2.
«وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ»(1)، أی اقتلوا المشركین والكفّار المحاربین والناكثین للعهد الذین اعتدوا علیكم وعلى ممتلكاتكم حیثما وجدتموهم.
بناءً على هذا اذا كان التسامح والتساهل یعنی الاهمال فی تطبیق احكام الدین أو التهاون والمجاملة ازاء إضعاف وهتك حرمة القوانین والقیم الاسلامیة ـ العقائدیة منها والاخلاقیة ـ فهو مما لا یقبله الدین اطلاقاً وان الاسلام ینبری لمقارعته بشدة، كما ان المجاملة والمرونة حیال اعداء الاسلام والنظام الاسلامی الذین یرومون توجیه ضربة للنظام واضعاف معتقدات الناس، أمرٌ لا یطیقه الدین والنظام الدینی أبداً، ولا یحق لایٍّ من منتسبی الدولة أو غیرهم ممارسة مثل هذا التسامح والتساهل.
أما ما روی عن النبی الاكرم(صلى الله علیه وآله) فهو تنویه لمنّة الشارع المقدس ورأفته بالمسلمین، وبعبارة اخرى ان الله سبحانه وتعالى قد منَّ على الناس بالتساهل فی مرحلة تشریع الاحكام وسنّ القوانین، ولم یشرّع الاحكام الاسلامیة بنحو یتعرض معه العباد للشدائد والصعاب التی لا تطاق. وكنموذج على ذلك، فقد شرَّع التیمم إذا كان فی الوضوء واستخدام الماء ضرر على الانسان لأی سبب من الاسباب، وذلك للحیلولة دون حصول عارض أو ضرر للانسان، وكذلك رفع أی حكم یوجب العسر والحرج «وَما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج»(2).
وبشكل عام فان منظومة الاحكام الاسلامیة احكام سهلة وسمحة، وبهذا المعنى فقط تأتی السهولة الدینیة.
اذن السهولة الواردة فی حدیث رسول الله(صلى الله علیه وآله) والاحادیث المشابهة له انما یقصد بها مقام تشریع الاحكام الذی هو بید الله سبحانه ولیس لأحد التدخل وتمریر ذوقه فی هذا المقام أبداً، والسماحة فی هذه المرحلة انما هی من صلاحیات الباری تعالى وحقّه بالذات. أما التساهل والتسامح الدینی بمعنى التهاون فی تطبیق التعالیم الدینیة والعمل بها، أو المرونة ازاء عملیة اضعاف الاحكام والمعتقدات الدینیة أو التصرف
1. البقرة: 191.
2. الحج: 78.
بما ینسجم مع رغبة الاعداء والمعاندین ـ وذلك بأجمعه على صلة بمرحلة التطبیق وفعل الناس ـ فهو مما لا موقع له فی الدین أبداً.
ولا ننسى هذه الملاحظة من ان التحلی بالتساهل والمسامحة ازاء الذین لا یضمرون للاسلام والمسلمین العداء والعناد لیس محبذاً فحسب بل الاسلام یوصی به ایضاً كى تلین قلوب الكفار من غیر المحاربین المعاندین تحت ظلال الرحمة والرأفة الاسلامیة وینجذبوا نحو الاسلام والمسلمین:
«لا یَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوكُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»(1).
بناءً على هذا، اذا ما اردنا التحدث عن التسامح والتساهل فی الدین فان مصداقه الصحیح تلك الحالات التی لا یكون فیها الآخرون معاندین واعداءً للاسلام والمسلمین وللنظام الاسلامی.
ب ـ الدین واللجوء الى الشدة والعنف
هل للعنف موقع فی الاسلام؟ وهل الجهاد وتطبیق الحدود والمراتب العلیا من الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر من مصادیق العنف المذموم؟
للاجابة على هذا السؤال علینا أولاً ایراد مقدمة لیتضح من خلالها هل ان كل نوع من العنف مذموم ولابد من إدانة كل اشكاله، أم ان بعض صور العنف تعد من مستلزمات الحیاة الاجتماعیة وسیتفكك بناء النظام والامن فی المجتمعات فی حالة عدم ممارستها؟
ان الانسان مخلوق اجتماعی بالطبع، وان البشر یندفعون نحو الحیاة الجماعیة لغرض تلبیة متطلباتهم المادیة والمعنویة، ومن خلال بناء المجتمعات یحاولون التنعم بوجه افضل بمكتسبات الحیاة الاجتماعیة والتفاعلات الانسانیة وكذلك
1. الممتحنة: 8.
استثمار حصیلة جهود الآخرین بتسلیم ما یقابلها من اثمان أو تقدیم خدمة متبادلة، لتحقیق تطلعاتهم بمزید من السرعة والسهولة وبنحو اكثر ملائمة عن هذا الطریق. ولكن هنالك على الدوام أناسٌ یحاولون استغلال جهود الآخرین دون عناء وضمان مآربهم ومصالحهم عبر اهمالهم ومصادرتهم لحقوق الآخرین ومصالحهم، كما ان طبیعة مثل هذه الحیاة الجماعیة وجود التزاحم والتضارب بین مصالح الناس. من هنا تقع هنالك سجالات على صعید المجتمع یتحتم وضع حدود وسنّ قوانین للحیلولة دونها.
بناءً على هذا، فالهدف المتوخى من الحیاة الاجتماعیة، وهو التنعم الامثل بمواهب الطبیعة من اجل بلوغ التكامل المادی والمعنوی للانسان ـ ولأبناء المجتمع كافة ـ انما یتحقق بوجود القانون الذی یحدد لكلٍّ من ابناء المجتمع حقوقه وواجباته.
یتم فی البدایة ابلاغ القانون ـ الذی یمثّل مجموعة من الواجبات والمحظورات التی ترسم طریقة تعامل الانسان فی الحیاة الاجتماعیة ـ لأبناء المجتمع لیعدّوا بامتثالهم له مقومات الانتفاع الصحیح والتام من الحیاة الاجتماعیة، لكننا نعلم جیداً ان فی المجتمعات وعلى مر التاریخ أناساً كانوا ولازالوا یتجاهلون القانون، وبمصادرتهم لحقوق الآخرین یعرّضون النظام والامن والاستقرار فی المجتمع للخطر.
من هنا فان البشر وبمقتضى عقلهم یرون ضرورة وجود قوة تكفل تطبیق القوانین والتصدی للخاطئین، ولهذا السبب یبادرون لتأسیس قوة مقتدرة مهمتها تطبیق القانون وكذلك تحدید العقوبات الخاصة بالمتخلفین عن القانون. وان وجود قوى الامن الداخلی والشرطة وتشكیل السلطة القضائیة والمحاكم والحكم بالسجن والنفی... الخ، یأتی كل ذلك بهذا الاتجاه ولغرض تحقیق هذین الهدفین. ومن ناحیة اخرى ان حالات التطاول والاخطار الخارجیة التی تهدد من خارج الحدود أمن
البلاد ووجودها ونظامها الاجتماعی، أو بعض الازمات الداخلیة الكبرى تجعل من الضروری وجود جیش مقتدر فی كل مجتمع لكی یتدخل فی الوقت المناسب ویقرّ الامن والنظام ویحافظ علیهما.
بناءً على هذا، هنالك فی جمیع بلدان العالم آلیات وقوات تنبری لمجابهة حالات انتهاك القانون والتجاوز على حقوق الآخرین أو الاخطار الداخلیة والخارجیة، فتتصدى لها وتتعاطى معها بكل اقتدار وبما یتناسب مع حجم الجریمة وطبیعتها، وفی بعض الحالات تلجأ الى ممارسة بعض العقوبات أو حتى القمع والحرب وبذلك تحافظ على حقوق الناس وأمن المجتمع. من هنا مادام اللجوء للقوة أمراً لا مناص منه ویأتی على ایدی الجهات المسؤولة وبصیغة قانونیة فهو مقبول لدى كافة الانظمة فی العالم.
والاسلام بدوره یصوّب هذه السیرة العقلائیة ویضع عقوبات لمواجهة الذین یهددون المسلمین فی ارواحهم واموالهم أو المواطنین من غیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی. وان الاسلام ـ بطبیعة الحال ـ لا یرى اقتصار حیاة الانسان على الحیاة الدنیا ولا منافعه على المنافع الدنیویة بل هو یعتقد ان الله سبحانه وتعالى یرید من الانسان وحیاته فی هذا العالم ان تكون مقدمة لغایة اسمى هی الحیاة الاخرویة الخالدة الدائمة، ویحفظ لكافة البشر حقّهم فی التكامل وبلوغ السعادة الابدیة. وعلیه فان القوانین التی یشرّعها لحیاة الانسان ببعدیها الفردی والاجتماعی انما تأتی عبر الاخذ بنظر الاعتبار المنافع الدنیویة والاخرویة للانسان.
من هنا لا یطیق الاسلام مخالفة قوانینه الفردیة والاجتماعیة، وبالرغم من اعتباره التمرد على الاحكام الفردیة ـ ما لم تتخذ المخالفة طابعاً اجتماعیاً نتیجة التظاهر بها أمام الآخرین ـ جریمة اخلاقیة ویُرجئ الحساب علیها حتى یوم القیامة، لكنه یعتبر مخالفة قوانینه الاجتماعیة جریمة حقوقیة یضع عقوبات وحدوداً لمرتكبیها ولا یسمح فی بعض الحالات بالرأفة بحال المجرمین اطلاقاً:
«الزّانِیَةُ وَالزّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ...».
ان ممارسة العنف أو ای فعل آخر یخرج عن اطار القانون یعد نوعاً من الاجرام وهو مرفوض، وفی ظل نظامنا الاسلامی حیث القانون عبارة عن الموازین الاسلامیة والقوانین المسنونة فی اطار الاسلام، تعد أیة مخالفة لهذا القانون جریمة.
استناداً الى ذلك، یصبح اللجوء للقوة فی بعض الحالات مقبولا سواء فی الانظمة غیر الدینیة أو فی ظل النظام الاسلامی ولا یُمكن التخلی عنها بصورة مطلقة وكاملة، ففی مثل هذه الحالة سیتعرض أمن الناس فی مجال أموالهم وانفسهم ومعنویاتهم للخطر وتضیع مصالح البلاد وحقوق المواطنین، لذلك لیس للقوة بذاتها قیمة ایجابیة ولا قیمة سلبیة بل ان تقییمها خاضع لظروفها واسباب ممارستها.
من المناسب هنا ان نتحرى رأی القرآن بهذا الصدد كی نتعرف بمزید من الدقة وعلى احسن وجه على الرؤیة الاسلامیة.
لا وجود لمفردة «العنف» فی القرآن الكریم ولكن استخدمت بدلاً عنها مفردتان أُخریان هما «الغلظة» و«الشدّة» وكلتاهما مرادفتان للعنف.
وتعنی مفردة الغلظة كما صرّح بذلك اللغویون: الخشونة، الشدّة، الاستغلاظ، والحدة فی الطبع، وتستخدم ضد الرقّة(1).
وتعنی الشدّة ایضاً الغلظة، التشدّد، والتصلب وهی تستخدم ضد الرقة(2).
وبالتالی فان مفردة العنف تعنی الشدّة والغلظة والحدّة وتستخدم فی مقابل الرقة(3).
لقد استخدمت مفردتا الغلظة والشدّة ـ كما صرّح بذلك المفسرون ـ فی الاستخدامات القرآنیة بمعناها اللغوی، فقد ورد ـ على سبیل المثال ـ فی الآیة 73
1. راجع: لسان العرب، تفسیر الكشاف، مجمع البیان، التفسیر الامثل.
2. نفس المصدر.
3. راجع: لسان العرب.
من سورة التوبة والآیة 9 من سورة التحریم:
«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ».
أو ما جاء فی الآیة 123 من سورة التوبة:
«... وَلْیَجِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً ...».
وورد كذلك فی الآیة 29 من سورة الفتح:
«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ ...»
هذه الآیات ونظائرها تحكی عن جانب الارغام فی الاحكام الاسلامیة التی تطبّق فی محلها ووفقاً للضوابط التی یضعها الشرع المقدس.
بناءً على هذا، بالرغم من ان الاسلام دین الرحمة والعطف وان الله تبارك وتعالى ارحم الراحمین والقاعدة الاولى فی الاسلام تقوم على الرأفة والرحمة، بید ان ذلك لا یعنی أبداً انكار أی نوع من التعامل الحازم واللجوء الى القوة والشدّة فی محلّها، لذلك فان حدیث الذین یصفون الاسلام بانه یرفض كل اشكال الغلظة واللجوء الى القوة ـ وان كانت فی محلّها وبأمر من الله سبحانه وتعالى ـ یفتقد السند القرآنی والاسلامی.
یصرّح القرآن الكریم: ان النبی(صلى الله علیه وآله) والمؤمنین یتمیزون بالشدة والغلظة فی مواجهة الكافرین ولا یبدون مرونة أبداً ازاء المتعرضین للحدود العقائدیة للمسلمین. وان تعاملوا مع اخوتهم أی الذین یعترفون بالاصول والقیم الاسلامیة بالرأفة والرحمة.
وعلیه، ان استخدام الشدة ازاء الذین ینتهكون حرمة الاسلام واحكامه النورانیة أو یعرّضون للاخطار ارواح المسلمین واموالهم وكراماتهم، لیس من مصادیق العنف ببعده السلبی، بل هو من خصال النبی(صلى الله علیه وآله) والمؤمنین الصادقین، وهذا التعامل الحازم والصلب الذی یأتی بدافع تطبیق التعالیم الالهیة یتحقق فی واقع الأمر ضمن اطار الامر بالمعروف والنهی عن المنكر، لا أن یكون نابعاً من الاهواء ومواطن الضعف
النفسی، وانما للمحافظة على الاحكام والقیم الدینیة لا غیر. وبما ان السعادة الدنیویة والاخرویة للبشر منوطة بالعمل بالدین واحكامه النورانیة وان المنفعة أو الخسران المترتبین على العمل أو عدم العمل بالاسلام تعود على العباد وحدهم، فان الذین یقفون بأی نحو كان بوجه تطبیق الاسلام واحكامه والممارسة العملیة لهما، انما یعملون فی الحقیقة على ایصاد طریق بلوغ التكامل بوجه الآخرین، من هنا یتحتم التصدی لمثل هؤلاء، واذا لم یؤثر فیهم القول باللسان، یجب التعامل معهم بشدة وباذن الحاكم الاسلامی، بل یتعیّن اللجوء الى عقوبة الإعدام بحقهم فی بعض الحالات.
بناءً على هذا، ینبغی التمییز بین العنف السلبی وبین الشدّة الاسلامیة. وتجنب الوقوع فی مصیدة أبالسة الزمان الذین یحاولون ـ بایحائهم انهما على حدٍّ سواء ـ القضاء على الحمیّة الدینیة والغضب والصلابة الاسلامیة المقدسة، والاّ سیصل الأمر بهؤلاء الى ان یصفوا النبی(صلى الله علیه وآله) والائمة الطاهرین(علیهم السلام) بالعنف والعیاذ بالله، ویصفون احكاماً من قبیل القصاص على انها غیر انسانیة، ویعتبرون استشهاد سید الشهداء فی كربلاء ردة فعل الناس ازاء العنف الذی مارسه النبی(صلى الله علیه وآله) فی معارك بدر وحنین!!
هل للولی الفقیه ان یلجأ الى القوة فی ممارسة الحكومة الدینیة؟
ان شرعیة الحكومة فی القاموس الدینی للشیعة نابعة من الاذن الالهی، ورغم ذلك لا تكفی الشرعیة وحدها لغرض تحقق الحكومة وتطبیق الاحكام الالهیة، لان الحكومة بما تتمتع به من رافد نظری مرموق لن یتیسر تحقیقها ما لم تحظَ بالقبول الشعبی.
ان الذین یتمتعون بادنى معرفة بالتاریخ الاسلامی لیقفون على خواء القول بان الاسلام انما انتصر واقام الحكم بقوة السلاح، اذ ان اساس الدین یقوم على قاعدة التبلیغ وارشاد البشر نحو الحیاة التی قوامها العقل والمنطق، والآیات القرآنیة اجلى شاهد على هذا المدّعى:
«إِنّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمّا شاكِراً وَإِمّا كَفُوراً»(1)، «وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ»(2)، والآیة «فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْیَكْفُرْ»(3).
بالرغم من ان النبی الاكرم(صلى الله علیه وآله) والائمة المعصومین(علیهم السلام) كانوا یتمتعون بالمعجزة والقدرة على ممارسة الحكم عبر الطرق الاستثنائیة والتوسل بالقوة الغیبیة القاهرة، غیر انهم لم یفعلوا ذلك، لان ارادة الاسلام تمثلت فی ان یتقبل الناس الاسلام والحكومة الدینیة عن بصیرة ووعی. فالحكومة التی تستحوذ على القلوب هی التی ستنال الاستقرار والازدهار «وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»(4)، فالله سبحانه وتعالى انما بعث الدین والشریعة الى الناس لیقوموا بانفسهم عن بصیرة ومنطق لارساء حكومة العدل والقسط.
یعتقد الاسلام بوجوب بیان الحق للناس ولیس لأحد الحق فی الممانعة من بیانه، وإن ابى كافة الذین عرفوا الحق الاذعان له.
على ایة حال، لو أن قوماً ارتضوا عن بصیرة ووعی الاسلامَ دینَ حق والنبی(صلى الله علیه وآله)أو الائمة المعصومین(علیهم السلام) أو الولی الفقیه حكاماً الهیین فهم مكلفون باقامة الحكم وادارة المجتمع على اساس الحكومة الاسلامیة والنهوض لمواجهة الذین بالاضافة الى عدم قبولهم الحكومة الدینیة یحیكون المؤامرات ضدها وضد الاحكام الالهیة، والدفاع عن كیان الدین والحكومة الدینیة ویُجبرون المخالفین على الامتثال والطاعة.
ان الذود عن الحدود الالهیة من الواجبات المسلَّم بها التی تتحملها الحكومة الاسلامیة وان التقاعس عنها بما یقتضیه من اضعاف للاحكام الاسلامیة وایصاد طریق الكمال بوجه ابناء المجتمع أو تشویهه ذنب كبیر ولا یُغتفر ستحیق عواقبه بالقائمین على الحكومة الدینیة.
وكما تقدَّم القول منا، ان اقتدار الحاكم الالهی والولی الفقیه منبعه الأمة، وان
1. الانسان: 3.
2. المائدة: 99.
3. الكهف: 29.
4. الحدید: 25.
المقبولیة لدى الامة هی التی تمنح الحاكم القدرة على ممارسة الحكم، لذلك بالرغم من تنصیب النبی الاكرم(صلى الله علیه وآله) علیاً(علیه السلام) خلیفة له واماماً للمسلمین فی غدیر خم، لكن بما انّ هذا التنصیب لم یقترن باسناد الامة ودعمها فقد أُعذر امیر المؤمنین(علیه السلام) عن القیام باقامة الحكومة والنهوض بمسؤولیته، بید اننا جمیعاً نعلم بمجرد مبایعة الامة له(علیه السلام)ومدّ ید العون له لتطبیق الاحكام الالهیة، وقف أمیر المؤمنین(علیه السلام) متوسلاً بالقوة القاهرة لیواجه اعداء الحكومة الاسلامیة فوقعت احداث من قبیل معركة الجمل وصفین والنهروان وتجلّت نماذج عملیة وواقعیة لتعامل الحاكم الدینی مع المعاندین.
بناءً على هذا، شرعیة الحاكم ـ أی احرازه الحق فی الحكم ـ انما تنشأ من الاذن الالهی، ومنشأ القدرة على ممارستها هو القبول الشعبی، وان الحاكم الاسلامی واعتماداً على هذه القدرة المنبثقة عن الامة مكلفٌ بالتصدی لمنتهكی القانون ومخالفیه وارغامهم على الامتثال وطاعة القوانین والقیم الاسلامیة.
ولا یخفى ان الحاكم والدولة الاسلامیة لیس لهما الحق بالتدخل فی الشؤون الفردیة والخاصة بالافراد، فالناس احرار فی دائرة قضایاهم الشخصیة ولا یحق للحكومة التعرض لهم، وهذا ـ بطبیعة الحال ـ ما لم یتجاهروا بالفسق ولم ینتهكوا حرمة الاحكام والقیم الدینیة ـ بما فی ذلك الاحكام الفردیة للدین ـ امام الملأ العام، لان ارتكاب المعاصی أمام الآخرین من شأنه التقلیل من قبح المعصیة ویؤدی الى ظهور المفاسد والمخاطرة بمصالح الناس والمجتمع، وهو فی واقع الأمر سیهدر حقوق الآخرین فی بلوغ الكمالات والمنافع الدنیویة والاخرویة.
اذن بمقدور الولی الفقیه والدولة الاسلامیة التصدی للمفاسد وحالات انتهاك القانون، وذلك بالتذكیر والكلام أولاً، فان لم ینفع لجأ لفرض القانون باستخدام القوة القاهرة.
* * * * *
5 ـ الدین والافكار الالتقاطیة (القراءات المتعددة والبدع)
سؤال: ما هو الفكر الالتقاطی؟ وما هی علاقته بالبدعة فی الدین؟
جوابه:
أ ـ تشابه الفكر الالتقاطی مع البدعة
الالتقاط تعنی فی اللغة التناول والاخذ من الارض، والفكر الالتقاطی یُطلق على نمط معین من التفكیر، ولایضاح هذا النمط من الفكر لابد لنا من ایراد مقدمة هی:
یؤكّد اصحاب الفكر والرأی على القول بأنه: «خلیقٌ بكل مفكر الادلاء برأیه فی حقل اختصاصه» ویعتقدون بوجوب استطلاع رأی الخبراء فی كل فنٍّ اذا ما اتخذت الموضوعات طابع التخصصیة. ولكن ربما یبرز فی مقام العمل احیاناً أُناس یتجاهلون القاعدة العقلیة الآنفة الذكر فیدلون بآرائهم فی مختلف المجالات التی لا تعد قطعاً من اختصاصهم.
تقوم هذه الطائفة من الناس بانتقاء رؤیة معینة من بین النظریات المطروحة فی كل حقل من الحقول، ودون معرفة بالاسس الفكریة للرؤیة المنتقاة تتخذ مجموعة من الرؤى كفكر لها وتقدمه للآخرین، وقد یتیسر تشخیص التباین بل وحتى التناقض بین مفاصل هذه الفكرة بقلیل من الدقة.
انهم ـ على سبیل المثال ـ ومن خلال ما قاموا به من مطالعات فی مجالات علم النفس وعلم الاجتماع والسیاسة والحقوق والفلسفة والدین، یقومون بتسجیل مجموعة من النظریات التی تنبثق كلٌّ منها عن مشرب معین، وهذه النظریات لم تتبلور على اساس التحریات الدقیقة والمعمقة فی الاسس الفكریة لها والاخذ بنظر الاعتبار تطابقها أو تناقضها، بل تحظى بالقبول التام لشدة انسجامها مع سلیقة مَنْ تولى تدوینها، ومن ثم تأخذ مكانها الى جانب سائر النظریات.
ان اهم إشكال یرد على مثل هذه الآراء غیر التخصصیة هو عدم تجانسها مع بعضها. ولهذا السبب بل للتناقض الموجود فیما بینها ایضاً، فهی عاجزة عن بلورة مجموعة متجانسة من الافكار الصحیحة.
بناءً على هذا فان ما یصطلح علیه «الفكر الالتقاطی» عبارة عن: مجموعة من النظریات المنبثقة عن مذاهب متباینة وربما متناقضة جُمعتْ مع بعضها، ونظراً للتباین فی اسس هذه المذاهب والنظریات وقواعدها أو تضادها فبعضها ـ على سبیل المثال ـ منبثق عن المذاهب القائلة بمحوریة الانسان، وآخر عن المذاهب التی تؤمن بمحوریة الله، وثالث یقوم على اساس اصالة الفرد فیما ینبثق بعضها الآخر من المذاهب القائمة على اساس اصالة المجتمع، بعضها نابع من «اللیبرالیة» و«فصل الدین عن الدولة»، وتقوم اخرى على اساس محوریة الدین ـ فقد وقع بعض اصحاب الفكر الالتقاطی فی ورطة التعددیة ونظریة ان جمیع الادیان والافكار صادقة.
لقد تفشى هذا النمط من التفكیر ـ الفكر الالتقاطی ـ فی مجتمعنا الاسلامی ایضاً لاسیما خلال نصف القرن الاخیر بین اوساط الذین لا یتمتعون بقوة فكریة وقدرة تحقیقیة وعلمیة كافیة، فلیسوا قلیلین مَنْ هم مسلمون وغیر مستعدّین ـ حین الحدیث ـ للتنازل عن كل الاسلام والمعتقدات الدینیة من جانب، لكنهم من جانب آخر فی غایة الانبهار بنظریات الآخرین فی شتى المجالات، وهم فی نفس الوقت لا یتمتعون بالتخصص فی المسائل الدینیة بما فیه الكفایة ولا فی المجالات التی یدلون بدلوهم فیها.
من الطبیعی ان یستدعی البحث عن الحق فی بعض الموارد ان یقوم المرء بمراجعة دقیقة لافكاره لئلا یكون هواه قد غلب منطقه وعقله ـ لاسمح الله ـ ولئلا یقع المرء دون وعی منه فی مصیدة الماكرین.
ثمة اصطلاح فی الروایات الاسلامیة وهو «الاجتهاد بالرأی» وهو عبارة عن ممارسة الحكم المسبَق وتحكیم الرغبات الشخصیة فی استنباط الاحكام، وهذه
الطریقة من الفهم للدین موضع ذم شدید من قِبل هذه الطائفة من الروایات، ویقف فی مقابلها الفهم الصحیح والعقلائی للدین وهو المعروف بـ «الفقاهة».
ربما یكون المرء محمّلاً بمجموعة من السوابق الذهنیة والرغبات الشخصیة قبل قیامه بالتحقیق حول أیة مسألة، فان لم یتخلص منها فی مقام التحقیق فلن تكون النتیجة الحاصلة من التحقیق اصیلة ونزیهة، من هنا فان إقحام بعض الدوافع الباطنیة من قبیل: حب الشهرة، نیل الشعبیة والموقع الاجتماعی، أو سائر المصالح الشخصیة فی عملیة الاستنباط من الدین ممّا من شأنه دفع الانسان لتوجیه وتفسیر الاحكام والمعارف الدینیة بالنحو الذی یصب بالنهایة فی صالح مآربه النفسیة یُسمى «الاجتهاد بالرأی»، وهذا الفهم للدین هو فی الحقیقة إملاءٌ لمعتقد المرء ورأیه على الدین ولیس فهماً محایداً وطالباً للحق.
ان اشتراط العدالة والتقوى الى جانب شرط الاجتهاد ـ القدرة على الاستنباط المنهجی والعقلائی من الدین ـ فیما یتعلق بالذین یتصدون للمرجعیة الدینیة للناس، انما یأتی للحد من «الاجتهاد بالرأی» ومن خلال الجمع بین الاجتهاد والفقاهة وبین العدالة والتقوى بما یحقق الشرط العلمی الضروری وكذلك المؤهل الاخلاقی للاستنباط عن الدین، ستكون لما یُستنبط كنتیجة لهذا التحقیق الحجیة على المجتهد ومقلدیه.
وهنالك مفردة اخرى تستخدم فی العرف الدینی تسمى «البدعة فی الدین» وهی عبارة عن: نسبة ما لیس من الدین للدین نتیجة للاجتهاد بالرأی والفهم الالتقاطی لمصادر الدین، فكلما قلنا ان الاجتهاد بالرأی هو اقحام السوابق الذهنیة والنظریات التی تم قبولها سلفاً فی عملیة الاستنباط عن الدین، وهذه النظریات بطبیعتها انما تتبلور فی عقول المحققین عن مذاهب ومشارب غیر دینیة أو تتنافى مع الدین ایضاً، وإلاّ لو كانت منبثقة عن الدین وجزءاً منه لما تناقضت مع جوانب الدین الاخرى أبداً.
بناءً على هذا؛ من الممكن اعتبار البدعة نتیجة الفكر الالتقاطی، واعتبار الفكر
المذكور نتیجة لتدخل المآرب النفسیة والمیول الشخصیة فی معرفة الدین وتفسیره.
لا یخفى بان ما ینسبه اصحاب الفكر الالتقاطی للدین، ونظراً لعدم اقترانه بالفهم الصحیح والمحاید للدین وفقدانه للمقدمات والشروط الضروریة لهذا الأمر، لا حجیة له من الناحیة العقلیة والشرعیة لا فیما یتعلق باصحاب هذا الطراز من الفكر انفسهم ولا غیرهم، ولا یقوى على الاجابة عن مساءلة الباری تعالى فی الآخرة عن الافعال.
ب ـ مفهوم دین الاقلیة ودین الاكثریة
ما المراد من دین الاقلیة ودین الاكثریة؟ وأیُّ مدىً فی حیاة الانسان فی اطار الثقافتین الاسلامیة والغربیة؟
بغض النظر عمّا ینطوی علیه ای دین من تعالیم تخص حیاة الانسان، وكنظرة خارجیة للدین، یتبادر السؤال التالی وهو: فی ایٍّ من الموارد ینبغی إلتماس التوجیه والعون من الدین؟
قُدّمت ثلاثة اجوبة لهذا التساؤل، اتخذ الاول منها جانب الافراط، والثانی جانب التفریط فیما نحى الثالث منحى الاعتدال.
الجواب الاول
ان ما یقال بان على الانسان استلام الاوامر من الدین فی كافة شؤون حیاته الفردیة والاجتماعیة بدءاً من طریقة تناوله للطعام وارتداء الملابس، وبناء الدار والعمران، والجلوس والقیام، والمشی والمنام وانتهاءً باقامة الحكومة، وتحدید واجبات المسؤولین وطریقة ادارة البلاد وكذلك تفصیل الموضوعات العلمیة المختلفة، والحصول على المزید من النجاح عن طریق الدین دون مشقة وتجشم لعناء التحقیق والدراسة.
مثل هذه الرؤیة للدین ـ التی ترى الدین مُلزَماً بتلبیة كافة متطلبات الانسان ـ
تُسمى رؤیة «الاكثریة» ونظراً لأن الدین وفقاً لهذه الرؤیة یلبی كافة التوقعات فلن تكون للانسان حاجة للاستعانة بقوة العقل، والعمل على تفتّح ما وهبه الله من قابلیات.
ان هذا النمط من الفهم للدین خاطئ تماماً وبعید عن الحقیقة، ولا یقوى على الافصاح عن دین الحق بما یدعو له من اقصاء لعقل الانسان وقدراته ویدّعی لنفسه تلبیة كافة متطلبات الانسان.
بعد رفض رؤیة الاكثریة للدین، یتبادر هذا السؤال من جدید وهو: ما هی الحدود الحقیقیة للدین؟ وما هی الامور التی یُلزَم الانسان فیها باتباع الدین؟ إنه سؤال تسبب منذ عدة قرون مضت بالكثیر من السجالات بین رجال الكنیسة والسیاسة فی الغرب وانتهى فی خاتمة المطاف الى وثیقة سلام غیر مدونة تمثل فی الحقیقة الاجابة الثانیة على السؤال المطروح.
الجواب الثانی
یقال: ان حیاة الانسان تشتمل على بُعدین دنیوی واخروی، وان كلا البعدین منفكان ومستقلان عن بعضهما بنحو لا یترتب أی اثر لسیرة الانسان فیما یرتبط بالدنیا على مصیره الاخروی، فعلى الانسان ان یستلم الاوامر من الدین فیما یخص شؤونه الاخرویة وعلاقته مع الله، أما فی الشؤون الدنیویة والحیاة فی هذا العالم فهو مأذون فی ان یعمل بما یرتضیه، وهذه هی النظریة العلمانیة أو فصل الدین عن المیادین الاجتماعیة، والمعروفة بنظریة «الاقلیة».
ان هذه النظریة تبدو غیر صحیحة ایضاً، فبالرغم من امكانیة تقسیم حیاة الانسان الى قسمین دنیوی واخروی، وان الدنیوی منها یبدأ منذ الولادة وینتهی عند الموت، والاخروی یبدأ بالموت ویمتد الى ما لا نهایة، وان لكلٍّ من هذین القسمین خصائصه، بید ان هذا التقسیم لا یعنی ان سلوك الانسان وافعاله فی الدنیا على
قسمین ایضاً: اعمال دنیویة واعمال اخرویة ولا علاقة لأیٍّ منهما بالآخر.
ان مثل هذه النظریة ـ التی ترى الدین عبارة عن طقوس فردیة أو جماعیة تجرى فی المعابد من قبیل الكنیسة والمسجد وما شابههما لا غیر، ویقتصر على العلاقة الفردیة للناس مع الله ولا شأن له بالحیاة الاجتماعیة ـ بالاضافة الى عدم استنادها لأی دلیل صحیح، فهی لا تنسجم بأی حال مع مضامین الادیان الالهیة، وكما نعلم ان كل دین حقٍّ ـ بغض النظر عن سعة احكامه وضیقها ـ یدّعی بان الانسان مكلَّفٌ بتنظیم سلوكه وافعاله ببعدیها الفردی والاجتماعی حسب احكام ذلك الدین، ولا یمكن للبشر العمل فی الدنیا بما یحلو لهم، ویتجلى هذا المعنى جیداً من خلال القاء نظرة سریعة على مضامین الادیان السماویة لاسیما الدین الاسلامی الحنیف.
الجواب الثالث
یقال: ان الحیاة الاخرویة للانسان هی ـ على وجه الدقة ـ ثمرة ونتیجة سلوكه واعماله الدنیویة، أی بمقدور الانسان ان یؤدی اعماله وافعاله بنحو تكون نافعة لآخرته، كما بمقدوره العمل بنحو یلحق الضرر بآخرته. ان الانسان حقیقة متحركة وفی حالة صیرورة وهو الذی یقرر بناءه الوجودی وطبیعة حیاته فی ذلك العالم بافعاله وسلوكه، ویتعین علیه الالتزام باحكام الدین الواجبة لدى انتقائه لطریقة التصرف. وهذه الرؤیة هی ذلكم الفكر الاسلامی الاصیل الذی لا یطیق نظریة «الاكثریة» الافراطیة، ولا یقبل نظریة «الاقلیة» التفریطیة.
وللایضاح نقول ان اعمال الانسان وممارساته تُقسم فی الفقه الاسلامی الى خمسة اقسام هی:
1 ـ الواجبات: وهی التكالیف الملزِمة التی أُرید للانسان ان یؤدیها على نمط معین من قبیل الصلاة والصیام والحج... الخ.
2 ـ المحرمات: وتُطلق على الافعال التی یجب تجنبها وعدم القیام بها من قبیل تعاطی المسكرات والتعدی على حقوق الآخرین... الخ.
3 ـ المستحبات: وتُطلق على الاعمال التی لا إجبار فی ادائها غیر ان القیام بها نافعٌ لضمان سعادة الانسان، من قبیل النفقات المستحبة وإعانة الفقراء.
4 ـ المكروهات: وهی الاعمال التی من الأولى ترك الاتیان بها وان لم یكن مُلزِماً.
5 ـ المباحات: وتُطلق على الاعمال التی لم یُصدر الاسلام أمراً بها أو نهیاً عنها، ولا حثاً أو ترغیباً.
هذه الاقسام الخمسة التی تشتمل على كافة اعمال الانسان الفردیة والاجتماعیة وسیرته بصغیرها وكبیرها انما تكتسب معناها من خلال العلاقة بسعادة الانسان ومصالحه الدنیویة والاخرویة، وبتعبیر آخر، ان تلك الطائفة من الافعال والاعمال التی لا مناص من ادائها لضمان السعادة تسمى الواجبات، والطائفة التی لابد من تركها للتخلص من الشقاء والتعاسة تسمى المحرمات، والاتیان بالمستحبات وترك المكروهات مفید أیضاً فی تحقیق السعادة، ولهذا السبب تحظى بالاهمیة. اما المباحات فهی امور لا تأثیر لها على السعادة والشقاء، والإتیان بها تلقائیاً لا یقرّب الانسان من الكمال ولا یبعده عنه.
الآن وفی ضوء التقسیم اعلاه، حریٌ القول: ان كافة الامور التی لا تخضع لالزام الدین باصلها أو كیفیة ادائها، تدخل فی دائرة تخطیط الانسان وتحقیقه ودراسته، فاتخاذ القرار بشأن اصلها وطبیعة ادائها موكول لعقل البشر وقواهم الفكریة، لیمهدوا من خلال ابحاثهم واستثمار المكاسب العلمیة والتحقیقیة للآخرین، الارضیة لبلوغ المزید من الكمال وعلى افضل وجه وتحقیق مصالحهم.
من هنا فان الاسلام فی الوقت الذی خصص لكل عمل وسلوك بل وحتى لافكار الناس وظنونهم واحداً من هذه الاحكام الخمسة الآنفة الذكر «الواجب، والحرام، والمستحب، والمكروه والمباح» وبذلك فهو یؤطر كافة اعمال الانسان
داخل اطار نظامه القیمی، لكنه لا یروم أبداً اخماد جذوة العقل والحیلولة دون حیویة الفكر والطاقات البشریة، بل انه ومن خلال تعابیر عدیدة یحث الناس على طلب العلم والرقی الفكری والتطور والتقدم والاستعانة بعلم الآخرین وان كانت هذه بعیدة المنال «اطلب العلم ولو كان بالصین».
بناءً على هذا، فالاسلام یرى ان الدنیا والممارسات الفردیة والاجتماعیة للانسان فیها تمثل مقدمة للآخرة، وان الحیاة فی العالم الآخر ثمرة وحصیلة عمل الانسان فی هذا العالم، وهو لا ینسجم بالمرّة مع الفكر العلمانی فی الغرب الذی یقصی الدین عن میدان الحیاة الاجتماعیة ویمنحه الدور المحصور فی حدود العلاقة الشخصیة للانسان مع الله.
ج ـ اختلاف موضوع القراءات المتعددة للدین مع موضوع تعدد الفتاوى
ماذا تعنی القراءات المتعددة للدین؟ وما الفارق بینها وبین تعدد فتاوى المراجع فی بعض المسائل؟
تنشأ القراءات المتعددة للدین من فكر التعددیة الدینیة فی البعد النظری، هذا الفكر الذی ربما یحاول اعتبار حقیقة الدین امراً مكنوناً عند الله وحده ولا سبیل للبشر ومنهم الانبیاء الیه أبداً، ویوحون بان الادیان الالهیة صورٌ متعددة لتلك الحقیقة الواحدة.
یتصور المذهب المذكور ان تعدد الادیان ناجم عن اختلاف الفهم للدین فالمسلم له فهمه الخاص به للدین والوحی الالهی وهو یختلف عمّا لدى المسیحی والیهودی وهكذا العكس؛ وان الدین كحقیقة واحدة وثابتة یختص بالله ولا سبیل أمام الانسان وحتى الانبیاء الیه، وما یخضع لحدود معرفة الانسان هو الاستنباط الذهنی وفهمه البشری لا غیر، فعلى سبیل المثال، كان للنبی(صلى الله علیه وآله)ـ والعیاذ بالله ـ فهمه للوحی الالهی والدین بما ینسجم مع الظروف الطبیعیة والاجتماعیة والقیمیة لزمانه، ولم یدرك
الدین كما هو عند الله أبداً، وفی مقام التبلیغ طرح للآخرین المزیج الناتج عن فهمه الخلیط وسوابقه الذهنیة وحالاته النفسیة.
یقول انصار هذا النمط من الفكر: لعلّنا الیوم وبسبب التطور العلمی نفوق النبی(صلى الله علیه وآله)فی فهمنا للدین؛ ویصرّحون فی نفس الوقت: لیس هنالك ما یضمن صحة ما یقع فی متناول البشر، وعلیه فلیس لأحد الحق بالادعاء بافضلیة فهمه على من سواه. وعلى هذا الاساس ستكون لدینا اعداد من الصراط المستقیم بدلاً من صراط مستقیم واحد، وان القراءات باجمعها رغم تعددها تمثل مظاهر للحق وهی بأسرها توصلنا الى هدف واحد وبالتالی لا افضلیة لدین على آخر.
من الطبیعی واستناداً لهذه الرؤیة ان الصدق والكذب، والحَسن والردیء، والحق والباطل، والدین الباطل تمثل مفردات لا معنى لها، واستناداً للنظریة المذكورة فان ما یقوله كل فرد أو فئة او طائفة بشأن الدین والله فهو كلّه حقٌ وصادق وان كانت اقاویل متناقضة فیما بینها!
الظاهر للعیان وضوح بطلان نظریة تعدّد الصراط المستقیم وفقاً للتفسیر المذكور بقلیل من التأمل، وذلك لاختلاف وتناقض الادیان فی الكثیر من مواضیعها، وحقانیتها جمیعاً انما یعنی حقانیة طرفی النقیض التی یرفضها العقل السلیم بشكل بدیهی، فلیس من عاقل ـ على سبیل المثال ـ یسعه الاقرار بصحّة تثلیث المسیحیة الى جانب توحید المسلمین باعتبارهما قراءتین لموجود واحد هو الله.
ما ینبغی الانتباه الیه هنا هو الفارق الجوهری بین هذه الرؤیة فی مجال نظریة المعرفة ـ حیث ترى نسبیة كافة المعارف البشریة ومن بینها المعرفة الدینیة وأنها تابعة للذهنیات والفرضیات المعدّة سلفاً المتمخضة عن الابعاد الاجتماعیة وغیرها من العلوم ـ وقضیة الاختلاف بین الفقهاء فی الاستنباط من المصادر الفقهیة فیما یخص بعض المسائل الثانویة والفردیة للدین، لان كلتیهما تمثلاًن دائرتین منفصلتین عن بعضهما ولا یُمكن أبداً اتخاذ تعدد الفتاوى شاهداً على صحة التعددیة الدینیة.
ان ما یُسمى بالتعددیة الدینیة ویجری الحدیث عنه فی البعد النظری تحت عنوان القراءات المتعددة یمثل نظریة لا مبرر لها منطقیاً، بینما لا یُعد اختلاف الفقهاء فی فهمهم لبعض المصادر الفقهیة فیما یخص بعض فروع الدین أمراً طبیعیاً فحسب، وانما یعد التغیر فی فهم فقیه واحد لمصدر فقهی واحد وعبر حقبتین من الزمن وبالتالی تغییره لفتواه ـ وهو أمرٌ نشهد امثلة منه ـ حدثاً طبیعیاً. وللمزید من الایضاح نشیر الى ضرورة التفكیك بین نوعین من العلوم والمعارف الانسانیة وهی:
1 ـ العلوم الثابتة التی لا تقبل التغییر.
2 ـ العلوم العادیة التی تقبل التغییر.
ان بعضاً من علوم الانسان مما لا یتطرق الیه الشك والریبة ولا مجال لاحتمال التغیر فیه أبداً، وتوجد نماذج من هذه الطائفة فی المعارف العقلیة غیر الدینیة والمعارف الدینیة ایضاً، فالانسان ـ مثلاً ـ على یقین بامتلاكه رأساً واحداً فی اعلى جسمه ولا یُعثر على عاقل یقول: لقد كنتُ مخطئاً الى الآن حیث كنت اتصور اننی امتلك رأساً واحداً، فانا ذو رأسین وهما اسفل قدمیَّ!! أو یعتقد بان 4 = 2 + 2 هی قراءة قدیمة ویتعین علینا الآن اعتبار حاصل جمعهما یساوی خمسة!. وكذا فی اصول الدین وضروریاته فلا یوجد مسلمٌ أبداً یعتقد بان الله اثنان، أو ان صلاة الصبح ركعة واحدة؛ أو بوجوب صیام شهر رجب بدلاً عن شهر رمضان، فالكتب الفقهیة ملیئة بالاحكام القطعیة التی لا تقبل التغییر ولا یشاهد فیها تغییر أو اختلاف فی الفتوى.
اما الطائفة الثانیة فهی نظریات ظنّیة ربما تتأثر بالمنطلقات والبُنى الثقافیة والاجتماعیة، وقد یكون للعلوم الاخرى دورٌ فی تبلورها، فربما تطرأ تغییرات فی هذه العلوم بتغیر الفرضیات والبنى الثقافیة والاجتماعیة الخاصة، وعلى هذا المنوال یسیر وضع العلوم العادیة.
فی مجال العلوم والمعارف غیر الدینیة لیست قلیلة النظریات العلمیة التی ثبت
بطلانها من قبیل مركزیة الارض، أو هنالك احتمال فی تغیرها، وكذا الامر فی الاحكام الفرعیة للدین حیث تشاهد نماذج من التبدل والتغیر فی الفتوى، فعلى سبیل المثال كان السلف من الفقهاء یستنبطون من ظاهر المصادر الفقهیة ان ماء البئر لیس كراً وهو یتنجس بملاقاته للنجاسة ویتم تطهیره بسحب مقدار معین من مائه، بینما یعتبر الفقهاء المعاصرون ماء البئر كراً لا یتنجس بملاقاة النجاسة. ومثال آخر على اختلاف الفقهاء فی استنباطهم هو ما اذا كان یكفی الاتیان بالتسبیحات الاربع لمرة واحدة فی الركعتین الثالثة والرابعة من الصلاة أم تجب ثلاث مرات.
ان مثل هذه الاختلافات فی الاستنباط من المصادر الفقهیة تعد أمراً ممكناً، بید ان ما لا یمكن القبول به عقلاً ومنطقاً هو ان نجعل من هذه التغیرات مستمسكاً ونقول: نظراً لما طرأ من تبدل واختلاف فی الفتوى فیما یخص هذه الموارد الفرعیة، اذن لا قدرة للانسان على امتلاك علم ثابت ویقینی وان كافة علومه عرضة للتغیر والتبدل.
هذا النمط من الكلام الذی یعبّر عنه بمغالطة الخاصّ والعامّ هو أشبه بنسج الخیال ونظم الشعر منه الى الاستدلال العقلی والمنطقی. وبناءً على هذا ثمة اختلاف جوهری بین الاختلاف فی فتاوى الفقهاء وبین القراءات المتعددة للدین. ولا یمكن اعتبار الاختلاف فی الفتاوى من مصادیق القراءات المتعددة للدین، بل ان فكرة القراءات المتعددة للدین بمعناها الذی تقدم ذكره، فكرة هجینة متناقضة منطقیاً ولا یمكن تبریرها عقلیا.
* * * * *
6 ـ الاسلام والتنمیة السیاسیة
سؤال: ما هو المراد من التنمیة السیاسیة؟ وما هی نظرة الاسلام بشأنها؟
جوابه: ان لمفهوم التنمیة السیاسیة مكانة مهمة فی میدان السیاسة وعلمها، ولكن لم یزل هنالك الكثیر من الغموض وعدم الوضوح یلف هذه المفردة(1)، ویمكن القول بجرأة انه لیس هنالك تعریف دقیق وواضح لمفهوم «التنمیة السیاسیة»، ورغم ذلك حریٌ القول: ان التنمیة السیاسیة تتركب من مفردتی «التنمیة» و«السیاسة»، وان توضیح كلٍّ منهما بامكانه ایضاح مفهوم التنمیة السیاسیة اكثر:
ان التنمیة (Development) عبارة عن نشاط یقوم به فرد أو مؤسسة أو مجتمع باكمله بالاستعانة بافضل الآلیات والمستلزمات المقترنة بالبرمجة المتكاملة لبلوغ الهدف المرسوم لذلك النظام بسرعة وعلى احسن وجه.
وفی هذا التعریف تمّت الاشارة الى عنصرین احدهما كمّی وآخر كیفی، فقولنا «بسرعة» انما نرید به الكمّ الزمانی لبلوغ المنشود، وحیثما كان ما ننشده هو ما ینشده المجتمع بأسره، سیكون ملازماً للمزید من المشاركة الشعبیة لتحقیق الهدف، واما قولنا «على احسن وجه» فنقصد به كیفیة بلوغ الهدف، وهذه الكیفیة انما تكتسب معناها عبر الآلیات والعنایة بالبعد القیمی من استخدامها والاهداف المتوخاة.
والسیاسة«politics» عبارة عن: القیادة السلمیة أو غیر السلمیة للعلاقة بین الناس، والفئات والاحزاب ـ القوى الاجتماعیة ـ والنشاطات الحكومیة داخل البلاد، وللعلاقات التی تربط الدولة مع الدول الاخرى على الساحة العالمیة(2)
1. عبد الرحمن عالم، قواعد علم السیاسة: 123، نقلاً عن لوسین بای Lucian.w.pye.
2. نفس المصدر: 30.
والتی تأتی فی اطار تحقیق اهداف ومصالح المجتمع وأبنائه.
بناءً على هذا فان مضمار التنمیة فی بعدها السیاسی یتمثل فی قیادة وادارة العلاقة بین الافراد والتنظیمات والنشاطات الحكومیة والعلاقات الخارجیة للبلاد التی انما تقام لكی یبلغ المجتمع اهدافه، وبطبیعة الحال، فان هذه الاهداف وان اشتركت فی بعض الامور لكنها تختلف مع بعضها باختلاف الدول، فعلى سبیل المثال، ان غایة بلوغ الرفاه المادی والاقتصادی فی بلادنا مقترنة بالتكامل الثقافی والمعنوی وسیادة القیم الاسلامیة؛ وبعبارة واحدة: تحقیق السعادة الدنیویة والاخرویة للمواطنین التی انما تتأتى فی ظل العمل بالاحكام والتعالیم الاسلامیة.
بناءً على هذا، فان قوام التنمیة السیاسیة یتمثل فی عنصرین احدهما كمّی والآخر كیفی. احدهما «المزید من المشاركة الشعبیة فی الشؤون السیاسیة» والآخر «ادراكهم الافضل للقضایا السیاسیة»، بید ان هذه العبارة اصبحت شأنها شأن الكثیر من الشعارات الاخرى آلة بید السلطویین لیفرغوا ـ من خلال تقدیمهم تعاریف ومعاییر خاصة ـ البلدان المستقلة ذات الثقافة والافكار الخاصة بها لاسیما الاسلام من اصالتها ویمهدوا السبیل لشن الهجوم الثقافی علیها(1).
بید ان مفهوم «التنمیة السیاسیة» الحاصل من تركیب مفردتی التنمیة والسیاسة هو مفهوم انتزاعی، والمفاهیم الانتزاعیة خاضعة للتعریف والتشخیص كلٌّ حسب معالمها(2)، وهذه المعالم تؤشر ما هی المرحلة من التنمیة السیاسیة التی یمر بها
1. لقد اسهبنا فی الحدیث بهذا الشأن وكذلك حول استراتیجیة العدو لبلوغ مآربه الاستعماریة وذلك لدى الاجابة على السؤال اللاحق من هذه السلسلة.
2. بناءً على هذا، فاننا وبتقدیمنا لتعریف مباشر لهذا المفهوم «التنمیة السیاسیة» ندرج فیما یلی المعالم الاساسیة له:
أ ـ تنامی حق التصویت والانتخابات الحرّة المتمیزة بكثرة المنتخبین.
ب ـ التسییس أو المزید من المشاركة الجماهیریة فی الاحداث السیاسیة.
ت ـ المشاركة الجماهیریة فی مراكز اتخاذ القرار.
ث ـ اضطراد المصالح من خلال الاحزاب السیاسیة واستتباب الدیمقراطیة.
ج ـ حریة الصحافة وتطور وسائل الاعلام.
ح ـ توسیع الامكانیات التعلیمیة.
خ ـ استقلال السلطة القضائیة وسیادة القانون.
د ـ محوریة الدنیا فی الثقافة ـ العلمانیة ـ .
ذ ـ قوات مسلحة بعیدة عن السیاسة.
وفی المقابل فقد ذُكرت بعض المعالم التی تؤدی الى زعزعة مسیرة التنمیة السیاسیة وهی عبارة عن:
أ ـ الفساد السیاسی الذی یصب فی المصالح الشخصیة.
ب ـ صنمیة الحكام.
ت ـ تعظیم وتكریم الفكر الرسمی الحاكم.
ث ـ التزام المسؤولین بخط الحزب الحاكم.
ج ـ التدخل الاجنبی فی الشؤون الداخلیة للبلاد.
ح ـ تسییس القوات المسلحة.
خ ـ المظاهرات الاحتجاجیة باستخدام العنف.
د ـ قمع المعارضین.
ذ ـ تفشی الفساد وسوء الادارة.
ر ـ الاغتیالات السیاسیة.
البلد، أفی مرحلة التطور وتكامل المؤسسات الجماهیریة أم مرحلة التنمیة المتزلزلة وانهیار المؤسسات(1).
والى جانب تأكیدهم على دور المشاركة السیاسیة فی التنمیة، یرى بعض ذوی الخبرة(2) فی «المؤسسة» معیاراً فریداً فی التنمیة السیاسیة. وعلى هذا الاساس فان تلكم الانظمة المزودة بمؤسسات ثابتة ومستقرة ومعقدة ومنسجمة هی التی تعتبر انظمة سیاسیة متطورة(3)، وبناءً على هذا فقد وصف امتلاك المؤسسات المدنیة المتماسكة والمستقلة بانه احدى المزایا المهمة للنظام المتقدم.
وستكون لسعة التنمیة السیاسیة آثارها ایضاً، وقد عدَّ بعض المنظّرین(4) بعض هذه الآثار بما یلی:
1 ـ تغییر الهویة من الدینیة الى القومیة ومن المحلیة الى الاجتماعیة.
1. المصدر الآنف الذكر، عبد الرحمن عالم: 127 ـ 129، بقلیل من الاختصار والتصرف.
2. صاموئیل هانتینغتن.
3. البروفسور برتران بدیع «التنمیة السیاسیة»، ترجمه الى اللغة الفارسیة: الدكتور احمد نقیب زاده، ص 82.
4. لیونارد بیندر Leonard Binder.
2 ـ تغییر الشرعیة من مصدر متعال الى مصدر واطئ.
3 ـ تغییر المشاركة السیاسیة من النخبة الى الجمهور ومن الاسرة الى الجماعة.
4 ـ تغییر توزیع المناصب الحكومیة من مستوى الموقع العائلی والتمییز الى الانجازات والكفاءات(1).
بعد المعرفة الاجمالیة لمفهوم التنمیة السیاسیة، یصل الدور لهذا التساؤل وهو: هل تنسجم التنمیة السیاسیة مع الدین والنظام الاسلامی أم لا؟
كما تقدم، فان التنمیة السیاسیة مفهوم انتزاعی یتم تعریفه فی ضوء معالمه، ومن خلال نظرة واحدة یتسنى تقسیم معالم التنمیة السیاسیة الى بُعدی الشرعیة والكفاءة، وفی مثل هذه الحالة سیَكون التطور تابعاً للتقدم والتنمیة فی هذین البعدین الاساسیین.
ان الشرعیة تعنی التوفر على «المبرر العقلانی على الحكومة والامر والنهی الذی یمارسه شخص أو فئة على الآخرین»، وبتعبیر آخر، لماذا یمتلك شخص أو اشخاص حق الأمر والنهی على الآخرین؟
كلما كان الجواب على هذا التساؤل اكثر دقة وعقلانیة تكون الحكومة اكثر تطوراً وتقدماً من الناحیة الشرعیة، وقد تحدثنا فی الجزء الاول من هذه السلسلة عن معاییر الشرعیة(2) وذكرنا فی معرض نقدنا لها بان افضل ملاك للشرعیة هو «الحق الالهی فی الامر والنهی والحكم على العباد»، لان هذا الحق متمخض عن حاكمیة ومالكیة وربوبیة (بمعنى انه صاحب الاختیار) لله تعالى التكوینیة والتشریعیة على الانسان وكافة شؤون حیاته. اذ ان الله سبحانه وتعالى وبحكمته البالغة وعلمه اللامتناهی وفضله غیر المحدود وضع قوانین ومقررات تُفضی الى مصلحة الانسان وسعادته فی هذه الدنیا وفی الآخرة، من هنا سیكون النظام الذی
1. عبد الرحمن عالم، المصدر المتقدم: ص 126.
2. الاستاذ محمدتقی مصباح الیزدی، اسئلة وردود: 1 / 17 ـ 21.
یؤسس شرعیته على اساس هذه الرؤیة ارقى نظام سیاسی.
بناءً على هذا، فان تلك الطائفة من المعاییر والنتائج الناجمة عن التنمیة التی تستدعی اقصاء المصدر الالهی السامی للشرعیة والجنوح نحو غیره من الملاكات تتعارض قطعاً مع الاسلام والنظام الاسلامی ولن تحظى بالقبول أبداً.
أما على صعید بُعد الكفاءة ـ الذی یشتمل بدوره على عدة معالم من التنمیة السیاسیة ـ فان الفكر الدینی یقتضی بان نسیر فی اطار القوانین الالهیة، وبتعبیر آخر، ان حكم الله وقانونه هو المقدّم حینما تستلزم مجموعة من الشواخص أو جزء ومفهوم من شاخص واحد تجاهل الاحكام الثابتة والقطعیة فی الاسلام، ویتم اقصاء المورد الذی یتعارض ویتنافى مع الدین، وكمثال على ذلك، ان احدى افتراضات التنمیة ومعالمها علمنة الثقافة ـ أی دنیویتها وسلخها عن الدین ـ ومن الواضح ان مثل هذه المقولة لن تحظى بقبول الاسلام والنظام الدینی، أو امور من قبیل حریة الصحافة، فهی موضع قبول مادامت لا تؤدی للاخلال بالاسس الدینیة والقیم والعفّة والمصالح العامة والامن الوطنی، مثلما ان اضطراد النشاطات السیاسیة لن یكون مسوغاً للمخاطرة بالوحدة الوطنیة ومحاولة الاطاحة بالنظام الاسلامی.
ومن ناحیة اخرى، فان القاء لمحة على تاریخ عشرین عاماً مضت على الثورة الاسلامیة تبرهن على ان الكثیر من مقومات التنمیة تعد بحد ذاتها هدیة قدَّمتها الثورة الاسلامیة بحیث وُصف نظام الجمهوریة الاسلامیة على انه من اكثر انظمة العالم شعبیة وسیاسةً، اذ ان اضطراد حق التصویت والانتخابات الحرّة، وازدیاد المشاركة السیاسیة للجماهیر فی شتى المجالات، وفی مراكز اتخاذ القرار والحریة المعقولة والمقبولة للصحافة... الخ باجمعها كانت من انجازات الثورة الاسلامیة الجبارة. اضف الى ذلك ان الشعور بالتكلیف الشرعی كعنصر قوی جداً وحافز مضاعف نحو المشاركة فی النشاطات السیاسیة من قبیل المسیرات والانتخابات والتصدی للمسؤولیات وتقدیم المعونات المادیة والمعنویة والتواجد فی جبهات
الحرب... الخ انما یتبلور نتیجة لایمان الشعب بالهیة واسلامیة الحكومة ولن یكون هنالك بدیلٌ وعوضٌ عنه اذا ما افتُقد أو تضاءل رونقه.
كما ان استقلال المؤسسات لا یعنی عدم تدخل الدین والفكر فی بناء المؤسسات داخل المجتمع الدینی وعملها وغایاتها، اذ ان فصل دائرة الدین عن دائرة سائر المؤسسات بنحو نعمل فی سائر المؤسسات بمعزل عن الدین بشكل كامل، یعد امراً لا ینسجم مع الاسلام الذی له حكمه وقانونه المنسجم مع الهدف من الخلقة على صعید كافة شؤون حیاة الانسان.
بناءً على هذا، الاسلام دینٌ لیس غیر متعارض مع التطور والتنمیة فی شتى المجالات فحسب، بل انه یرید أن یكون الانسان افضل فی یومه مما كان علیه فی أمسه، غایة الأمر انه یرید هذا التطور والرقی فی اطار اصوله واحكامه وقیمه الدینیة، لأن السعادة الحقیقیة للانسان حتّى فی هذا العالم، بالاضافة الى السعادة الاخرویة، انما تتحقق عن هذا الطریق، وإلا فان مختلف المشاكل النفسیة والاخلاقیة والفكریة التی یعانیها الغرب الآن بالرغم من تقدمه الكبیر لیس بالامر الخافی على أحد.
وكنموذج ملموس على ما ندعیه هو اسبانیا إبان عصر حاكمیة الاسلام فیها، حیث اعترف الغربیون انفسهم بانه لولا التراث الذی خلّفه الاسلام فی اسبانیا لبقی الغربیون یعیشون حالة شبه همجیة ولما حصلوا على هذه الصناعات والتطور أبداً.
بناءً على هذا، فان تلك الثّلة التی تحاول وصف الدین معارضاً للتطور ویهتفون بـ «تضاد الشریعة مع العصرنة» ویخلصون الى نتیجة مفادها: إما القبول بالتطور والحداثة واقصاء الدین جانباً، وإما الوفاء للدین والتخلف عن ركب التطور والتنمیة؛ إما هم یجهلون الاسلام أو یحاولون القضاء على الدین والتدین ومسخهما فی المیادین الاجتماعیة على اقل تقدیر وسیادة العلمانیة.
ولا نُخفی ان المسلّم به عند دعاة التنمیة السیاسیة هو «النسبیة» فی المعرفة
بمعنى ان لیس من أحد أو فكر یمثّل حقاً مطلقاً، وعلیه لابد من التحلی بالمداراة والتساهل مع مختلف الافكار لان لكلّ مذهب نصیباً من الحق، وان الاستنباط من الدین والنصوص الدینیة لیس مستثنىً من هذه القاعدة، ومن ذلك تنشأ ما یصطلح علیها «القراءات المتعددة». اذن التمسك بامور تحت عنوان اصول وقیم دینیة لا تحتمل التغییر یعدُّ ضرباً من التعصب والرؤیة غیر الواقعیة.
وللرد على الحدیث الأخیر نقول: ان اصول الاسلام وكذا احكامه وقوانینه القطعیة والضروریة امور ثابتة ومطلقة، ونظراً لقطعیة البراهین الدالة علیها لیس هنالك مجال لاستنباطات متعددة، واننا لو لم نفترض هذه الطائفة من المسائل الاسلامیة على انها ثابتة ومطلقة لم یبقَ ما نذكره تحت اسم الاسلام.
الدوافع الخفیة فی التنمیة السیاسیة
ما هو دافع البعض فی طرحهم لـ «التنمیة السیاسیة وبعض المفاهیم المشابهة لها» فی هذا الوقت؟
لغرض الكشف عن ماهیة هذه التحركات وكذلك السبل التی تُسلك لبلوغ الاهداف المتوخاة منها، نشیر بایجاز لتاریخ الاحداث التی شهدتها أوربا بعد الثورة الصناعیة:
ان قصة التسلط فی الغرب تبدأ فی الحقیقة من عصر الثورة الصناعیة فی اوربا ـ وان كانت هنالك میول قبل ذلك فی اوربا وكذلك بین سائر الاقوام لغزو البلدان والتسلط على الآخرین ـ عندما حصلوا على الآلات الحدیثة فی ظل التحام العلم والصناعة والتقنیة الحدیثة وافلحوا فی انتاج اكداس البضائع وباسعار زهیدة من حیث كلفة الانتاج واحتكار الثروة والربح الطائل من خلال بیع هذه البضائع باسعار خیالیة.
وبازدیاد الربح وبالتالی رأس المال یزداد الاستثمار لغرض الانتاج، وهذا بحد ذاته یمثل دافعاً لكسب المزید من الربح ورأس المال، وهكذا وبدوران عجلة رأس المال والانتاج یزداد ركام الثروة یوماً بعد یوم.
ولكن فی المقابل والى جانب تزاید الانتاج ـ العرض ـ ظهرت مشكلتان جوهریتان هما:
1 ـ شحة المواد الاولیة للانتاج.
2 ـ تضاؤل معدل الطلب مقارنة بما یُعرض من منتجات.
هذان السببان دفعا الدول الغربیة لتفكیر باستعمار البلدان الاخرى للحصول على الموادّ الخام من جهة وللظفر بأسواق جدیدة لمنتجاتهم من جهة اخرى. وقد استمر هذا التوجه الاستعماری من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر، وفی غضون هذه الفترة تنبّه الغربیون الى مشكلة اخرى وهی انحسار المصادر الطبیعیة والقدرة الشرائیة فی البلدان الخاضعة للاستعمار، فالتقنیة والوسائل الحدیثة المصدّرة تحتاج الى متخصصین لاستخدامها، من هنا فقد قرروا العمل على رفع القدرة الشرائیة ومستوى المعلومات فی هذه البلدان، ولهذا الغرض عمدوا الى امرین هما:
الاول: منح هذه البلدان القروض والمساعدات الاقتصادیة وتأسیس صندوق النقد العالمی.
الثانی: استقطاب ذوی الكفاءات فی هذه البلدان الى الجامعات الاوربیة ومن بینها جامعات انجلترا والمانیا وفرنسا.
وكانت المهمة الثانیة تأتی بدافع تربیة الاخصائیین من ذوی القدرة على استخدام السلع المستوردة من الدول الاستعماریة، مثلما تجری المهمة الاولى بغیة رفع القدرة الشرائیة لدى شعوب البلدان المستعمَرة لیتم من خلاله تصدیر المزید من البضائع الى هذه البلدان ویحافظ سوق الغربیین على ازدهاره.
بید ان هذا المنحى لم یكن یروق للمستعمرین على الدوام اذ ان بعض هؤلاء المثقفین اخذوا ینادون بعد عودتهم لبلدانهم بفكرة الدعوة للاستقلال والمطالبة بالتحرر عن الاستعمار الاجنبی، وهذا بذاته كان منطلقاً لمرحلة جدیدة وعهد جدید بدء منذ اواخر القرن التاسع عشر وبلغ ذروته فی القرن العشرین.
وبالرغم من المواجهات المتعددة الوجوه التی جوبهت بها مثل هذه التحركات الاستقلالیة، توصّل المستعمرون فی نهایة المطاف الى هذه النتیجة وهی ان من الافضل لهم التحلی بقدر من الرؤیة الواقعیة وبطرحهم لفكرة «العلاقة» بدلاً عن «الاستعمار» یتمكنون فی المستقبل من الانتفاع من هذه البلدان ایضاً، ومن بین هذه التحركات الاستعماریة كان مشروع تأسیس منظمة دول الكومنولث « Commonwealth» الذی اقترحته بریطانیا لتبقى المستعمرات التی كانت رازحة لهیمنة الانجلیز فی السابق وحصلت على الاستقلال فیما بعد، على تعاونها ومشاركتها مع بریطانیا تحت هذه الیافطة، ویستمر الاستعمار هذه المرة باسلوب آخر.
على أیة حال؛ لقد اخذت مسیرة المطالبة بالاستقلال بالتصاعد یوماً بعد یوم، وهذا بحد ذاته كان یستدعی اسالیب اكثر حداثة للاستعمار، بحیث ان الاستعمار المكشوف تنازل عن موقعه للاستعمار الخفی، وأحد هذه الاسالیب الجدیدة كان بطریقة ان تتولى الدول الاستعماریة صناعة عناصر واحزاب فی الدول المستقلة ـ أو انها كانت تتدخل فی عملیة صیاغة بعض التنظیمات والاحزاب بصورة لم یكن حتى القائمون على هذه الاحزاب یعرفون بتدخل العناصر الاجنبیة وتوجیهاتها ـ فتقوم بجمع الناس حولها عبر مناداتها بالشعارات المناهضة للاستعمار، وبعد وصول الحزب الذی تأسس وتبلور بشعار مكافحة الاستعمار الى السلطة یمد ید الصداقة لأسیاده الاجانب ویتولى تأمین مصالحهم.
وبمرور الزمن وتنامی التجربة توصل الغربیون الى هذه النتیجة وهی ان استمرار وتجذر الاستعمار واستغلال البلدان الاخرى منوط بمسخ ثقافتها وفكرها بنحو تتغیر معه طبیعة الرؤیة لدى الناس ویروج الفكر القائم على «محوریة الفرد» و«الروح الاستهلاكیة» و«اكتناز الثروة» بشكل یشبه ما هو سائد فی الغرب وامریكا، ویسود تلك البلدان نظام یتبنى استهلاك وسائل الغرب وتقنیته وهو مرعوب ازاء ما یحققونه من تطور.
لو قدِّر لهذین الهدفین أن یتحققا لكان قد ضُمن استمرار الهیمنة، غیر ان أحد موانع تحقق الاهداف الآنفة الذكر فی الشرق هو «الثقافة الشرقیة» القائمة على القناعة والروح الجمعیة، من هنا فقد وضعت سهام الغزو الثقافی بتعقیداتها الخاصة بها على لائحة اعمال الغربیین، وفی هذا الصدد برزت الى الوجود فكرة تلازم الثقافة والتكنولوجیا، فكان الادعاء الجوهری لهذه الفكرة: ان لكل تكنولوجیا ثقافتها الخاصة الملازمة لها، وحیثما حلّت التكنولوجیا حلّت معها ثقافتها شئنا أم ابینا، إذن إما ان نقبل بالتكنولوجیا مقرونة بالثقافة أو ان لا نقبل بأیٍّ منهما، ونظراً الى ان التكنولوجیا قادمة من الغرب فلا مناص من ان تحل ثقافة الغرب ایضاً.
لقد اثبتت هذه الفكرة بطلانها فی الیابان، لان الیابانیین وبالرغم من قبولهم لبعض التأثیرات عن ثقافة الغرب الغازیة، فقد حافظوا وتمسكوا بتقالیدهم واعرافهم وقیمهم الشرقیة وثقافتهم واستطاعوا تحقیق تقدم هائل بحیث اختطفوا قصب السبق من الغربیین انفسهم.
وقبل انتصار الثورة الاسلامیة فی ایران أُثیر موضوع تناقض الاسلام والتنمیة فی اطار سیاسة الغرب ذاتها، وقد زعم الذین حاكوا هذه المؤامرة بان الاسلام دین الزهد والقناعة والتقشف، وان التنمیة شأنها التطور واستخدام المزید من الثروة، وعلیه من المتعذر المواءمة بینهما، وان الاسلام لا یطیق التنمیة، ونظراً لاضطرارنا للتنمیة فلابد من ان نضع جانباً الاسلامَ أو جوانبه التی تتنافى مع التنمیة على أقل تقدیر.
لقد اخذت مثل هذه النغمات تطرق الاسماع هذه الأیام على شكل محاضرة أو مقال أو كتاب... الخ للایحاء بهذه الفكرة وهی تناقض الاسلام مع التنمیة، وان صیاغة مواضیع من قبیل «تعارض الشریعة مع الحداثة» و«ضرورة نقد الشریعة» وما شابهها مما یمكن ادراجها تحت هذا العنوان.
بالرغم من ان البحث التفصیلی فی العلاقة بین الاسلام والتنمیة یستدعی مجالا
أوسع لكننا نؤكد ان الاسلام لیس لا یعارض التنمیة والتطور فحسب بل انه یرید أن یكون المسلم افضل فی یومه مما كان علیه فی أمسه، غایة الأمر انه ینشد هذه التنمیة فی اطار قیمه واحكامه النورانیة التی تكفل منافع الانسان فی الدنیا والآخرة، ولا یرى أی ترابط بین التطور والتنمیة وبین القبول بالثقافة الغربیة.
على سبیل المثال، لقد كان المسلمون إبان عصر همجیة الغرب وبربریته، حملة لواء العلم والصناعة فی العالم، وباذعان الغربیین انفسهم، لولا التراث الذی خلّفه الاسلام فی اسبانیا لبقی الغربیون یعیشون حالة شبه همجیة ولما نالوا نصیبهم من الصناعة والتطور.
والیوم فان انصار فكرة تعارض الاسلام مع التنمیة یحاولون وبشكل مشبوه اشاعة هذه الفكرة فی المجتمع وهی ان «التنمیة الاقتصادیة تقترن بالتنمیة السیاسیة والثقافیة».
ان لنا فهماً خاصاً لهذه المفاهیم اذ اننا نتصور ان المراد منها المضی قُدُماً بهذه المفاهیم الثلاثة باتجاه تحقیق اهداف النظام الاسلامی، غیر ان مراد هذه الحفنة من الخطباء والكتّاب مفهوم خاص لهذه المفردات یؤول الى فرض الثقافة الغربیة على الثقافة الاسلامیة.
ان استهداف العقول بالمنثورات على اختلافها، والكتب والنظریات العلمیة داخل الجامعات من ناحیة؛ وقولبة عقول الطلبة المبعوثین الى الخارج ـ الذین یدرسون فی فروع من قبیل الاقتصاد وعلم الاجتماع والحقوق والعلوم السیاسیة لیرددوا ما یقوله الغربیون بدقة بعد عودتهم الى البلاد ـ من ناحیة اخرى، كل ذلك یعد من اسالیب الهجوم الغربی وجرّ البلاد ثانیة كی ترزح تحت هیمنة المستعمرین.
كما یجری الایحاء بصور مختلفة إما التخلف عن ركب التطور والحضارة أو التخلی عن الحمیّة الدینیة والتحلی بالتساهل والتسامح على صعید القضایا العقائدیة والاقتصادیة والسیاسیة التی ربما تستبطن عقبات دینیة ـ وان كان ذلك من مزاعم
وایحاءات هذا الطیف ـ والحصول على قروض ضخمة من صندوق النقد الدولی والبنك العالمی والحصول على رأس المال الضروری للانتاج من خلال تمهید الارضیة للاستثمارات الخارجیة وتأسیس المناطق التجاریة الحرة، ونظراً لان المحافل الدولیة لیست على استعداد لمنح هذه القروض أو الاستثمار داخل البلاد دون شروط مسبقة، فلابد من غض الطرف عن الروح الثوریة والتمسك ببعض الاصول والقیم لیتسنى لنا بلوغ مرامنا.
وینبغی التحلی بالمداراة والتسامح فی الامور الثقافیة ایضاً، اذ یمكن فی مثل هذه الحالة دخول المجتمع الدولی ورسم صورة دولیة حسنة لنا وإلاّ فان تمسكنا باصولنا ومبادئنا الثابتة من شأنه ان یبتلینا بالعزلة على الصعید الدولی.
اذن لابد من التخلی عن الاصولیة والتزام الاعتدال واللیبرالیة وتجنب الاتجاه الیقینی والتفكیر المطلق الى الحد الذی لا نبدی معه ایّ تحفظ اذا ما شنَّ البعض هجوماً على الامور التی نعدّها من المسلّمات!! بینما یحتل الیقین موقعاً متمیزاً فی الاسلام وان اصحاب الیقین یتبوؤن منزلاً رفیعاً فی آیات القرآن الكریم والروایات، وفی المقابل فان الشك واتجاه التشكیك ـ الذی یمثل الآن احدى قیم العالم الغربی ـ هو أمر مذموم ومحطة بغیضة فی النظرة الاسلامیة وان الثبات على اصول الاسلام ومسلّماته یُعدّ من أسمى قیم الانسان المسلم.
* * * * *
بناءً على هذا، فان مفاهیم من قبیل «التنمیة السیاسیة» التی ربما تكون احدى ادوات الاعداء لاثارة الفرقة والتمهید للقضاء على قیم الاسلام والثورة ومحو ما لدى الجماهیر من حمیّة دینیة وثوریة للعمل بالاضافة الى ضیاع آخرة الناس، فهی تضیّع دنیاهم ایضاً عبر جرف هذا الشعب لیرزح من جدید تحت سلطة الاجانب، من المناسب أن تُوضح بدقة متناهیة من قبل الغیارى وان یقدموها بدافع الوصول لاهداف النظام الاسلامی، والعمل على الحیلولة دون استغلالها وذلك من خلال القیام بالاعمال التخصصیة.
7 ـ اسباب انحراف بعض المثقفین المسلمین
سؤال: ما هی اسباب انحراف بعض المثقفین المسلمین؟
جوابه: للاجابة على هذا السؤال من الاحرى ان نتناول بالبحث اسباب انحراف المسلم ولیس فقط المثقف:
ان ما یسمى الیوم بالانحراف والاعوجاج كان فی عصر صدر الاسلام یحمل عنوان «الفتنة»، فالفتنة أو الانحراف أمرٌ یظهر فی البدایة على صعید الفكر ومن ثم ربما یسری الى مقام العمل ویتجسد على شكل قتل وسفك الدماء وعدوان... الخ.
بناءً على هذا، فالانحراف أو الفتنة فی البعد النظری هو الاساس والمصدر وما یظهر فی العمل یعدّ نتیجة وحصیلة له، ولهذا فان القرآن الكریم یعتبر الانحراف الفكری (الفتنة) من الناحیة القیمیة اشدَّ سوءاً من الممارسات المترتبة علیه «... وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ»(1).
لقد أقدم الناس بعد رحیل النبی الاكرم(صلى الله علیه وآله) ـ بالرغم من انهم كانوا قد تعلّموا منه المعتقدات والرؤیة السلیمة، وكانوا على استعداد إبان عهد النبی(صلى الله علیه وآله) لكافة أشكال التفانی والتضحیة فی سبیل الاسلام والمحافظة على نفس النبی(صلى الله علیه وآله)وشاركوا فی مختلف المعارك تحت قیادته ـ أقدموا على ممارسات وأرسوا فتناً كان لها تأثیرات مضرة ومؤسفة لیس على مصیر المسلمین وحدهم بل على مستقبل البشریة، تأثیرات حرمت المجتمع البشری من بلوغ السعادة لقرون طویلة، وتركت هذا التساؤل وهو: لماذا وقعت مثل هذه الفتن بعد النبی(صلى الله علیه وآله) وتمخضت عن هذه النتائج؟
انه السؤال الذی وجَّهه المسلمون فی صدر الاسلام للامام علی(علیه السلام) فردّ(علیه السلام) قائلاً «إنما بَدءُ وقوع الفتن اهواءٌ تتّبع واحكامٌ تُبتَدع»(2).
1. البقرة: 191.
2. نهج البلاغة، الخطبة 50.
فی هذا الحدیث یحدد امیر المؤمنین(علیه السلام) أمرین كسبب للانحراف (الفتنة) وهما:
1 ـ الهوى(1): وله اقسام یمكن الاشارة الى الولع بالمال والثروة وانواع النزوات من بینها.
من الاهواء التی ربما یمثل منطلقاً لاكثر المذاهب الدینیة هو الرغبة والحب المفرط للشهرة والبروز الى الحد الذی یبذل المرء قصارى جهوده ویكلّف نفسه ضروب المشاكل ویحاول من خلال استهلاك نفقات طائلة لكی یحظى باهتمام ومودة الآخرین.
لقد كان الكثیرون على مرّ التاریخ ممن تجرعوا مشقة السجن وشدائده لسنوات مدیدة وتحملوا التعذیب والنفی عسى ان یعثروا على انصار ینادون بالحیاة لهم من قبیل ما نشاهده لدى بعض اقطاب الصوفیّة، فنظراً لان الغایة الحقیقیة هی الحصول على المحبوبیة والشهرة وهذا ما لا یتیسر الاّ بالكلام الذی یرضی الآخرین ویعجبهم، من هنا فان امثال هؤلاء لا مانع لدیهم من قلب الحقائق وتزییفها بما یحقق لهم اهدافهم الى الحد الذی تشاهد بعض التناقضات فی اقوالهم، ولتبریر هذه التناقضات یزعمون: ان كافة السبل مستقیمة وكل الآراء على حق فیصبحون انصاراً لما یسمى «السلام الشامل».
2 ـ احكام تُبتدع: السبب الثانی لظهور الانحراف والفتنة هو ما یثار تحت یافطة العصرنة «البدعة فی الدین» وهو یتمخض عن السبب الاول، فیصف الامام علی(علیه السلام)هذین العنصرین على انهما منطلق انحراف الانسان، وهو(علیه السلام) فی الحقیقة انما یوجه تحذیره بوجوب ان یُرسى البناء فی تفسیر الدین على التسلیم ولیس على الاهواء والاجتهادات الشخصیة.
وبتعبیر آخر، بمقدور الانسان ان یتعاطى مع الآیات والاحكام الالهیة وفق
1. بشكل عام ان تلك المجموعة من النوازع والرغبات الانسانیة التی تؤدی الى اضعاف الایمان أو سلبه أو عدم ظهوره أو تحول دون اكتساب الفضائل والقیم الاخلاقیة تسمى «الاهواء».
نمطین: اولهما ان یذعن لما ورد فی الآیات والروایات لبیان الاحكام الالهیة ویعمل بها دون نقاش، وان یتبع المنهج الصحیح للاستنباط والاجتهاد فی فهم مصادر معرفة الدین وهی الآیات والروایات، وثانیهما ان یقبل ببعض الامور ویؤمن بها سلفاً ثم یتجه لتفسیر وتأویل الآیات والاحكام بتلك الافتراضات وعلى العكس من الاسلوب الاول یبادر لتأویل الآیات والروایات بما ینسجم مع فهمه وهواه وبدلاً من ان یتبع هو الدین والشریعة یكون الدین تابعاً له ویُفسَّر بما یتلاءم ورغبته، وحیثما لم تنسجم احكام الدین مع رغبته طرحها بما یرتضیه هو أو الآخرون.
هذه فی الحقیقة هی البدعة فی الدین التی انما تتبلور لتحقیق المصالح والحصول على المحبوبیة واهتمام الآخرین وصیاغة صنمیة الذات لدیهم، وتُقدَّم فی اطار بیان جمیل وكلمات بلیغة براقة على انها «قراءة جدیدة» للدین.
على أیة حال ان العنصرین الذین تقدّم ذكرهما فی كلام امیر المؤمنین(علیه السلام) هما اصل انحراف «فتنة» كل مسلم وبالذات المثقفین، ولابد من التحرز عنهما اشد الاحتراز.
* * * * *
8 ـ ضرورة ترسیخ المعنویات
سؤال: ما هی اسباب انحسار المعنویات فی اوساط الشباب؟ وما هو المنهج الصحیح فی تبلیغ الدین وصیانة الشباب ازاء شبهات المعاندین؟
جوابه: السبب فی طرح هذا السؤال أن نزوع الشباب نحو المعنویات والقیم الدینیة بلغ فی غضون السنوات التی اعقبت انتصار الثورة الاسلامیة وابان فترة الدفاع المقدس، حداً بحیث انهم كانوا یذودون عنها حتى الشهادة والتضحیة، أما الآن وبعد مضی عدة سنوات فقد اخذ هذا النزوع بالخفوت ومن النادر العثور على ما سلف من معنویات.
فی البدایة نسوق مقدمة ومن ثم نتطرق للجواب الاساسی:
ان الانسان مخلوق یقع فی باطنه تحت تأثیر العواطف والاحاسیس، ویتأثر من الخارج بمؤثرات عدیدة؛ وهذه المؤثرات الخارجیة هی التی توجه عواطف الانسان واحاسیسه، وكلما كانت اكثر شدة ستكون اكثر قدرة على تحریك العواطف وعلى التوجیه ایضاً، ومن ناحیة اخرى ان الحالات النفسیة للانسان لا تتمیز بثبات وضعها على الدوام وفی كل زمن بل هی عرضة للتقلبات بتغیر الظروف، وقد قیل فی علم الاجتماع: ربما تبلغ ظاهرة اجتماعیة ذروتها فی ظل ظروف بیئیة معینة، بید ان هذه الظاهرة ستضمحل مع ضعف اسباب اضطرادها.
الآن وفی ضوء المقدمة الآنفة الذكر، ندرج بعض الظروف الاجتماعیة التی كانت سائدة خلال الفترة التی سبقت انتصار الثورة الاسلامیة وما بعدها وكذلك خلال مرحلة الدفاع المقدس:
1 ـ حاكمیة عملاء الغرب واستحواذهم على مقدرات البلاد.
2 ـ الاضطهاد وانعدام الحریة.
3 ـ تفشی التحلل.
4 ـ الاستعمار الثقافی وضیاع الهویة الوطنیة والدینیة.
5 ـ التبعیة الاقتصادیة.
6 ـ مواجهة النظام البائد للقیم الالهیة والدینیة ـ بوصفها اهم سبب فی انبثاق النهضة الاسلامیة للشعب الایرانی ـ.
7 ـ اغتیال الشخصیات الدینیة البارزة والهجوم الشامل الذی شنّه الاستكبار على البلاد واستشهاد الشباب الاعزاء.
ان هذه الاسباب الى جانب نهضة التنویر التی تمیز بها الامام الخمینی(رحمه الله) قائد الثورة الاسلامیة العظیم، هی التی دفعت الشعب لأن یتلمَّس خلاصه وسعادته حقاً فی الالتجاء للدین والمعنویات والاقبال نحو الاخلاق الاسلامیة والسلوك الدینی یعززهم رافد فكری عملاق.
لقد بلغت هذه الروحیة ذروتها إبان مرحلة الدفاع المقدس وادى استشهاد الشبیبة وأسرهم وتعویقهم فی سبیل الدین والوطن الى مضاعفة رغبة وتعلق الجمیع لاسیما الشباب بالعرفان والمعنویات، بحیث تحولت فترة انتصار الثورة الاسلامیة ومرحلة الدفاع المقدس الى مقطع ذهبی من الاقبال نحو المعنویات والتقوى.
والسؤال الآن هو: لماذا خفتت هذه الحالة وانحسر التوجه نحو المعنویات؟
لو اردنا الحدیث عن الاسباب الرئیسة المؤثرة فی مثل هذه المعادلة، فبوسعنا الاشارة الى الامور التالیة:
1 ـ تغیر الاوضاع السائدة فی المجتمع.
2 ـ انعدام الصورة الواضحة عن فترة انتصار الثورة ومرحلة الدفاع المقدس والاوضاع السائدة فی المجتمع وقتذاك لدى جیل الشباب المعاصر.
3 ـ وجود المشاكل المعاشیة والدراسیة.
4 ـ مشكلة البطالة والزواج.
5 ـ تغیر سیاسة الاستكبار فی مواجهته للنظام الاسلامی من الهجوم العسكری الى الغزو الثقافی واتخاذ هذا الغزو صوراً شتى منها إثارة الشبهات على صعید القضایا العقائدیة والبعد النظری للنظام الاسلامی، وذلك ما یأتی بعد الاخذ بنظر الاعتبار فقدان الشباب للرصید الفكری الدینی واستغلال عواطفهم واحاسیسهم.
هذه العناصر باجمعها ـ وفی ضوء ما ورد آنفاً من ملاحظة فی علم النفس حول تقلب حالات الانسان ـ تتظافر معاً فتسوق رغبات الشباب وعواطفهم ومیولهم نحو المادیات وتصدهم عن المعنویات.
ولكن الهاجس الرئیس هو ما الذی یتعین فعله كی یحصِّن الشباب انفسهم حیال الاخطار التی تهددهم فی عقائدهم وقیمهم الدینیة؟
یبدو ان انجع السبل هو ان یستثمر القائمون على الشؤون الثقافیة فی البلاد الجانب العاطفی خلال مرحلة الشباب غایة الاستثمار ویجعلوه قاعدة لترصین الطاقات الفكریة والعقلیة للشباب ویعمّقوا فیهم المعرفة، فاذا لم یعزّز فكر الشباب وعقله بالادلة القویة یُخشى علیه ان یقع ضحیة التآمر الثقافی للاعداء.
بناءً على هذا یتعین العمل من خلال تصنیف الكتب والمطبوعات الفكریة والثقافیة من ناحیة، ورسم الخطط وعقد الجلسات المنتظمة والتواصل المباشر ـ بحیث یتسنى للشباب طرح اسئلتهم والحصول على الجواب الشافی بیسر ـ لأن تتوفر الظروف الكفیلة برقی ما لدى الشباب من رؤى وافكار وتتحصن فی مواجهة هجمات الاعداء.
وفی الختام ننقل لشبابنا الاعزاء ما یوصی به القرآن الكریم حیث یقول: «وَإِذا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّى یَخُوضُوا فِی حَدِیث غَیْرِهِ»(1).
ان بلاغ هذه الآیة هو: یتعین على المسلمین تجنب الدخول فی بعض الحوارات ماداموا لم یكتسبوا القدر الكافی من المعرفة الدینیة، حیث لا یكونون قادرین على
1. الانعام: 68.
التمییز والنقد وتحلیل قول الحق من قول الباطل، لان الاستماع أو مطالعة بعض الامور التخصصیة التی یحاول الاعداء ومثیروا الشبهات تضلیل الناس عبر التشكیك فیها، مما یترك أثره فی القلب فیُزلَّ الانسان عن جادة الحق.
ان هذا القول لیس معناه بان لا یحق لأحد الاستماع لحدیث المناوئین، بل المراد منه ان یحترز عنه مَنْ لم یحرزوا القدر الكافی من المعرفة بحیث یتمكّنون من النقد وتحلیل الامور التخصصیة. وبطبیعة الحال فان مثل هذه الدراسات والدخول فی الحوارات سیكون مناسباً فی حالة توفر الشروط الضروریة، بل یجب على الذین یمتلكون القدرة على النقد الاستدلالی للرؤى غیر الاسلامیة وبیان المعارف الدینیة، ان ینهضوا للحیلولة دون تفشی الشبهات وتأثیراتها فی المجتمع.
* * * * *
9 ـ الرقابة الاستصوابیة
سؤال: ماذا تعنی الرقابة الاستصوابیة؟ وما هو موقعها العقلائی والقانونی؟
جوابه: بشكل عام تجری الرقابة على كیفیة وحسن اداء المؤسسات القانونیة والسیاسیة فی أی بلد على نحوین: الأول استطلاعی، والثانی استصوابی.
الرقابة الاستطلاعیة: وتُطلق على الرقابة التی یكون المشرف فیها مكلفاً باستطلاع ما ینجزه المنفذون، ومن ثم یقدّم كشفاً عمّا شاهده الى جهة اخرى دون ان یتخذ بنفسه أیة خطوة عملیة أو یقوم بتأیید طبیعة الاجراء أو رفضها.
ان هذا النمط من الرقابة ذو طابع معلوماتی بحت وهو فی الحقیقة حقٌ لكافة ابناء المجتمع ایضاً، والاّ فلا فرق فی ذلك من حیث عدم قدرة المشرفین على اتخاذ ای اجراء بحق المخالفات المتوقعة، مع رقابة سائر المواطنین.
الرقابة الاستصوابیة: والاستصواب تشترك مع مفردة صواب فی المصدر والاصل، والصواب تعنی الصحیح فی مقابل الخطأ، والاستصواب تعنی عدّه واعتباره صائباً من قبیل القول: هذا العمل صحیح ولا اشكال فیه.
وتطلق الرقابة الاستصوابیة اصطلاحاً على الرقابة التی یكون المشرف فیها حاضراً فی كافة موارد اتخاذ القرار وعلیه المصادقة على الاجراءات المتخذة للحیلولة دون وقوع أی خطأ أو سوء استغلال من قبل المنفذین.
أ ـ الموقع العقلائی والقانونی للرقابة الاستصوابیة
هنالك مجموعة من الشروط الخاصة توضع فی كافة دول العالم ومن قبل عقلاء الدنیا قاطبة للتصدی للمسؤولیات المهمة لكی تؤدى الواجبات المناطة بالمرء على احسن وجه، ولا تُهدر حقوق ومصالح المواطنین نتیجة لعدم كفاءة المسؤول المعیَّن
وفقدانه الاهلیة.
من هنا فان ثمة شروطاً معینة توضع حالیاً فی اكثر الانظمة الدیمقراطیة فی العالم تشمل الناخبین والمرشحین فی الممارسات الانتخابیة، ویحدد القانون مرجعاً رسمیاً لممارسة الرقابة وتشخیص شروط المرشحین للانتخابات، ویتولى هذا المرجع الرسمی دراسة ظروف ومسیرة الانتخابات وتوفُّر أو عدم توفر الشروط الضروریة فی المرشحین ـ وذاك ما ینتهی بالتالی الى المصادقة أو رفض اهلیة المرشحینـ .
بناءً على هذا، فان الرقابة الاستصوابیة أمر شائع وعقلائی وقانونی فی كافة البلدان والانظمة القائمة فی العالم، فمن الشروط المعتبرة ـ مثلاً ـ فی جمیع الانظمة الحقوقیة فی العالم ان لا یكون المرشح ذا سابقة جزائیة، ویُحرم ذوو السوابق الجزائیة السیئة من بعض الحقوق الاجتماعیة من بینها الترشیح لمجالس اتخاذ القرار ولجان الانصاف والمجالس البلدیة وغیرها.
ولكن هل یعنی وضع مثل هذه الشروط سلب المواطنین حقهم فی الترشیح؟
ینبغی القول: اذا ما اقررنا بان من لوازم الممارسة الصحیحة للحكم وجود اناس قدیرین للتقنین واتخاذ القرار خلال الازمات الاجتماعیة والسیاسیة، من الطبیعی اننا سنعتبر وجود مجموعة من المواصفات والقابلیات والاحاطة بمقتضیات المجتمع ومصالح الشعب لدى المرشحین أمراً ضروریاً ولازماً، ونظیر ذلك ان الترخیص بالتطبیب وافتتاح عیادة انما یُعطى فقط لأناس معینین یتمتعون بمعلومات والتزام كاف فی أمر الطب، وهذا لا یعنی أبداً سلب الناس حقهم فی افتتاح عیادة، بل یعنی على وجه الدقة المحافظة على حقوق ومصالح سائر المواطنین.
اذا ما كانت مثل هذه الشروط ـ وهی ربما تختلف باختلاف الانظمة وفقاً لطبیعة الرؤیة والایدیولوجیا التی تحكم النظام والدستور فیها ـ ضروریة بالنسبة للمتقدمین بالترشیح، فلابد من وجود مرجع یحرز توفر هذه الشروط لدى المرشحین ایضاً،
ففی حالة فقدان هذه الشروط باجمعها أو بعضها لدى أحد المرشحین فان هذا المرجع أو المؤسسة القانونیة التی یرفع هذا المرجع الكشوفات لها یتولى رفض اهلیة المرشحین الفاقدین لهذه الشروط.
وفی بلدنا ایضاً ـ شأنه كسائر دول العالم ـ حدد القانون مرجعاً یتولى الاشراف على موضوع الانتخابات ومؤهلات المرشحین للانتخابات، وقد أُلقیت هذه المهمة واستناداً للمادة التاسعة والتسعین من الدستور على عاتق مجلس صیانة الدستور(1).
فی البدایة تحرز وزارة الداخلیة ـ بوصفها المنفذة للانتخابات ـ اهلیة المرشحین، ثم یقوم مجلس صیانة الدستور ـ بموجب الدستور ـ بالاشراف على ما اذا كانت المصادقة على اهلیة المرشحین أو رفضها حقاً أم لا، وهذه الرقابة المناطة بمجلس صیانة الدستور بموجب المادة التاسعة والتسعین من الدستور مطلقة وتشمل الاشراف على التصویت ومسیرة الانتخابات وكذلك اهلیة المرشحین، وان تقییدها بمجرد الاشراف على التصویت یفتقر للدلیل ویعدُّ تجاوزاً للمادة المذكورة من الدستور (99).
ولكن ما السبب فی ان رقابة مجلس صیانة الدستور استصوابیة ولیست استطلاعیة؟ استناداً للمبدأ العقلائی الذی یرى احراز صحة الانتخابات وتأیید او رفض اهلیة المرشحین للانتخابات مهمة تنهض بها جهة رسمیة وقانونیة، وكذلك ضرورة وجود جهة قانونیة لضبط اعمال المنفذین ـ وزارة الداخلیة ـ لعلاج الاخطاء أو حالات سوء الاستغلال المحتملة من قبل القائمین على الانتخابات، فقد عیَّن الدستور مؤسسة رقابیة كجهة رسمیة تشرف على الانتخابات وعملیة تشخیص مؤهلات المرشحین وعمل القائمین على الانتخابات، وهذه المؤسسة المشرفة هی
1. المادة التاسعة والتسعون من الدستور: یتولى مجلس صیانة الدستور الاشراف على انتخابات مجلس الخبراء ورئیس الجمهوریة واعضاء مجلس الشورى الاسلامی وعلى الاستفتاء العام.
مجلس صیانة الدستور، ولم ینص الدستور على مؤسسة أو شخص آخر كمشرف أو مؤسسة یرفع الیها مجلس صیانة الدستور كشوفاته. اذن المشرف الرسمی والقانونی الوحید هو مجلس صیانة الدستور، وحیث ان الرقابة العقلائیة على التصویت وتشخیص اهلیة المرشحین تستدعی تأییداً أو رفضاً ونقضاً عملیاً ومؤثراً وهذه المزایا انما تتحقق فی اطار الرقابة الاستصوابیة فقط من هنا فان رقابة مجلس صیانة الدستور تكون رقابة استصوابیة.
من ناحیة اخرى، ان الدستور فی مادته الثامنة والتسعین خوّل مجلس صیانة الدستور مهمة تفسیر الدستور(1)، وقد فسَّر هذا المجلس كراراً «الرقابة» الواردة فی المادة التاسعة والتسعین من الدستور بـ «الرقابة الاستصوابیة».
وتجری هذه الرقابة ـ بطبیعة الحال ـ فی اطار القانون وبموجب الشروط التی حددها القانون للمرشحین أو طریقة اجراء الانتخابات، ومجلس صیانة الدستور انما یتولى ـ فی الحقیقة ـ التحقیق حول توفر الشروط المنصوص علیها فی القانون لدى المرشحین وفی عمل القائمین على الانتخابات، وفی ضوء واجبه لن یصادق على اهلیة المرشحین أو صحة الانتخابات إن لمْ یرَ توفر هذه الشروط.
ب ـ دوافع الاعتراض على الرقابة الاستصوابیة
ما هو الدافع وراء الاعتراض على الرقابة الاستصوابیة؟
فی ضوء الموقع العقلائی والقانونی للرقابة الاستصوابیة المقبولة والثابتة فی كافة الدول والانظمة العالمیة، یتبادر هذا السؤال وهو: لماذا ینبری البعض فی خطاباتهم وكتاباتهم لمعارضة هذه الرقابة ویسعون لالغائها؟
ینبغی القول فی معرض الاجابة: الحقیقة هی لیس ثمة تیار أو تنظیم سیاسی فی البلاد یرفض الرقابة، والسابقة العملیة لبعض الذین یعارضون الرقابة الاستصوابیة
1. المادة الثامنة والتسعون من الدستور: تفسیر الدستور من اختصاص مجلس صیانة الدستور ویتم بمصادقة ثلاثة ارباع الاعضاء.
فی الوقت الراهن تؤكد انهم كانوا قد مارسوا هذه الرقابة ودافعوا عنها بحماس اثناء تصدیهم للامور، لكنهم الآن وبدافع سیاسی ـ ولیس بدافع دینی ووطنی ـ ومن اجل تحقیق مصالحهم الفئویة والحزبیة اخذوا یلجون باب المعارضة للرقابة الاستصوابیة لیتسنى لهم زج من لا تتوفر فیهم الاهلیة فی مراكز اتخاذ القرار الحساسة فی النظام،وعن هذا الطریق یحققون مآربهم الحزبیة واغراضهم السیاسیة.
انهم یحاولون ـ مثلاً ـ اثناء انتخابات مجلس الخبراء إقحام من لیسوا بمجتهدین ـ ای الذین یفتقدون الاهلیة من الناحیة القانونیة ـ فی مجلس الخبراء لیبلغوا اهدافهم عن هذا الطریق، ونظراً لمعارضة مجلس صیانة الدستور ـ بموجب القانون ـ لرغبتهم غیر العقلانیة(1) والمنافیة للقانون، فهم یحاولون الغاء الرقابة الاستصوابیة ویدعون:
ان لمجلس صیانة الدستور حق الاشراف على مجرى الانتخابات فقط، وعلیه ان یكون مخبراً عن مجریات الاحداث دون أن یمارس أی اجراء عملی ازاء المخالفات والممارسات المنافیة للقانون.
ولكن الى مَنْ یرفع تقاریره یا ترى؟ وهل نصَّ القانون على جهة اخرى یقدم لها مجلس صیانة الدستور كشوفاته أم لا؟ هذه اسئلة لا یردّون علیها أبداً.
وتأتی هذه المعارضة احیاناً من قبل المناوئین لحاكمیة الاسلام واحكامه التی تُحیی الانسان فی هذا البلد، وهم یسعون وتحت یافطة الدفاع عن «جمهوریة» النظام الى إضعاف اسلامیته وعزلها، وبالغائهم للشروط المنصوص علیها بالنسبة للمرشحین للانتخابات والمترتبة على المیزة الاسلامیة للنظام، یحققون عملیاً مآربهم المنافیة للدین والمعادیة للشعب.
1. ان هذه الرغبة لیست عقلانیة لان اعضاء مجلس الخبراء یتولون اختیار القائد والشهادة له بانه «فقیه ومجتهد» ونظراً لان تشخیص القدرة على الاجتهاد والفقاهة ـ وهی أمر تخصصی تماماً ـ لدى شخص ما یحتاج الى احاطة كافیة بموضوع الفقاهة والاجتهاد، وهذا مما لا یتیسر الاّ عند من یتوفرون على نصیب من الاجتهاد، لذلك فان الاعتراض على شرط الاجتهاد فی اعضاء مجلس الخبراء یعد أمراً لیس عقلانیاً.
وهنا نورد ثلاث شبهات من بین الشبهات التی أثارها المناوؤن للرقابة الاستصوابیة، ونردّ علیها لیتبین اكثر فقدان الادلة التی تتشبث بها هذه الفئة لأی اساس:
ج ـ شبهات حول الرقابة الاستصوابیة
الشبهة الاولى والرد علیها
ربما یقال: ان القاعدة الأولیة هی براءة الناس وهم صلحاء ما لم یثبت العكس. اذن لا داعی للتحری عن اوضاع الآخرین لاثبات اهلیتهم وهو خلاف للقاعدة الاولیة.
وفی معرض الاجابة لنرَ أولاً أین یكمن موقع أصل البراءة لیتضح من خلال ذلك ما اذا كان هذا المورد من موارد تطبیقات أصل البراءة أم لا.
یقول اصل البراءة: اذا ما اراد أحدٌ نسبة فاحشة لآخر لیعاقبه فعلیه اثباتها، والاّ لا یتحقق ای اتهام استناداً لهذا الأصل ما لم یقم الدلیل، وبالطبع اذا اقیم الدلیل سقط اصل البراءة اذ ان «الاصل دلیل حیث لا دلیل» كما یقال.
بید انه فی المجال الذی یشترط فیه توفر مجموعة من المزایا والقابلیات كشرط للانتخابات لا یمكن افتراض وجودها والكف عن التحری لاحرازها، وبتعبیر آخر: ان أصل البراءة یثبت عدم وجود التهمة ولیس الكفاءة والقابلیة، فهل یصح ـ مثلاً ـ اعتبار كافة ابناء المجتمع مجتهدین على اساس اصل البراءة؟ وهل یمكن الحكم على اساس اصل البراءة لاثبات المهارات والقابلیات المهنیة؟ وهل تمنح الشرطة تراخیص السیاقة لطالبیها على اساس أصل البراءة؟
اذا ما وُضعت شروط عقلیة وقانونیة لتولی المسؤولیة فی ابسط الامور وحتى اكثرها تعقیداً، فسیكون احراز تلك الشروط حتمیاً ایضاً.
الشبهة الثانیة والرد علیها
قد یصوَّر احیاناً ان اشتراط «الالتزام بالاسلام وولایة الفقیه» للترشیح للانتخابات
نوع من تفتیش العقائد، وتفتیش العقائد لیس مسموحاً به أبداً.
ینبغی القول فی الاجابة: ان تفتیش العقائد هو ان نؤاخذ شخصاً دون ما یستوجب ذلك وانما بسبب التزامه بعقیدة ما فقط، ولكن اذا كان التصدی لمنصب أو مسؤولیة منوطاً بشرط معین فان التحقیق والتحری بشأنه لیس تفتیشاً للعقائد مطلقاً.
من هنا یجب التحقیق بشأن المرشحین للعضویة فی مجلس الشورى الاسلامی ما اذا كانوا یتوفرون على شروط العضویة أم لا، انهم یؤمنون بالدستور لیتحركوا فی اطاره خلال فترة عضویتهم أم لا؟ هل یلتزمون عملیاً بالاسلام كی یعكفوا على سنّ القوانین فی اطار موازینه أم لا؟
بناءً على هذا، على مَنْ یصبح نائباً ان یكون ملتزماً بالدستور وأصله المؤكد ای ولایة الفقیه، وملتزماً عملیاً بالاسلام ـ ماعدا الاقلیات الدینیة ـ وهذا لیس تفتیشاً للعقائد بالمرة، فاذا ما عُدَّ وضع شروط للانتخاب وتأیید الأهلیة تفتیشاً للعقائد فلابد من تخطئة الدستور نفسه فی الكثیر من الموارد، اذ ورد فی الدستور: ینتخب رئیس الجمهوریة من بین الرجال المتدینین السیاسیین...، واذا ما اردنا التحقیق عمّا اذا كانت لهذا الرجل القدرة على تقبّل هذا المنصب المهم من الناحیة الدینیة والسیاسیة أم لا، یُفترض ان نُتّهم بتفتیش العقائد بینما الامر لیس كذلك.
ینبغی ـ بالطبع ـ الانتباه ان من رشَّح نفسه لمسؤولیة أو منصب یتعین التحقیق والتحری بشأنه فی ذلك المرفق ذی الصلة وحول الشروط الواجب توفرها للتصدی لذلك المنصب، ولكن لا ینبغی التدخل فی الجانب السرّی من حیاته مما لا علاقة له بالامر.
الشبهة الثالثة والرد علیها
یقال احیاناً: من الافضل ان نترك الخیار للشعب نفسه مباشرة والمبادرة للتحقیق
بانفسهم ویختارون المرشح الذی یرغبون به بمزید من الحریة متجاوزین بذلك الجهة الرسمیة لاحراز اهلیة الافراد.
الرد
الرد على هذه الشبهة التی تداف احیاناً بمذاق یستهوی الناس ویرضیهم، هو كما یلی:
أولاً: ان قیام الناس بانفسهم بالتحقیق والتحری بین العدد الهائل من المرشحین واحراز توفر الشروط لدیهم یقتضی استهلاك المزید من الوقت والجهود وهذا متعذرٌ أو مستعص على اقل تقدیر بابتلاء الناس بالمشاكل والاعمال، فمن اجل احراز عدم وجود سابقة جزائیة لدى المرشح ـ مثلاً ـ هنالك حاجة لكثیر من المراجعات ووجود جهاز فعال للغایة یلبّی الحاجة، ونظراً لكثافة عدد المراجعین ستمتد عملیة احراز هذا الشرط لوحده شهوراً، واذا ما تقرر احراز هذا الشرط وبعض الشروط الاخرى والاعلان عنها من قبل المؤسسة التی تولّت تسجیل اسماء المرشحین لیصوِّت الشعب لصالح الحائزین لهذه الشروط دون ان یتحملوا العناء، فی مثل هذه الحالة ستكون ذاتها الرقابة الاستصوابیة لمؤسسة رسمیة التی كان مثیروا الشبهات ینوون التنصل عنها.
ثانیاً: لقد اثبتت التجربة جیداً ان الذین یمتلكون الاموال والامكانیات ویتمتعون بالكثیر من الاسالیب الدعائیة وافضلها كانوا الاكثر نجاحاً فی مثل هذه الحالات واستطاعوا من خلال دعایاتهم البراقة اخراج الأمر عن مسیره وشق طریقهم ـ أو من یؤیدون من المرشحین ـ الى المجالس ومراكز اتخاذ القرار أو المناصب التنفیذیة ـ بالرغم من عدم توفرهم على المؤهلات التی تؤهلهم للتصدی للامور.
ثالثاً: یجب ان تُقرن حریة الشعب فی الانتخابات مع المحافظة على حقوقهم، أی ان ابناء الشعب یتمتعون بحریة اكثر متى ما وجدوا راحة اكثر لضمان حقوقهم،
وستتدانى الحریة التی یتمتعون بها متى ما تصاعدت وتیرة الشك والغموض والقلق لدیهم، ومن الواضح جداً ان الخیار فیما بین مجموعة تضم عشرة انفار یطمئن الانسان على صلاحهم جمیعاً وبالتالی على ضمان حقوقه بانتخابه لایٍّ منهم اكثر سهولة وافضل بكثیر من التخیّر بین مجموعة تضم الفَ شخص لیس هنالك معرفة أو ضمان بشأنهم.
بناءً على هذا، ان وجود هذا المصفى ـ الرقابة الاستصوابیة ـ یمثل فی الحقیقة عوناً وظهیراً للشعب من اجل انتخاب الافضل بكل حریة وبعیداً عن الشكوك والقلق.
د ـ اختلاف نظامنا عن سائر الانظمة ـ فی مجال الرقابة
بعد ان اتضح نصُّ القوانین فی كافة الدول والانظمة على مجموعة من الشروط للمرشحین لتبوء المناصب الحساسة، من المناسب هنا أن نسأل: هل یختلف نظامنا الاسلامی عن سائر الانظمة فی هذا المجال؟
حریٌ القول فی الاجابة: ان كل نظام یفرض الشروط تبعاً لطبیعة رؤیته وایدیولوجیته وكذلك دستوره، ففی بلادنا حیث النظام الاسلامی هو الحاكم، واستناداً الى المادة الرابعة من الدستور یتعین ان تشرَّع القوانین فی البلاد ـ سواءً الدستور أو سائر القوانین ـ على اساس موازین الشریعة الاسلامیة المقدسة(1)، ومن ناحیة اخرى یتعین ان یجری سنّ القوانین من قبل مجلس الشورى الاسلامی فی اطار الدستور، من هنا فان المرشحین للعضویة فی مجلس الشورى الاسلامی مكلفون بسنّ القوانین فی اطار الموازین الاسلامیة والدستور.
1. المادة الرابعة من الدستور: یجب ان تكون الموازین الاسلامیة اساس جمیع القوانین والقرارات المدنیة والجزائیة والمالیة والاقتصادیة والاداریة والثقافیة والعسكریة والسیاسیة وغیرها، هذه المادة نافذة على جمیع مواد الدستور والقوانین والقرارات الاخرى اطلاقاً وعموماً، ویتولى الفقهاء فی مجلس صیانه الدستور تشخیص ذلك.
وبطبیعة الحال، فان الذین یناوؤن اصل النظام القائم على الموازین والاحكام الاسلامیة أو لا یعترفون بالدستور أو احد اجلى مبادئه واكثرها تأكیداً وهو «ولایة الفقیه»(1) لا یمكن ان یقع علیهم الاختیار كمسؤولین یتعین علیهم التحرك وسنّ القانون وتطبیقه فی اطار الموازین الدینیة والدستور وولایة الفقیه، وهذا أمر عقلانی وواضح تماماً. من هنا ورد النص فی الدستور على الالتزام العملی بالاسلام والدستور على انه من الشروط الواجب توفرها فی المرشحین للعضویة فی مجلس الشورى الاسلامی، وان ارتكاب الامور التی تتنافى مع الاحكام النورانیة فی الاسلام من قبیل الامور التی تتنافى مع العفة والاخلاق ـ التی لا تعد جُرماً فی الانظمة الالحادیة والعلمانیة ـ تعد جُرماً فی النظام الاسلامی وتؤدی الى حرمان المرشح من بعض الحقوق الاجتماعیة.
* * * * *
1. المادة الخامسة من الدستور: فی زمن غیبة الامام المهدی (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولایة الامر وامامة الامة فی جمهوریة ایران الاسلامیة بید الفقیه العادل، المتقی، البصیر بامور العصر، الشجاع القادر على الادارة والتدبیر وذلك وفقاً للمادة (107).
10 ـ سبب سكوت القائد والمراجع ازاء بعض الانحرافات
سؤال: ألا یعد سكوت القائد وبعض مراجع التقلید ازاء بعض الانحرافات التی تبدر من بعض المسؤولین بین الفینة والاخرى، من مصادیق التساهل والتسامح؟
جوابه: للاجابة على هذا السؤال وامثاله من الاسئلة، لا مناص لنا من ایراد مقدمة موجزة:
بالرغم من ان الدین الذی ینشد الحق والعدالة یحظى بالقبول من لدن جمیع الناس الباحثین عن الحق والعدالة على الصعید الفكری والنظری، بید ان مثل هذا الاجماع والقبول من قبل هؤلاء باجمعهم لا یُشاهد على الصعید العملی. ان مساوقة السلوك والفعل مع كافة ما یریده الدین بواجباته ومحرماته أو الاذعان لما یقتضیه الحق والعدل لا یقترن على الدوام بالقبول العملی فی الموارد التی تنتهی بضرر الناس، وان الكثیر من البشر ینشدون العدالة مادامت لا تسبب لهم المنغصات.
من جهة اخرى ان المصالح والقیم فی الاسلام لیست باجمعها على درجة واحدة من الاهمیة والشأن بل هنالك افضلیة فی المرتبة والاولویة لبعضها على البعض الآخر.
واخیراً، فان الناس وفی ضوء مواقعهم الاجتماعیة الخاصة بهم لیسوا سواء فی تكالیفهم وواجباتهم، وان الاشخاص بالاضافة الى كونهم مكلفین بتحمل المسؤولیات بالتصدی للانحرافات سیتحملون مسؤولیات جساماً اخرى ایضاً بما یتناسب مع منزلتهم الاجتماعیة، من هنا یأتی وضع شروط خاصة لتطبیق فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر، وان كل شخص مكلّف بالدفاع عن القیم الاسلامیة بما یتلاءم مع موقعه الخاص به.
بناءً على هذا، ان ما یحظى باقصى مراتب الاهمیة بالنسبة للجمیع لاسیما القادة
الدینیین هو الحفاظ على اساس وكیان الاسلام، وان القائد ومراجع التقلید بما انهم قادة ومراجع لن یسكتوا وسیدقون نواقیس الخطر متى ما شعروا بان خطراً یهدد اصل الاسلام واحكامه النورانیة.
ان القائد اذ یتولى رسم السیاسات العامة للحكومة یقوم بعد تفصیل هذه السیاسات بتكلیف المسؤولین بتطبیقها ویُشرف على حُسن ادائهم، والمسؤولون ـ بوصفهم السواعد التنفیذیة للحكومة ـ ملزمون بدورهم بتطبیق أوامر القائد وتعالیمه.
ومع هذا، فان المشكلة التی تعترض القادة الدینیین على الدوام هی طریقة التعامل مع الذین یعانون ضعفاً فی فكرهم الدینی ولا تتفق سیرتهم مع الرؤیة الاسلامیة، ولكن بما ان اهم شیء بالنسبة للقائد هو المحافظة على اساس الاسلام والنظام الاسلامی فلا مناص له من ان یكتفی بالتنبیه والنصیحة ازاء بعض الانحرافات، لان الموقف الصریح ربما یؤدی الى إضعاف اساس النظام اكثر مما یؤثر فی تعزیزه. وهنا تُقدّم المصلحة الاهم وهی الحفاظ على اساس الاسلام والنظام على سائر المصالح التی تدفع القادة الدینیین لاختیار السكوت احیاناً للمحافظة علیها.
وهذا النمط من السكوت لا یعنی ـ طبعاً ـ التساهل والتسامح بای حال، وانما ینبئ عن تجرع الغصص والحفاظ على اساس النظام والاسلام، وبالامكان مشاهدة الصورة القاسیة لموقف القادة الدینیین حیال انحرافات مسؤولی الحكم، فی هذا الكلام لأمیر المؤمنین(علیه السلام) حیث قال:
«فصبرتُ وفی العین قذى وفی الحلق شجى»(1).
اجل، فالقادة الالهیون یتحرقون ویذوبون كالشمع لئلا یبتعد ارباب الحكم أو ابناء الأمة عن صراط الهدایة والكمال المستقیم.
1. نهج البلاغة: الخطبة الشقشقیة.
ولكن على ابناء الشعب التحلی بالیقظة، وبالاضافة الى التحلی بالبصیرة بالدین ومعرفة الظروف والاوضاع الاجتماعیة والاشراف على عمل المسؤولین، لابدّ ان یكونوا على اُهبة الاستعداد للاستماع وتلقی توجیهات القائد لیمیزوا الحق عن الباطل ویعملوا بتكلیفهم الشرعی والثوری فی الوقت المناسب.
* * * * *