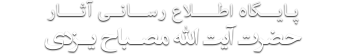ar_assale-ch04.htm
«الجزء الرابع»
«الحریة والتعددیة»
المقدمة
الحریة أحد التطلعات المقدسة والسامیة بالنسبة للافراد والمجتمعات الانسانیة على امتداد التاریخ البشری، ویحظى دعاة التحرر بشأن واحترام متمیزین بین جمیع الاقوام والامم، ویوضعون فی عداد العظماء وممن یستحقون التمجید.
لقد كانت الحریة تتراءى أمام اعین الناس مهمة ومصیریة بحیث اصبحوا على استعداد لتجرع الآلام والشدائد المضنیة والتضحیة بالارواح والاموال وبوجودهم كلِّه من اجل نیلها، وقد ضحى مئات الآلاف بل الملایین من البشر بانفسهم على مذبحها، فلیس عبثاً عندما ظهرت فكرة اللیبرالیة فی مقطع من التاریخ انها انتشرت بسرعة فی جمیع ارجاء العالم وحصلت على انصار كثیرین بحیث ان من البلدان بشخصیاتها وعلمائها تعتبر اللیبرالیة احد الاصول المسلَّم بها واللاعودة عنها لنظامها وفكرها وتتباهى بها.
ولكن ما هی الحریة؟ وای مفهوم تتضمن على وجه الدقة؟ وما هی مبادئ اللیبرالیة ومعالمها؟ وهل الانسان موجود حرٌّ ومختار أم مجبر ومقهور؟ وما هی العلاقة بین الدین والحریة؟ هل ان الحریة تقیّد الدین أم العكس أم لیس الاثنین؟ وكیف تُعرَّف وتُحدد حریة التعبیر عن الرأی باعتبارها من المصادیق المهمة للحریة لاسیما فی المجتمعات المدنیة المعاصرة؟ وما هو التوجه الاسلامی فی مجال حریة التعبیر عن الرأی وحریة الصحافة؟ وقد تولى الفصل الاول من هذا الكراس الاجابة على هذه الاسئلة ومجموعة اخرى من الاسئلة فی هذا المجال.
المصطلح الآخر الذی أخذ بالرواج وكثیراً ما یتردد على الالسن فی مجتمعنا فی هذه الأیام لاسیما داخل المحافل العلمیة وكثُرت المحاضرات والمقالات فی الدفاع عنه أو نقده هو مصطلح التعددیة(1)، وهذا المفهوم یشیر الى الفكر الذی على اساسه یُعتبر التكثر والتعدد مقبولا ومحبباً فی مجالات شتى من قبیل الاقتصاد والسیاسة والثقافة والفكر والدین وغیرها.
والتعددیة اضحت الیوم كاللیبرالیة مظهر التنوّر الفكری والتمدّن والتألق العلمی، ویوصم المخالفون لها بالتحجر والتعصب والعوز المنطقی والعنف وصفات اخرى مماثلة لها. ویختص الفصل الثانی من هذا الكراس بالاجابة على الاسئلة فیما یخص هذا الموضوع ساعیاً لبیان ابعاد من الابحاث ذات الصلة به.
لقد جُمعت هذه الاسئلة والردود من محاضرات متعددة القاها العلامة الحكیم سماحة آیة الله مصباح الیزدی فی حشود الجامعیین والحوزویین وفی مختلف طبقات الجماهیر احیاناً، وهذا الكراس یمثل فی الواقع استمراراً لثلاثة اجزاء سبقته: صدر الاول وهو یحمل موضوعی «النظام السیاسی فی الاسلام» و«ولایة الفقیه»، والثانی بموضوعی «ولایة الفقیه» و«مجلس الخبراء» والثالث بموضوعی «الدین والمفاهیم الحدیثة» و«الرقابة الاستصوابیة»، وها هو الجزء الرابع یُقدم للراغبین وهو یحمل موضوعی «الحریة» و«التعددیة».
وفی الختام نرى لزاماً ان نقدم الشكر لحجة الاسلام حمید كریمی وحجة الاسلام محمدمهدی نادری اللذین نهضا بمهمة إعداد وتدوین هذا الجزء من الاسئلة والردود.
إصدارات مؤسسة الامام الخمینی(رحمه الله) للتعلیم والبحث
. Pluralism.
الفصل الأول
الــحــریــة
مفهوم الحریة وتعریفه
سؤال: ما هی الحریة وما هو التعریف الذی یمكن تقدیمه لها؟
جوابه: للاجابة عن هذا السؤال ینبغی التذكیر بان المفاهیم یمكن تقسیمها الى طائفتین هما:
أ ـ المفاهیم العینیة والانضمامیة.
ب ـ المفاهیم الذهنیة والانتزاعیة.
ولا یستعصی الفهم كثیراً حینما نستخدم المفاهیم العینیة، فعلى سبیل المثال ان المفاهیم التی هی من قبیل الماء، والحركة، والبرق التی تستخدم فی العلوم الطبیعیة، أو العین، والأذن، والكبد، والمعدة... الخ التی تستخدم فی العلوم الطبیة كلها مفاهیم عینیة، ومراد المتحدث منها واضح لدى الجمیع، وان كانت هنالك موارد ربما یلفّها الغموض ایضاً من قبیل ما اذا كان الماء العكر ماءً أم لا؟
أما فی الموارد التی نستخدم فیها المفاهیم الانتزاعیة ـ من قبیل المفاهیم الفلسفیة والمفاهیم التی تستخدم فی الكثیر من العلوم الانسانیة نظیر علم النفس وعلم الاجتماع والحقوق والعلوم السیاسیة وما شابهها ـ فان التفاهم یصبح صعباً، اذ ربما یكون للمفردة الواحدة تعاریف متعددة ومختلفة، ولذا قلّما تصل البحوث حول هذه المفردة الى نتیجة.
على سبیل المثال، ذكروا لمفردة الثقافة (culture) الكثیرة التداول ما بین خمسین الى خمسمائة تعریف وقلّما یستطیع أحد ان یُقدِّم تعریفاً دقیقاً وكاملاً للثقافة، وتبعاً لذلك سیصبح مفهوم «التنمیة الثقافیة» غامضاً ومدعاة للانزلاق، وعلى اثره ستغور الاحادیث حول الثقافة والتنمیة الثقافیة فی بحبوحة من الغموض ایضاً.
وهكذا شأن مفردة الدیمقراطیة (Democracy) ایضاً، فبالرغم من ان هذه الكلمة
تستخدم بمعنى «حاكمیة الشعب» أو «حكومة الشعب على الشعب» لكن معناها لیس واضحاً على وجه الدقة، فهل ان هذه المفردة تفید نوعاً من الحكم؟ أم نمطاً معیناً فی علاج القضایا الاجتماعیة؟
والمثال الآخر مفردة اللیبرالیة (liberalism) التی تعنی تبنّی الحریة وبذلك تكتسب بریقاً خاصاً، ولكن لم یتم بیان معناها بشكل دقیق. كما ان مشكلة الترجمة وتحویل المفردة الى لغة اخرى یزید الغموض فی مثل هذه الكلمات.
ولم تخلُ مفردة الحریة من هذا الغموض والاختلاف فی المعانی والاستنباطات ایضاً، ولغرض ان یتحقق التفاهم فی البحوث الخاصة بالحریة یتعین الوصول لتعریف مشترك لها، ومن ثم الجلوس للحوار بعد الاتفاق على معنىً معین، وخلال الابحاث التی جرت فی غضون السنوات العدیدة الاخیرة حول الحریة لم یحصل التفاهم نتیجة وجود هذه المشكلة.
ربما تستخدم كلمة الحریة بمعنى الاختیار فی مقابل الجبر، وقد یكون المراد من الحریة ایضاً الانسان الحر فی مقابل المملوك والعبد، وتارة یقال ان فلاناً یتمتع بحریة الرأی ای ذو رأی مستقل فی قبال التقلید بالرأی، وفی بعض الحالات تستخدم الحریة ایضاً بمعنى ان یفعل الانسان ما یشاء ویقول ما یحلو له، وبعبارة اخرى ان لا یقیده قید أو شرط فی قوله وفعله، وما یتعلق بالبحث والحدیث فی فلسفة الحقوق وفلسفة القانون هو هذا المعنى الاخیر.
لقد ذكر بعض الكتّاب فی الغرب ما یقرب من مائتی تعریف للحریة یقترب الكثیر منها مع بعضها فیما یتنافى بعضها مع البعض الآخر. وان كافة الامم والاقوام تولی الحریة قداسة متمیزه وتنشدها، ورغم ذلك فان الاختلاف یطرأ حول بعض الامور مما یؤدی الى حدوث نقاش وجدال وربما الى حدوث نزاع وصراع وقتال احیاناً.
والنتیجة هی: نظراً لما تتصف به مثل هذه المفاهیم ـ ومن بینها مفهوم الحریة ـ عن فضفاضة ومطاطیة، فانه یتعین التوصل الى معنىً واضح ودقیق لها قبل الحدیث
والرد على أی سؤال حولها، ومن ثم مواصلة البحث، لاننا اذا اردنا مقارنة التعاریف كلاً على حدة مع الاسلام والبحث فی انسجامها أو عدم انسجامها مع الاسلام فسنواجه بحثاً فی غایة التشعب والصعوبة.
بناءً على هذا، یبدو ان اسهل الطرق للمضی قدماً فی البحث هو تحدید موارد مفردة الحریة ومصادیقها بدلاً من البحث حول تعریفها ومعناها، فمثلاً یُطرح السؤال التالی: هل الصحافة حرّة فی الاسلام وما هی حدود هذه الحریة؟ هل العلاقات الجنسیة حرّة ومطلقة فی الاسلام والمجتمع الاسلامی؟ هل الاساءة للآخرین والاستهزاء بهم واهانتهم أمر مطلقٌ ومسموح به أم لا؟
ونتیجة الكلام هی ان تعاریف الحریة متنوعة جداً ولیس من الضرورة والسهولة الى حدٍّ كبیر الاتفاق على تعریف واحد، وانما المهم هو إیراد الموارد الخاصة بالحریة وعقد الحوار بشأنها.
* * * * *
التدین حق الانسان أم تكلیفه؟
سؤال: هل التدین حق للانسان ام تكلیف علیه؟
جوابه: ربما تطرح المسألة بهذا النحو: ان البشر فیما مضى كانوا یذعنون للقوة والاستبداد والعبودیة ویستسلمون للتكلیف والمسؤولیة، غیر ان الانسان الآن وفی عصر الحضارة والمدنیة الحدیثة یبحث عن حقوقه ویطالب الطبیعة والله والدین بحقه، وهنا یكمن السرّ فی تطور البشر، وعلیه اذا ما اراد دین بلوغ النجاح فی عصرنا فینبغی ان لا یتحدث عن التكلیف وطاعة الله والنبی والحاكم الشرعی، بل علیه ان یتحدث عن حقوق متنوعة ومتعددة للانسان فی هذا المجال، فلقد مضى زمان الحدیث عن الطاعة والتكلیف والحدّ والواجب والحرام، ولابد من الاهتمام برغبات الانسان.
فی معرض الاجابة ینبغی فی البدایة التطرق الى هذه القضیة وهی: هل ثمة حقٌ یترتب دون تكلیف یقابله أم لا؟ لقد اجاب فلاسفة الحقوق بانه لا معنى لأی حق دون تكلیف یقابله، فعندما نقول ـ مثلاً ـ ان لكلّ انسان حق الانتفاع بالهواء الطلق، فمعنى ذلك انه لا یحق للآخرین تلویث الجوّ، والاّ فلو قلنا بحق الجمیع وحریتهم فی تلویث الجو فانه لن یعود هنالك معنىً لحق الانتفاع بالهواء الطلق. وكذلك اذا قیل: ان لی الحق فی التنعم باموالی، فمعنى ذلك ان الآخرین ملزمون بعدم التطاول على اموالی واحترام حقی، واذا كان من حق الآخرین التمتع باموالهم فانا مكلّف بان لا اتطاول على اموالهم ایضاً. اذن الحق والتكلیف متلازمان مع بعضهما، واثبات الحق لأحد معناه اثبات التكلیف على الآخرین.
الأمر الثانی هو ان أی حقٍّ یثبت للمرء یلازمه تكلیف علیه، فلو كان ـ مثلاً ـ لأحد حق الانتفاع من مكتسبات المجتمع فهو مكلف ایضاً بخدمة المجتمع. اذن
اثبات أی حقٍّ للمرء یثبت معه تكلیف علیه.
ثمّ إنّه ینبغی الانتباه الى ان الغایة الاساسیة من هذا السؤال والشبهة المذكورة هی ان الله لا یحق له فرض التكلیف علینا وأمرنا ونهینا، واذا كان هنالك حق وتكلیف فالناس هم الذین یحددونه، ولا مجال الیوم للقول بعلاقة العبد والمولى والتعبد والطاعة المطلقة، فالزمن زمن حریة الانسان وكرامته.
ان التهرب من التكلیف ـ بالطبع ـ وامتناع الانسان عن الاذعان لأوامر الله تعالى ونواهیه لا یقتصر على الانسان المعاصر المتحضر، فلقد كان النزوع نحو الاعمال الصالحة والطالحة كامناً فی نفوس البشر منذ بدء الخلیقة، وما دفع قابیل لأن یقتل هابیل كان هو عدم رغبة أحد ابنی آدم فی الخضوع للقانون ونیته فی التحلل من التكلیف، وان القصص التی تصور صراع الانبیاء(علیهم السلام) مع الاقوام السالفة والتی تكرر ذكرها فی القرآن تعج بذوی الطباع الحیوانیة والشیطانیة من البشر الذین یأبون الانصیاع للحق ولا یخضعون للتكلیف الالهی.
على أیة حال، ان اساس الحضارة والرقی هو تقبل الناس للمسؤولیة والتكلیف والقانون، وان اساس الاسلام والدین هو الامتثال للتكالیف والاحكام الالهیة، وان بلاغ الانبیاء جمیعاً هو الدعوة للتوحید (لا اله الاّ الله)، وبما ان الله تعالى هو خالقنا وبارئنا ونحن عبید ومملوكون له فبامكانه التصرف بنا واصدار الامر والنهی لنا كیفما شاء. اذن روح الدین هو التحرر من كل قید وغلٍّ ومعبود سوى قید العبودیة لله تعالى.
لقد خلق البشر مختارین احراراً تكوینیاً. وبالرغم من ان خلق الانسان والكون بأصله وحجمه وطبیعته جاء بمشیئة الهیة، وهو یسبح الله بلسان صامت، بید ان الارادة الالهیة قضت من الناحیة التشریعیة ان یبیَّن طریق الخیر والشر وان یختار البشر طریق السعادة والكمال انطلاقاً من حسن اختیارهم، وان ینالوا عبر ادائهم للتكالیف الالهیة حقهم العظیم وهو القرب من الله تعالى.
* * * * *
الدین والحریة، انسجام أم تناقض؟
سؤال: هل ینسجم الدین مع حریة الانسان؟
جوابه: أُثیر هذا التساؤل لحد الآن ـ الذی یُطرح احیاناً فی اطار مغالطات براقة ومفریة ـ بصور متعددة یمكن تقسیمها بمجموعها الى طائفتین: فی اطار الدین وخارج اطار الدین، ففی الاطار الدینی جرت المحاولات واستناداً لبعض الآیات القرآنیة لتصویر أی نوع من تقیید الحریات على أساس انه امر مناف للدین، أما خارج اطار الدین فقد نُظر الى السؤال اعلاه عبر ثلاث رؤىً متباینة حیث یجری الایحاء ـ اعتماداً على اختیاریة الانسان، ومحوریة الانسان، والتنصل من المسؤولیة ومطالبة الانسان بحقوقه فی عصر المدنیة ـ بانه لا حقَّ للدین فی تقیید الحریات، ولابد من تفسیر الدین بنحو لا یقف فی وجه الحریة.
وفی البدایة سنردّ على الشبهة فی اطارها الدینی ومن ثم نبادر للاجابة علیها وهی خارج اطار الدین، وسوف نعكف على البحث عبر الرؤى الثلاث.
أ ـ فی الاطار الدینی
یقوم هذا النمط من الشبهة الذی یثار من قبل المتدینین والمسلمین على أساس ان الدین اذا ما تدخَّل فی الشؤون السیاسیة والاجتماعیة للانسان والزمَ الناس بسلوك معین، أو ارغمهم على طاعة أحد، اذ ذاك سیتناقض مع حریة الانسان. كما ان الانسان موجود له حریته واختیاره وبامكانه ان یفعل مایشاء. ان الاسلام یحترم حریة الانسان كثیراً، واستناداً الى العدید من الآیات القرآنیة فان الانسان لیس مُلزماً باطاعةِ أحد، ومن هذه الآیات على سبیل المثال:
1 ـ جاء الخطاب فی الآیة 22 من سورة الغاشیة: «لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِر» اذن:
استناداً لهذه الآیة لا ینبغی للنبی(صلى الله علیه وآله) التدخل فی شؤون الآخرین. وعندما لا یمتلك النبی(صلى الله علیه وآله) ـ وهو خیر البشر ـ حق التصرف فی شؤون الآخرین، فمن البدیهی ان لا یمتلك الامام المعصوم(علیه السلام) والفقیه وأی شخص آخر مثل هذا الترخیص ایضاً.
2 ـ یقول تعالى فی الآیة 107 من سورة الانعام: «وَما جَعَلْناكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً وَما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیل».
3 ـ تقول الآیة 99 من سورة المائدة: «وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ» أی على الرسول ابلاغ الرسالات الالهیة الى الناس فقط، والناس احرار ان شاؤوا عملوا بها وان لم یشاءوا لم یعملوا.
4 ـ تقول الآیة 3 من سورة الدهر: «إِنّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمّا شاكِراً وَإِمّا كَفُوراً»، أو الآیة 29 من سورة الكهف: «فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْیَكْفُرْ».
الجواب
اولاً: لابد فی البدایة من الانتباه الى ان مثل هذه الشبهات انما تُطرح فی زماننا لإضعاف نظریة ولایة الفقیه لیتسنى من خلالها تصویر الطاعة لولی الأمر والحاكم الدینی على انها تتنافى مع حریة الانسان.
ثانیاً: ان الآیات المذكورة واستناداً لما قدّمه هؤلاء من تفسیر لها تتناقض مع طائفة اخرى من آیات القرآن الكریم، اذ یقول تعالى فی الآیة 36 من سورة الاحزاب: «وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ».
أو قوله فی الآیة 6 من سورة الاحزاب: «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». والأَولى إما تعنی انّه مقدّم أو انه یتمتع بالولایة، ویقول المفسرون ان مفاد الآیة هو: ان النبی(صلى الله علیه وآله) مقدمٌ على الناس أنفسهم فی اتخاذ القرار بشأنهم ولا یحقّ للآخرین ابداء وجهات نظرهم فی مقابل ما یقرره(صلى الله علیه وآله).
أو فی الآیة 65 من سورة النساء حیث یقول تعالى: «فَلا وَرَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتّى
یُحَكِّمُوكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیماً».
اذا كانوا مؤمنین بان حكمك هو حكم الله، وان الله هو الذی منحك هذا المنصب، وعلیك العمل بما یحكم به الله عز وجل، وهم بدورهم یتقبلون هذا الحكم، اذن لا یراودهم القلق فی هذه الحالة إلا أن یكونوا غیر مؤمنین فی قلوبهم.
وهنا إما ان نقول بوجود تناقض بین الآیات القرآنیة ـ والقرآن منزه عن هذا الظن ـ وإما ان نفسر الآیات استناداً الى الآیات الاخرى وبالاستعانة بأحادیث المعصومین(علیهم السلام) المعتبرة.
یتبین من خلال البحث فی مطلع الآیات من الطائفة الاولى وخاتمتها وسیاقها ان المراد فی هذه الآیات هم الكفار، وان الله سبحانه وتعالى یواسی النبی الاكرم(صلى الله علیه وآله)بان لا یهلك نفسه ولا یحزن لدخول بعضهم الى جهنم. فواجبك هو ابلاغ الحق وبیانه وایمان الناس لیس مهمتك، فنحن قد منحنا البشر حریتهم وسیجزون على أعمالهم فی المستقبل.
بناءً على ذلك، تكون نتیجة هاتین الطائفتین من الآیات: هی ان مهمة النبی(صلى الله علیه وآله)فی البدایة ابلاغ الدین وهنالك مَن یقبله وهنالك من یُنكره شئنا ام ابینا. أما الطائفة التی آمنت فعلیها الامتثال للتعالیم الالهیة والدینیة امتثالاً مطلقاً.
وربَّ مَن یتصور هنا كما ان الناس مختارون فی قبولهم لأصل الدین، فان المسلمین سیكونون احراراً فی العمل أو عدم العمل باحكام الدین أیضاً، بید ان هذا تصور باطل، اذ ان المرء اذا ما اعتنق الاسلام سیكون معنى ذلك ایمانه بهذا الدین واحكامه والتزامه بتطبیق تعالیمه، واذا ما اعتبر نفسه حراً فی العمل بهذه الأحكام فمعنى ذلك انه یرى عدم التزامه بتطبیقها، وهذا تناقض بین الاعتقاد والعمل لیس الاّ، كمثل شعب ینتخب حكومةً وقانوناً ثم یقولون اننا احرارٌ فی ان ننفذ أو لا ننفذ قراراتها، وهذا كلامٌ مرفوضٌ فی ای بقعة من بقاع العالم.
اذن لا اجبار فی اصل اعتناق الاسلام (لا إِكْراهَ فِی الدِّینِ) ولا یمكن فرض
الایمان بالله والنبی والمعاد على الآخرین، ولكن لابد ـ بعد القبول بالاسلام ـ من العمل باحكامه وتعالیمه، وكمثال على ذلك یجب اداء الصلاة والصوم ویجب امتثال اوامر نبی الاسلام(صلى الله علیه وآله) والامام(علیه السلام)، وكذلك یتعین الالتزام بسائر الاحكام الدینیة دون استثناء، لان القبول بأی دین أو قانون یعنی القبول بلوازمه وتبعاته ایضاً، والاّ لن یستتب أی نظام أو مجتمع وسیعمل كل شخص بما یروق له شخصیاً.
یقول تعالى فی الآیتین 150 و151 من سورة النساء فی هذا الصدد ـ وجوب الامتثال لكافة التعالیم الدینیة ـ: «إِنَّ الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَنَكْفُرُ بِبَعْض وَیُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذلِكَ سَبِیلاً * أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِینَ عَذاباً مُهِیناً»، أی ان الذین یحاولون تجزئة الدین ویقولون نؤمن ببعض ونرفض بعضاً هم ممن لم یرتضِ الدین حقاً وهم كفارٌ لان الاحكام بأسرها من الله وبهذا فلا فرق بینها. اذن انكار بعض الدین بمثابة انكار كلّه وهو یستوجب الكفر والعذاب الالهی.
ان الحكومة الاسلامیة لا تتدخل ـ بالطبع ـ فی الشؤون الشخصیة والسرّیة، لكنها تتدخل فی القضایا الاجتماعیة وما له علاقة فی المحافظة على حرمة الدین والمقدسات. وتحض المواطنین على العمل، وفی هذه الحالة تتحقق ولایة النبی والامام والفقیه.
ولا یفوتنا القول ان البعض ـ وكأسلافهم على مر التاریخ ـ یحاولون فی الوقت الراهن ـ باستنادهم الى الآیات المتشابهة أو المثلة بآیات القرآن الكریم أو حتى الصاق التناقض بهذه الآیات ـ تحقیق مآربهم المشؤومة والمعادیة للدین وجرف الآخرین نحو هاویة الانحراف والانحدار كما فعلوا بأنفسهم.
ب ـ خارج اطار الدین
ربما تثار الشبهة بالشكل التالی: ان الفصل المقوّم والممیّز للانسان هو كونه مختاراً،
أی ان الفارق بین الانسان وبین سائر الحیوانات هو انها مجبورة بالعمل وفقاً لغریزتها، أما الانسان فهو مخلوق مختار یعمل بما یملیه اختیاره. واذا ما اراد الدین ومن خلال مجموعة من الاحكام والتعالیم، الزام الناس باداء اعمال معینة أو تجنبها أو دعوة الناس لطاعة النبی(صلى الله علیه وآله)والامام(علیه السلام) أو نائب الامام، فقد قام بما یتعارض مع اصل انسانیة الانسان، وبتعبیر آخر ان القوانین والاحكام الدینیة تستوجب سلب انسانیة الانسان وحریته!
قبل الخوض فی الاجابة نذكّر أولاً باشكال فلسفی ـ على صلة بهذه الشبهة ـ والرد علیه لیكون مدخلاً للجواب الاصلی. اننا نواجه مقامین: احدهما مقام التكوین والوجودات والواقعیات، والآخر مقام التشریع والواجبات والقیم. والاشكال هو ان المدرك لـ «ما هو موجود» هو العقل النظری والمدرك لـ «ما ینبغی ان یوجد» هو العقل العملی، وهما مستقلان عن بعضهما، فلا یمكن النفوذ عن طریق الوجود والعلوم الى الواجبات والقیم، وهذا الطریق مسدود منطقیاً، فلا یمكن القول ـ مثلاً ـ بما ان الانسان مخلوق من قبل الله تكوینیاً، اذن یجب ان یمتثل للاحكام الالهیة.
لقد اثیرت هذه الشبهة فی البدایة من قبل دافید هیوم الفیلسوف الانجلیزی الشهیر فی القرن الثامن عشر، وبعد انتصار الثورة الاسلامیة فی بلادنا انبرى أناسٌ للحدیث والكتابة فی هذا المجال وشحذوا هممهم لترویجها فی المجتمع.
والرد على هذه الشبهة على نحو الایجاز هو اولاً: ان هذا الاشكال یتناقض مع مبناكم، لانكم تریدون الوصول من الوجود الى الواجب فتقولون: ان الانسان موجود مختار اذن یجب ان یُترك حراً ولا ینبغی اجباره على الطاعة. ثانیاً: طبقاً لما تقولون لا یمكن اجبار أی شخص اینما كان وأیة حكومة، ولكل انسان ان یفعل ما یشاء، لان القانون والاجبار سلبٌ لحریة الانسان، وسلب الحریة سلبٌ لانسانیة الانسان، وحصیلة هذا القول لیس سوى الهمجیة والبربریة وسیادة قانون الغاب مما لا یرتضیه أی عاقل.
لو اراد كل امرئ فی المجتمع ان یتصرف بما یروق له فیضرب من یشاء ویتفوه بأیّ حدیث ـ وان كان فیه إهانة وإساءة للآخرین ـ ... الخ، فلن یعود هنالك من اثر للحیاة التی تقوم على اساس العقل والفطنة. ان قوام الانسان ومیزته هو عقله ومن لوازم امتلاك العقل هو تحمّل المسؤولیة وتقبّل القانون، فلا حضارة بدون قانون، ولولا المسؤولیة لن تكون هنالك انسانیة.
ولكن حلّ هذا الاشكال یتمثل فی وجوب تفصیل هذه المسألة والقول: اذا وصلت مجموعة الوجودات الى حد العلّة التامة ففی مثل هذه الحالة یمكننا استنتاج ضرورة وجود المعلول بفضل وجود العلّة، والتعبیر عن هذه الضرورة بالقیاس بمفردة «یجب» وبذلك یتم الانتقال من «ما هو موجود» الى «ما ینبغی ان یوجد»، والاّ فیكون هذا الانتقال متعذراً، وعلى صعید بحثنا فان الاختیار التكوینی یعد ممهداً وجزءاً من العلّة للتكلیف والطاعة ولیس علّة تامة لهما.
بناءً على هذا فان الرد الاساس على هذه الشبهة هو: ان معنى حریة الانسان واختیاره بصفتها فصلا ممیزاً له هو امتلاك القدرة التكوینیة على الاختیار والانتخاب، أما فی البعد التشریعی فهو وجوب تحمّله للمسؤولیة واذعانه للقانون والقول بوجود حدود لافعاله واقواله، والاّ فانه سیخرج عن الانسانیة. وان الحدیث عن حدود القانون وطبیعته حدیث آخر ینبغی البحث عنه فی موضع آخر.
صورة اخرى للشبهة
والصورة الاخرى للشبهة هی ان زمن العبودیة قد ولّى، وان صورة العبودیة والمولویة بین الانسان وبین الله انما هی تختص بزمن النبی(صلى الله علیه وآله)، ولم یعد هنالك حدیث عن العبد والطاعة والتكلیف فی عصر الحضارة، بل ینبغی الحدیث عن الانسان «السید» أو ما یعبر عنه القرآن الكریم بـ «خلیفة الله»، فنحن خلفاء الله ومثلنا مثله نحكم الارض وندیر شؤونها، ولقد انتهى زمن المسؤولیة وتحمّلها، وان
تلك الطائفة من آیات القرآن ذات الصلة ببحث العبد والمولى أو التی تتحدث عن الطاعة انما هی تختص بعصر نزول القرآن ولیس مرحلة الانسان المدنی المعاصر.
وملخص الرد على هذا الكلام الذی یحاول الایحاء بوجود تضارب بین الدین والحریة هو أولاً: ان صفة «خلیفة الله» التی اشارت الیها بعض آیات القرآن والواردة بشأن النبی آدم(علیه السلام) لا تشمل كل الناس، فلیس كل من كان على هیئة انسان هو خلیفة الله فی التصور الاسلامی، فالقرآن الكریم یرى بعض بنی آدم من قبیل شیاطین الانس ویصرّح «وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِیّ عَدُوًّا شَیاطِینَ الإِْنْسِ وَالْجِنِّ»(1)، والقرآن یعتبر بعض الناس احقر واضلّ من الانعام(2) وبعضهم اسوء الدواب على وجه الارض(3)، ومن المسلَّم به ان هؤلاء لا یمكن ان یكونوا خلفاء الله على الارض.
ان خلیفة الله هو مَن كان له علمٌ باسماء الله الحسنى ویتمتع بالاهلیة لإقرار العدالة الالهیة فی الارض، وخلیفة الله هو مَن یجسّد الصفات الالهیة فی الحیاة الفردیة والاجتماعیة ولیس كل من یمشی على رجلین.
ثانیاً: بالاضافة الى البحث القرآنی الذی یستدعی مجالاً أوسع، ینبغی التأكید على ان القول بأن كرامة الانسان بحریته والیوم قد انتهى زمن القیود والمسؤولیة ما هو الاّ شعار خادع رُفع فی البدایة فی الغرب واستقبله أُناسٌ فی بلدان عدیدة من قبیل ایران واخذوا یرددونه دون وعی للوازمه.
ورغم حاجة هذه القضیة لبحث مفصل فان ما یسعنا قوله بایجاز هنا هو اننا نتساءل: ان المراد من «یجب ان یتحرر الانسان من أیة مسؤولیة وتكلیف ولا تقیده قیود» هل هو نفی وجود أی قانون؟ اذا كان الامر كذلك فذاك مما لا یتفوه به أی عاقل، ومثل هذا المجتمع مما تتعذر الحیاة فیه، لان ذلك مما یستلزم امكانیة كل
1. الأنعام: 112.
2. الأعراف: 179.
3. الأنفال: 22.
امرئ لقتل غیره أو الإساءة الیه وهتك عرضه أو سلب أمنه وأمواله وكرامته... الخ، وان عواقب هذه النظریة ستحیق بالقائلین بها وتطیح بهم أولاً.
اذن لابد ان تكون الحریة المنشودة مقیدة ومشروطة، وفی مثل هذه الحالة یكون السؤال هو: مَنْ هی الجهة التی تشخص حدود الحریة؟ فاذا ما اراد كل امرئ ان یضع الحدود طبقاً لرغبته اذ ذاك ستعود نفس المشكلة المتقدمة. اذن لابد ان تتولى جهة قانونیة ذات صلاحیة لتعیین الحدود.
ولكن مَن تكون هذه الجهة یا ترى؟ وهنا یقدّم المتدین المسلم جواباً فیما یجیب اللیبرالی الغربی غیر الموحد بجواب آخر.
وجواب المسلم هو ان هنالك الهاً فی الكون هو خالق الكائنات وعلى معرفة اكثر من غیره بمصالح الكائنات والانسان ومفاسده، ولا یرید سوى الخیر والكمال لعباده، ولیس هنالك اصلح منه لتعیین حدود الحریة، وبهذا الكلام لا یعتری نظریة المسلمین أی تناقض أو مؤاخذة.
أما اللیبرالی غیر الموحد فیقول: البشر هم الذین یجب ان یعینوا حدود الحریة، وهذه النظریة عرضة للكثیر من المؤاخذات من بینها ان الناس لن یجمعوا على نظریة مشتركة أبداً، واذا ما جعلنا من رأی الاكثریة ملاكاً، فكیف تنال الاقلیة ـ التی ربما تكون 49% من الناس ـ حقوقها الانسانیة؟ بالاضافة الى ما اثبته البشر على مر التاریخ من عجز عن تشخیص مصالحهم ومفاسدهم مادیاً ومعنویاً بشكل كامل، من هنا فهم یبادرون لإعادة النظر فی آرائهم على الدوام.
* * * * *
هل الانسان مجبر أم مختار وحرّ؟
سؤال: مع وجود مختلف القوانین المسیطرة على الانسان والكون، أین موقع الاختیار؟ وما الفرق بین الاختیار التكوینی والحریة التشریعیة؟ وهل الانسان مختار؟
جوابه: من القضایا المهمة والجدیة على صعید فلسفة معرفة الانسان هو بحث الجبر والاختیار، فلقد كان هذا البحث من الامور القدیمة بالنسبة للبشر حیث كان موضع أخذ وردٍّ واختلاف فی الآراء، وكذلك الیوم اذ له سوقه الساخن فی المحافل الفلسفیة عالمیاً.
ان اثارة هذا البحث والالمام بجوانبه یستدعی المزید من الوقت، ونحن هنا نشیر لهذا الموضوع باختصار وذلك لارتباط قضیة الاختیار بموضوع الحریة.
كما تعلمون ان المتكلمین المسلمین ینقسمون الى ثلاث فئات فیما یخص مسألة الجبر والاختیار وهی:
أ ـ الاشاعرة: وهم القائلون بالجبر ویعتبرون التوحید الافعالی لله مستلزماً لنفی الاختیار عن الانسان.
ب ـ المعتزلة: وهم القائلون بالتفویض وایكال الاعمال للانسان، ویرون عدم تدخل الخالق فی أفعال البشر تنزیهاً له عن الأفعال السیئة والخطایا.
ج ـ الامامیة: وهم یعتقدون بـ «الامر بین امرین» ویقتفون إثر الائمة المعصومین(علیهم السلام) فی عدم قبولهم بالجبر الكلی والتفویض التام. وبتعبیر مبسَّط ومتسامح: اننا مجبرون من ناحیة ومختارون من ناحیة اخرى.
والیوم هنالك من لهم میول مضادة للاشتراكیة ویؤیدون الحریة المطلقة للانسان ویقولون: ان بمقدور الانسان ان یفعل ما یشاء، وثمة عبارة مشهورة لجان بول
سارتر یقول فیها: لو شئتُ لانتهت حرب فیتنام، ومعنى هذه العبارة المفرطة فی المبالغة ان لذى الانسان القدرة على ایقاف حرب كبرى یشترك فیها الملایین، وفی المقابل هنالك فلاسفة یقولون ان اختیار الانسان وهمٌ، والحقیقة هی ان الانسان اسیرٌ لمجموعة من القوانین الجبریة وهو یساق نحو جهة ما بالاجبار.
والفكرة الصحیحة والدینیة هی ان الانسان مختار ولكن فی حدود معیّنة، فللبشر مساحات اختیار ما بین النقاط التی تلتقی عندها القوانین السائدة على الكون والطبیعة، فدائرة عمل البشر تتمثل فی استثمار القوانین لصالح غایاته، وهو باستثماره لقانون طبیعی واكتشافه المتواصل یحقق غلبةً على قانون طبیعی آخر، وان معنى عبودیة الانسان التكوینیة هو اننا نعیش بین الآلاف من القوانین الطبیعیة والعلل والمعلولات ونتمتع باختیار تكوینی ضمن دائرة ضیقة.
وفی اطار دائرة الاختیار التكوینی هذه، هل بامكان الانسان ان یفعل ما یحلو له أم هنالك مجموعة من القیود والقوانین التشریعیة تقید عمله؟ والجواب هو: ان لنا قوانیننا فی هذه الدائرة لكنها لیست قوانین تكوینیة بل هی قوانین تشریعیة أو اعتباریة أو قیمیة، أو ما عبّر عنه القدماء قبل آلاف السنین بدائرة العقل العملی فی مقابل القوانین الخارجیة التی تمثل دائرة العقل النظری.
ان الالتزام بالقوانین التشریعیة هی مسؤولیة الانسان ولا جبر هنا أبداً، فمن كان طالباً للكمال والسعادة عمل بهذه التعالیم والاّ فبمقدوره تركها. والانسان یمتلك قابلیات خارقة، فاذا ما عمل بالقوانین الالهیة والتشریعیة نال القرب من الله وجواره، وان لم یعمل بها وعصى هوى الى اسفل السافلین والى مرتبة ادنى من الحیوانات. فالتعالیم الشرعیة كالتعالیم الطبیة إن عمل بها المریض نال السلامة وإن خالفها أصابه المرض أو تفاقم مرضه، ففی الوقت الذی یكون المریض مختاراً فی العمل بتعلیمات الطبیب لكنه اذا كان طالباً للسلامة والنشاط فعلیه الالتزام بالمقررات الصحیة، وهذا ما یعنیه الاختیار.
اذن بلوغ السعادة مادیاً ومعنویاً، فردیاً واجتماعیاً منوط بمجموعة من القوانین التشریعیة التی یتعذر بلوغ السعادة الابدیة بدون الالتزام بها، وان كان بمقدور الانسان القول: اننی حرٌّ ولا أرید العمل بهذا القانون أو هذا الدواء وارید الدخول الى جهنم، كما یقوم بذلك الكثیر من الناس فی الخارج.
ولا بأس ان نشیر هنا الى الدلیل على الاختیار، فبالاضافة للوجدان والشعور الباطنی بوجود الاختیار فان وجود الدین ومختلف القوانین الحقوقیة والجزائیة والاخلاقیة وما شابهها والاطراء على البشر وذمهم، كلها ادلّة على اختیار الانسان. بل ان ما یفتخر به الانسان ویمیزه هو اختیاره خطّه بحریة، ولولا هذا الاختیار لم یكن هنالك ما یمیزه عن سائر المخلوقات. وحیثما جرى الحدیث عن مدح أو ذم لسیرة اشخاص وسلوكهم وتوجهاتهم فمعناه ان كل واحد منهم قد اختار فعله هذا بحریة، فلو ان طفلاً أو رجلاً قام بفعل مجبراً، فهل بامكانكم توبیخه بالقول لِمَ فعلت هذا؛ أو مدحه بالقول احسنت صنعاً؟!
ان فی كافة الادیان والقوانین الحقوقیة والمذاهب الاخلاقیة یوجد افتراض سابق وهو «ان الانسان حرٌّ» لان الانسان إن كان مجبراً فلن یكون من معنىً للامر علیه أو نهیه، لاسیما الادیان التی فرضت كلّ هذه الاحكام والاوامر والنواهی على كلام الانسان ومأكله ومشربه وما ینظر الیه وما یقرؤه وسائر افعاله، اذن یتضح من هذا انها تعتبر الانسان مختاراً ولولا حریة الانسان فی عمله لما انزل الله الحكیم والعادل مثل هذه الاحكام أبداً، وبالرغم مما یراه علم النفس والمذهب السلوكی الذی یرى سلوك الانسان افرازاً للوراثة والبیئة الطبیعیة والاجتماعیة ولا یفتح أمام الاختیار مزیداً من المجال، فان الادیان ولاسیما الاسلام تجعل لكل عمل من اعمال الانسان تكالیف عدیدة وتعتبر الانسان مختاراً ومسؤولاً فی كافة المجالات.
* * * * *
حدود الحریة
سؤال: هل الحریة مطلقة أم مقیدة؟ وما هی حدود الحریة؟ ومَن الذی یجب ان یعیّن دائرة الحریة؟
جوابه: كما تقدم القول ان مفردة الحریة من المفاهیم الرائعة والمقدسة بالنسبة للبشریة كلّها، وهذه المفردة تمثل مفهوماً غامضاً وفضفاضاً ومجالا للانزلاق، فالبعض یرون الحریة اسمى وارفع من الله والدین ویقولون انه لا حقّ للدین فی ان یعارض حریة الانسان!
فی معرض الرد على مثل هذه الاقوال ومواجهتها نسأل فی البدایة: ما هو مرادكم من الحریة؟ أهی الحریة المطلقة أم المقیدة؟ فان كانت الحریة المطلقة هی المراد فهی مما لا یقبل بها أحد أبداً، وان قصدتم المقیدة فنحن نسألكم، مَن الذی یحدد الحریة؟ فاما البشر والقوانین البشریة هی التی ترسم الحدود، وهذا مرفوض فی نظر الانسان المسلم، اضف الى ذلك ان المسلمین یؤمنون بالقانون الاسلامی، وان ارتضى غیرهم قانوناً آخر. وإما ان یضع الدین والباری عز وجل الحدود، حینذاك تكون الحریة صحیحة فی اطار القوانین الدینیة والالهیة لیس الاّ.
وللایضاح نقول: ان الحریة المطلقة وغیر المقیدة تعنی قیام كل امرئ بما یحلو له فی قوله ومأكله وسائر أفعاله، وهذه الحریة ترفض كل دین وقانون، لان كل قانون یضع حدوداً لقسم من افعال البشر.
اذن الحریة المطلقة انما تعنی فقدان القانون وبالتالی الفوضى والانفلات والهمجیة، وهذا أمر لا یرتضیه أی عاقل. اذن لابد من ان تتحدد الحریة بقیود على الدوام، وحیث اصبحت الحریة مقیدة فان الحدیث یجری الآن حول قیود الحریة، ما هی ومَن الذی یجب ان یشخصها؟
قیل: ان المعتبر هو الحریة المشروعة والقانونیة، فما المراد من الحریات المشروعة؟ اذا كان المراد من المشروع هو المعنى الشرعی والدینی كما یدل على ذلك الاصل اللغوی فذاك هو ما نقوله من ان الحریات التی تحظى بالاعتبار ـ سواء أكانت فردیة أم اجتماعیة ـ هی التی یحددها الدین ویأذن بها الله سبحانه. اذن ینبغی عدم القول بعد ذلك ان الحریة فوق الدین ولیس للدین ان یقید حریات البشر. واذا كان المراد من المشروع ـ كما هو شائع فی الحقوق السیاسیة ـ هو ما یعنی الحریات التی یقرها القانون، فلابد من تركیز الحدیث هنا على القانون، مَنِ الذی یجب ان یُقر هذا القانون؟ بالاضافة الى انه بذلك یتضح ان القانون یضفی الاعتبار على الحریة، ولیست الحریة فوق القانون. والحریة فی ضوء التفسیر الاول لا تتنافى مع الدین، وهی لا تتنافى مع القانون ایضاً استناداً للتفسیر الثانی، واما القانون الذی یقید الحریة فهو ـ فی تصورنا نحن المسلمین والمؤمنین ـ القانون الذی یضعه مالك الكون والانسان أی الله سبحانه وتعالى، لان حق التشریع والتقنین منحصرٌ بالاساس بالله عز وجل، وفی الحالات التی یكون قد وضع قانوناً فانه یتعین على البشر الامتثال له، أما فی الحالات التی اناط مهمة التقنین فیها للبشر فبامكاننا سنُّ قوانین معینة ضمن دائرة الفراغ تلك من خلال الرجوع للآراء والنظریات. اذن الحریة القانونیة تعود الى الحریة الدینیة المشروعة بالمعنى الشرعی لهذه الكلمة، وبالنتیجة یجب ان تكون الحریة على الدوام فی اطار القوانین الالهیة والاسلامیة لا اكثر ولا اقل.
ان الذین یحملون فكراً لیبرالیاً وغربیاً یعتبرون الناس ورأی الاغلبیة ملاكاً للقانون والمقنن، فاذا ما ارتضى الناس نوعاً من الحریة صار قانونیاً والا فلا، واذا ما ارتضوه فی فترة ما كان قانونیاً واذا ما رفضوه فی فترة اخرى اصبح غیر شرعی، فالشذوذ الجنسی ـ مثلاً ـ كان غیر قانونی فی الغرب سابقاً لعدم قبول الناس به حینذاك، لكنهم وحیث یقبلونه الآن فهو یصبح قانونیاً الیوم.
أما فی الفكر الاسلامی والدینی فان المشرع هو الله تعالى، وان حدود الحریة فی الغرب هی نقطة التزاحم مع حریة الآخرین ومصالحهم المادیة، بید ان حدود الحریة فی الاسلام هی المصالح الحقیقیة للبشر سواء كانت مادیة أو معنویة.
حتى لو اردنا العمل فی الجمهوریة الاسلامیة فی ایران وفقاً للفكر الدیمقراطی الغربی، فبما ان غالبیة الشعب مسلمون فان رأی الاغلبیة ینسجم مع الاسلام والدین، وفی جمیع الاحوال فان الدین الاسلامی هو الذی سیرسم حدود الحریة، وان الذین یدّعون الایمان بالله والاسلام ویقولون فی نفس الوقت بوجوب عدم تقیید الحریة وان الحریة فوق الدین، إما انهم غافلون عن التناقض فی كلامهم وإما انهم على وعی بالامر ویخدعون الناس بنفاقهم وزیفهم.
ان حریات الانسان على نوعین هما:
1 ـ الحریة الفردیة والاخلاقیة.
2 ـ الحریة الاجتماعیة والحقوقیة.
وما یحدد الحریة فی كلا المجالین هی المصالح المادیة والمعنویة للفرد والمجتمع التی اوضحتها الاحكام الشرعیة. فمنطق الدین هو: من لم یشأ فله ان لا یؤمن، أما وقد آمن بالدین فعلیه الالتزام بالقوانین والحدود الالهیة ایضاً، وأمّا الایمان بالاسلام والعمل طبقاً للمذهب المادی واللیبرالی فانّهما لا یجتمعان أبداً.
لو ان الناس على وجه البسیطة جمیعاً كفروا بالله ودینه فانهم لا یضرّون الله شیئاً(1)، بل الضرر یلحق بالناس انفسهم. ولا منّة لنا على الله ودینه بل الله یمنّ علینا اذ هدانا لدینه ووفقنا للاسلام.(2)
وحیث اننا قد قبلنا الاسلام فلابد ان نقبل بالحریة فی اطار الدین، وما سوى ذلك لا نعتبره حرّیة بل هو حیوانیّة.
وفی الختام نضیف: ان الاجابة على اسئلة من قبیل: ما هی المصلحة؟ وما مدى
1. ابراهیم: 8
2. الحجرات: 17
سعتها؟ ومَن الذی یجب ان یحددها؟ تتفاوت باختلاف الثقافات. فسبیل الثقافة الاسلامیة تفترق عن سبیل الثقافة الالحادیة الغربیة، واذا ما اضحت المصالح المعنویة والروحیة للافراد بالاضافة الى النظام والامن والمصالح المادیة للفرد والمجتمع محدّدة للحریة فی ظل النظام الاسلامی، فلا مناص من ان تزداد دائرة الحریة فی الدین ضیقاً باضافة القید الثانی وتضاعف القیود. اذن لابد من معرفة ان الحقیقة تتمثل فی ان دائرة الحریات فی النظام الاسلامی اكثر ضیقاً منها فی الانظمة غیر الدینیة.
* * * * *
علاقة القانون بالحریة
سؤال: هل یمكن القول: اذا اخلَّ القانون بالحریات الفردیة فلا اعتبار له؟ او هل یمكن ان نقول بعبارة اخرى: ان الحریات الفردیة فوق القانون؟
جوابه: ان الاجابة على هذا التساؤل تختلف فی ضوء اختلاف الرؤى. فنظراً لان الغایة وفق الرؤیة اللیبرالیة لیست سوى التلذذ بالحیاة الدنیا، فلن تكون للقانون مهمة سوى توفیر اسباب اللذة، ولا دخل للقانون ما دامت لم تطرأ مضایقة لحریات الآخرین وشهواتهم، وفی ضوء ذلك سیكون للقانون دورٌ محدودٌ للغایة، وعلى الدولة ان تمارس ادنى مستوى من التدخل فی حیاة الناس، وبهذا یتبلور للعبارة المتقدمة معناها بان رعایة الحریات مقدّمة على القانون أو ان الحریات فوق القانون.
أما فی التصور الاسلامی فان القانون انما یرسم الخط الصحیح لحیاة البشر، ویقود المجتمع نحو مصالحه المادیة والمعنویة، من هنا فان على الحاكم الاسلامی ازالة العراقیل التی تحول دون تحقیق هذا الهدف.
فی ضوء ما تقدم ینبغی العلم ان القانون بوصفه «القضیة التی تحدّد الحق لفرد والتكلیف على الآخرین» لا یكتسب معنى إلا اذا كان الأفراد غیر أحرار فی القیام بأی فعل یریدونه، وفی غیر هذه الصورة فان الحدیث عن القانون والقانونیة سیكون عبثاً، فاذا ما أُرسی البناء فی المجتمع على ان یفعل كل امرئ ما یحلو له لم تعد ثمة حاجة للقانون.
وحتى هذه القضیة القائلة «ان لجمیع الناس الحق فی اختیار سكناهم بحریة» انما تعنی اثبات الحق لجمیع الناس من ناحیة واثبات التكلیف علیهم من ناحیة اخرى. وبتعبیر آخر: انما یتحقق حق اختیار السكنى للفرد عندما یحترم الآخرون هذا الحق، ویعتبرون انفسهم ملزمین باحترام حق هذا الفرد المخصص له، فلیس هنالك قانون
فی العالم یخلو من «الواجبات والممنوعات»، بل ان شأن القانون فی الاصل هو تقیید الحریة، فعندما یقال علیك ان تفعل كذا فذلك معناه ان لا تفعل ضدَّ ذلك العمل.
اذا ما صرح قانون بانه: «یجب ان لا تُقید ایة حریة»، فهذه العبارة بذاتها متناقضة «paradoxical» لان القانون هو ما یحدد الحریة، وهذا القانون یكون قد سلب حریة تقیید الحریة وقیّدها أی انه نقض نفسه. وبالامكان تصحیح الأمر وذلك بان نقرر حریات معینة أولاً ومن ثم نقول: یجب مراعاة هذه الحریات. وفی مثل هذه الحالة یصدق القول الاخیر وهو ان هذا القانون فوق سائر القوانین.
بناءً على هذا فالشعار القائل «لا یحق لأی قانون تقیید الحریات» اذا كان المراد به مطلق الحریة فهو یؤدی الى التناقض، واما اذا كان المراد به بعض الحریات فاننا نتساءل أیاً من الحریات تقصدون؟ فاذا اجابوا: الحریات المعقولة والمشروعة والقانونیة فاننا نتساءل ثانیة: مَن وأیّ قانون یجب ان یبیّن هذه الحریات المشروعة والمعقولة والقانونیة؟ هل هی الحریات التی شرَّعها الاسلام وأذِنَ بها؟ فاذا كان الجواب بالایجاب فذاك ما كان موجوداً فی النظام الاسلامی منذ بدایة قیامه، بل لا یمكن القول بما سوى ذلك فی ظل النظام القائم على الدین، واذا ما قلتم انها الحریات المتعارف علیها دولیاً أو الواردة فی الاعلان العالمی لحقوق الانسان، أو الواردة فی المذهب المادی واللیبرالی، فسوف نقول: ان بعضاً مما یُعدّ حریات مشروعة ومعقولة فی عالم الیوم أو اعلان حقوق الانسان أو المذهب المادی واللیبرالی یتناقض مع الاسلام والفكر الدینی من حیث المبنى والاصول ومن حیث البناء والنتیجة، ولا یمكن ان تحظى بقبول أی مسلم؛ وانما یمكن القبول فقط ببعض هذه الحریات التی لا تتناقض مع الاسلام، فلا یبقى مجال للیبرالیة باعتناق الاسلام، والعكس صحیح. وذلك لتناقضهما، ولهذا فان ارباب السیاسة فی امریكا والغرب یعتبرون النظام الاسلامی اكبر خطر وعدو بالنسبة لهم.
* * * * *
الحریة حق طبیعی للانسان
سؤال: ماذا یعنی هذا القول: الحریة من جملة حقوق البشر ولا یحق لأحد حرمان انسان من حقه الطبیعی؟
جوابه: كما تقدم التنویه، ان الكثیر من المفردات فی العلوم الانسانیة هی مفاهیم یتعذر تقدیم تعریف واضح ودقیق لها بحیث یفهمه الجمیع، ومن هذا القبیل تأتی مفردة «الحق» ومفردة «الطبیعی» ایضاً.
یعلمُ من لهم معرفة بفلسفة الحقوق ان من مذاهب فلسفة الحقوق مذهب الحقوق الطبیعیة، ویدلنا تاریخ الفلسفة على ان هناك أُناساً كانت لهم حوارات فی هذا المجال فی الماضی السحیق، فكان البعض فی الیونان القدیمة یعتقدون ان للبشر حقوقاً وهبتها الطبیعة لهم، ولا یحق لأحد سلبها منهم أبداً؛ لان الطبیعة الانسانیة تقتضیها هذه الحقوق، واستناداً الى ذلك استنتجوا نتائج غیر منسجمة فیما بینها فی بعض الاحیان مما ادى الى وقوع النزاعات والمجادلات، ومن بین المغالطات التی اشتهرت واثیرت على صعید فلسفة الحقوق وفلسفة الاخلاق وعرفت فیما بعد بمغالطة «الاتجاه الطبیعی».
لقد قال البعض ان الناس تتعدد طبائعهم، ومنهم مَنْ قال بتفاوت الطبائع بین السود والبیض، فالسود اشد بنیةً من البیض واضعف منهم تفكیراً، ومن ثم حصلوا على هذه النتیجة الخاطئة وهی: بما ان السود اشد بنیة فلابد ان یقوموا بالاعمال البدنیة فقط! وحیث ان البیض هم الاقوى من الناحیة الفكریة فلابد ان یتولوا مهمة ادارة المجتمع. اذن من الممكن القول ان بعض الناس خلقوا فقط لخدمة البعض الآخر، وبناءً على هذا فان الرّق قانون طبیعی.
لسنا هنا بصدد الرد على المغالطة الآنفة الذكر «الاتجاه الطبیعی» ونقد النظریتین
المذكورتین، لان ذلك مما یحتاج الى بحث اكثر تفصیلاً لا یسعه المجال الآن، بید ان اكثر الآراء اعتدالاً ومنطقیة قیل فی مجال الحقوق الطبیعیة على مر التاریخ هو: اذا ما اقتضت طبیعة الانسان شیئاً فیجب ان یتحقق ولا یُحرم الانسان مما تقتضیه طبیعته.
ونحن نعتقد ایضاً بوجوب تلبیة ما تقتضیه طبیعة البشر وما هو مشترك بینهم. وبالوسع تقدیم الادلة العقلیة التی تؤید هذا الأمر. بید ان السؤال الذی یتبادر عندئذ هو: ما هی مصادیق هذه الحقوق الطبیعیة؟
قالوا فی الاجابة: من الحقوق الطبیعیة: حق المأكل والملبس والمسكن والقول والنظر والاستماع وما شابه ذلك، أی لا یحق لأحد منع انسان من الاكل، أو منع غیره عن الحدیث؛ أو یعصب عیون انسان آخر لیمنعه من النظر، ولكن ما الدافع وراء اثارة مثل هذه المواضیع یا ترى؟ ولماذا وكیف جرى الاعتراف بمثل هذه الحقوق فی الاعلان العالمی لحقوق الانسان؟ وهل ان هذه الحقوق تعلو القانون ویجب ان لا تُقید، أم انهم وضعوا لها حدوداً فی كل بلد ومجتمع؟ وفی مثل هذه الحالة مَن الجهة أو القانون الذی یعین هذه الحدود؟
هذه اسئلة تُطرح الى جانب مجموعة اخرى من الاسئلة، ولما تزل طائفة من هذه الاسئلة دون جواب واضح مقنع للجمیع.
وخلاصة القول: ان اصل النظریة صحیح ولابد من تلبیة الحاجات الطبیعیة والغریزیة للبشر، بید ان الكلام كله یجری فی حدود هذه الحریات الموضوعة لها فی كل امة او قوم أو دین أو مذهب، ونحن بدورنا نرى ان حدود هذه الحریات هی «المصالح المادیة والمعنویة للافراد والمجتمع فی اطار القوانین الاسلامیة».
* * * * *
معنى الآیة «لا إِكْراهَ فِی الدِّینِ»
سؤال: ما معنى الآیة الكریمة: لا إِكْراهَ فِی الدِّینِ؟
جوابه: ان الایمان ثلاث شعب هی: الایمان بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالاحكام، بید ان الركن الاساس للدین هو الایمان القلبی والاعتقاد، من هنا لا یمكن ارغام ای انسان على اعتناق معتقد معین، فمعتقدات كل انسان تكمن فی صندوق عقله وقلبه الذی یتعذر على أی أحد الوصول الیه، ومغزى الآیة الكریمة بیان هذا الامر الواقعی والتكوینی المتمثل فی ان جوهرة الدین لیست مما یُفرض ویُملى.
ولكن هل یجوز الاجبار فی مرحلة الكلام والعمل أم لا؟ ینبغی تناول هذا الموضوع على مرحلتین هما:
أ ـ هل یمكن اجبار من لم یُسلم على اعتناق الاسلام أو الالتزام بالاحكام الدینیة؟
ب ـ هل یمكن ارغام المسلم على الالتزام بالاحكام الدینیة؟
حریٌّ القول فیما یخص الطائفة الاولى: ان الاسلام اعترف ببعض الادیان، منها على القدر المتیقن الیهودیة والمسیحیة والزراتشتیة التی یتسنى لأتباعها ان یعیشوا فی ظل الحكومة الاسلامیة بصفتهم من اهل الكتاب والذمة ووفق احكام خاصة. بل بمقدور الكفار ایضاً ان یعیشوا فی الدولة الاسلامیة ان كانوا من المعاهدین «ای ممن یلتزم بمعاهدة ومیثاق»، فالاسلام لا یأمر الیهودی أو الزراتشتی باقامة الصلاة أو الزواج وفقاً للاحكام الاسلامیة وغیر ذلك.
والفئة الثانیة من غیر المسلمین هم الكفار المحاربون والمعاندون الذین تجب محاربتهم اذا ما وقعت الحرب حتى یستسلموا.
أما فیما یتعلق بالطائفة الثانیة، فالنقاش یدور بین المسلمین حول: هل بوسع المسلم القول: أرید ان احتسی الخمر جهاراً فی الطرقات والازقة، أو العب القمار، أو لا ارغب فی ارتداء الحجاب الشرعی، أو التظاهر ضد الاسلام؟
لقد تصور البعض امكانیة تجویز مثل هذه الممارسات وذلك بالاستناد الى حق الحریة ویقولون مجادلین: أوَ لم یكن فی صدر الاسلام مَن كانوا ینكرون وجود الله مثل ابن ابی العوجاء؟ أَوَ لم ینسبوا المعصیة للامام المعصوم؟ أو لم یكفل الدستور هذه الحریات... الخ؟
والاجابة هی: كلا فالاسلام یتصدى للتجاهر بالفسق، فلیست حریة العمل والتعبیر عن الرأی غیر مقیدة فی الاسلام، فلا یمكن القیام بأی عمل أو اطلاق أی كلام فی ظل الحكومة الاسلامیة، فتشریع الامر بالمعروف والنهی عن المنكر انما جاء لمراعاة الحدود، وان من اسباب اقامة الحكومة فی الاسلام هو التصدی للمحرمات والمخالفات الشرعیة، ولقد اجاز الاسلام التدخل فی شؤون الآخرین وفرض القیود على الناس فی مواطن معینة والى حدٍّ ما بل أوجبها، وان الكلام برمته لیدور حول تعیین حدود الحریة.
والخلاصة ان الاسلام لا یسمح بمحاربة الدین والتآمر على النظام والتجاهر بالفسوق، وهو یرفض هذه الامور بكل شدة. والاسلام یجیز الرحمة والرأفة والمداراة والمسامحة فی محلها، فیما یجیز الشدة والغلظة والقوة والصلابة فی موضع آخر، ولا وجود فی الاسلام لصنم باسم الحریة والدیمقراطیة اعلى من الدین وافضل منه.
ان مستوى الدین فی الثقافة الغربیة بمستوى مجموعة من النصائح الاخلاقیة ومثلُه كتوصیات حكیم وواعظ یعمل بها بعض الناس ویتركها آخرون. فالعاصی هو یعلم بمعصیته والقسیس والكنیسة والله. وكما انه لا یُعتقل من یكذب أو یرتكب الغیبة، فكذا الأمر بالنسبة للخمّار ولاعب القمار والاباحی. لذلك اذا ما قیل
للمتبرجة: لماذا خرجت الى الزقاق والشارع بهذه الحالة؟ فانها تجیب: لا شأن لكم بذلك، كیف تسمحون لانفسكم التدخل فی شؤون الآخرین. وربما ینتهی الأمر للمرافعة والمحكمة.
وفی بلداننا الاسلامیة ومجتمعاتنا ینحو البعض شیئاً فشیئاً نحو هذه الرؤیة والحریة. بینما ان هناك بوناً شاسعاً بین مجتمعنا والمجتمع الغربی وبین الاسلام والمسیحیة المتبناة لدیهم، فكما تقدم قوله بالاضافة الى فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر والرقابة العامة فی الاسلام، فان على الدولة التصدی للتجاهر بالفسوق وانتهاك الحرمات، ولا یفوتنا القول ان هذا الكلام یجری عندما یرتكب امرؤ المخالفة علناً امام الآخرین ووسط المجتمع، والاّ اذا ما ارتكب شخص محرماً وكان متخفّیاً فلا یجوز للآخرین التحری والتنقیب، ولیس لهم البوح بالاسرار فی حالة معرفتهم بالامر، لان اسرار الناس محترمة: وان حرمة التجسس على حیاة الآخرین وعدم التدخل فیها انما تخص مثل هذه الحالات. بناءً على هذا لا تناقض بین الامر بالمعروف والنهی عن المنكر وبین عدم التجسس على الحیاة الخاصة للآخرین، لان مجال الحكم الاول هو ارتكاب المخالفة امام الآخرین، ومجال الحكم الثانی هو ارتكاب المخالفة فی الخفاء وبعیداً عن انظار الآخرین.
* * * * *
اللیبرالیة واصوله
سؤال: ماذا تعنی اللیبرالیة؟ وما هی اصول المذهب اللیبرالی؟
جوابه: كما تقدم ذكره ان المفاهیم تقسم الى طائفتین انضمامیة وانتزاعیة، وان فهم الموضوعات ذات الصلة بالمفاهیم الانتزاعیة امرٌ صعبٌ. واحدى المفردات الغامضة والانتزاعیة ذات الصلة بدائرة العلوم الانسانیة هی مفردة اللیبرالیة، ومن الطبیعی ان الغموض سیلف هذه الكلمة لوجود الغموض والاجمال فی مفهوم الحریة؛ مثلما تسری القدسیة والمحبوبیة التی تتمیز بها الحریة الیها، ولكن ماذا تعنی الحریة والمطالبة بالحریة یا ترى؟ فهل المراد هو الحریة السیاسیة أم الاقتصادیة أم الاجتماعیة أم ما هو اعم من هذه الموارد؟
ما یمكن قوله بایجاز هنا هو ان كلمة «الحرّ» استخدمت لغةً بمعان شتى، فتارة تستخدم بمعنى یقابل العبد؛ واخرى بمعنى «المتنور» وثالثة بمعنى «السخی» ورابعة بمعنى «الطائش والمتحلل». أما اصطلاحاً فهی تطلق على طریقة التفكیر المستخدمة فی المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والدینیة، وهی تعتمد اساساً فی طبیعتها على المزید من الاهتمام بالحقوق الطبیعیة للافراد.
اذا ما قیل «اللیبرالیة السیاسیة» فان المراد هی السیاسة التی یتم فیها ایلاء حقوق الافراد وحریتهم فی الشؤون السیاسیة ما امكن من الاهتمام، واللیبرالیة الاقتصادیة اشارة للاقتصاد الذی یُعتمد فیه على الفرد وحریة الافراد فی نشاطهم الاقتصادی، ووجوب ان یكون للدولة الحد الادنى من التدخل فی نشاطات الافراد، وهكذا اللیبرالیة الثقافیة والدینیة... الخ.
ان لهذا المذهب الذی ظهر لاول مرة عام 1850 م فی انجلترا كحزب سیاسی، اصوله وخصائصه نشیر الى بعضها بایجاز:
اولاً: الفردیة: وهی من الخصائص البارزة للیبرالیة، فالفرد وحقوقه مرجحٌ على كل شیء فی هذا المذهب، واذا ما اقیمت حكومة فلابد ان تكرس لتلبیة رغبات افراد المجتمع، وان المفاهیم الجماعیة من قبیل «مصلحة المجتمع» فهی تعدّ وهماً، فكلّ امرئ یعرف مصلحته الشخصیة افضل من الآخرین، واذا ما سعى الجمیع نحو خیرهم وصالحهم فسیصل المجتمع فی خاتمة المطاف الى الخیر. ولا وجود لدینا لأی خیر مطلق أو فضیلة حتى نحاول على أساسها التدخل فی الحیاة الخاصة للناس، ولا حقَّ للدین والاخلاق والدولة والمصلحین والمفكرین فی اصدار الاوامر والتعالیم للافراد، فالمهم «أنا» ورغباتی وتشخیصی والظروف التی استطیع عن خلالها بلوغ تطلعاتی على احسن وجه.
ثانیاً: القیمة المطلقة للحریة: والمراد من القیمة المطلقة هی تلك القیمة التی تعلو كافة القیم ولا مجال للتغاضی عنها من اجل أیة قیمة اخرى من قبیل العدالة الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو المحافظة على كیان الاسرة والاخلاق. اذ یصرح اللیبرالیون بان التحلل الجنسی وانهیار الكیان الأُسری والانحطاط الاخلاقی وسائر المفاسد التی تشهدها اغلب المجتمعات البشریة المعاصرة ما هی الاّ ضریبة وثمن یدفعه الانسان للمحافظة على القیمة الأسمى وهی الحریة.
ان الحد الوحید للحریة فی نظر اللیبرالیین هو حریة الأفراد الآخرین، وبعبارة اخرى: ان المبضع الوحید الذی باستطاعته ان یقطع الحریة هو الحریة نفسها، فاذا ما اتفقت حریة الطرف المقابل لك مع رغبتك اذ ذاك یجوز كل تصرف ولم تعد هنالك اهمیة للرجل والمرأة والزوج والغریب والاجنبی والصدیق، ولله والدین والاخلاق والانصاف والعقل والانسانیة، فالمهم ما تصبو الیه رغبتی وانا حرّ فی تلبیتها.
ثالثاً: انسجام الرأسمالیة مع المادیة: لقد عُجنت اللیبرالیة مع الرأسمالیة واقتصاد السوق الحر بنحو اعتقد فیه الكثیر من المفكرین ـ ونخصّ بالذكر الیساریین ـ ان اللیبرالیة هی ایدیولوجیا الرأسمالیة.
رابعاً: محوریة الانسان: ترى اللیبرالیة وبعض المذاهب الحدیثة فی الغرب من قبیل الشیوعیة والاشتراكیة ان الانسان هو محور الكون، وفی ضوء الرؤیة المادیة لهذه المذاهب ازاء العالم فان الانسان هو الاصل، ولهذا فان المهم والاصل فی سنّ القوانین ورسم الخطوط العامة للسیاسة والاقتصاد والثقافة هی رؤیة الانسان وارادته، على العكس من الادیان الالهیة والتوحیدیة التی تؤمن بمحوریة الله وتعتبر الخالق هو المشرّع الاساسی، وتقول بالبعد المعنوی والروحی والالهی للانسان بالاضافة الى البعد المادی، اذ ان قوام الانسانیة هو هذا البعد الروحی له.
وهنالك امور اخرى من قبیل العلمانیة والفصل بین الدین والدنیا وتبنی التسامح والتساهل وما شابهها یمكن اعتبارها من تفرعات المحاور الاساسیة للیبرالیة.
* * * * *
التحدیات بین الاسلام واللیبرالیة
سؤال: ما هی المواطن الجوهریة للاختلاف والتحدی بین الاسلام واللیبرالیة؟
جوابه: هنالك عدة مواطن جوهریة للاختلاف بین الاسلام واللیبرالیة، وبعض الاختلافات لا تقتصر على اللیبرالیة، بل ان سائر الافكار التی تشترك مع اللیبرالیة لا تتفق اساساً مع الدین فی هذه النقاط، ونشیر هنا بشكل مفهرس الى بعض الحالات:
أولاً: من المواطن الرئیسیة للتحدی بین الاسلام واللیبرالیة هی قضیة الحریة، فاللیبرالیة ـ وكما تقدم ـ تقول بالقیمة المطلقة للحریة، واستناداً لمذهب الحقوق الطبیعیة فانها تجعل الاصالة لحق الحیاة وحق الحریة وحق المالكیة، اذ یتعین على الناس جمیعاً وكذلك الدولة احترامها وتجنب المساس بها.
غیر ان الحریة لیست قیمة مطلقة فی الاسلام، بل القیمة المطلقة هی الطاعة والامتثال للاحكام الالهیة، فعلى الانسان الامتثال فی كل مورد یقر الله تعالى فیه الحریة أو یشخص تقییدها فی حیز أو دائرة، فالحریات فی الاسلام مقیدة بالحدود الالهیة، فتارة یحرّم ویحظر التعبیر عن المعتقد ویعتبر توجیه الاهانة للمقدسات الدینیة والنبی(صلى الله علیه وآله)والائمة المعصومین(علیهم السلام)مستحقاً لأشدّ العقوبات، واخرى یضیق على حریة القلم والتعبیر ولا یسمح ببیع او شراء بعض الكتب، ویحدّ بواسطة القانون من الحریة الجنسیة، بل ویحد من حریة الاكل واللباس والتردد والبصر والسمع... الخ، فدائرة القانون والحریة فی اللیبرالیة هی مراعاة المصالح المادیة ـ على اساس محوریة الانسان والمادیة ـ بید ان دائرة الحریة فی الاسلام هی مراعاة المصالح المادیة والمعنویة جمیعاً.
ثانیاً: نقطة الاختلاف الثانیة هی ان اللیبرالیة وبعض المذاهب الاخرى ترى محدودیة الانسان بـ «الأنا» الطبیعیة، فلقد دفعت محوریة الانسان والمادیة
باللیبرالیة الى ان تهتم بالبعد المادی والحقوق الطبیعیة للانسان وهی: الحیاة، والحریة، والمالكیة، فلیس الانسان سوى مجموعة من الغرائز والرغبات المادیة والحیوانیة، والانسان هو الذی یصنع القیم ویسنّ القوانین ویقرر مصیره، وعلى الاخلاق والدین وسائر القیم ان تتلاءم هی مع الانسان ولیس العكس.
لم یرد التصریح فی هذه المذاهب بالنهی عن السعی وراء الدین والآخرة، لكنهم یقولون لا شأن لنا بها وهم لا یلتفتون الى المعنویات والدین فی مختلف مجالات الحیاة، وبالتالی یتم تهمیش الدین لا محالة وتكون العلمانیة ـ فصل الدین عن الدنیا وعن السیاسة والاقتصاد والاجتماع ـ ولیداً مشؤوماً لمثل هذا النمط من التفكیر.
أما فی الاسلام فان الانسان ذو بعدین مادی ومعنوی، والاصالة للروح والمعنویات، والبدن المادی حامل ومركب للانسان الحقیقی. فالانسان بلا معنویات ولا اخلاق ولا دین ولا التزام بالخالق والمعبود لیس انساناً بالمرّة، وانما هو حیوان ذو رجلین كسائر الحیوانات بل اسوء منها. وبالتالی فهو ـ الاسلام ـ یجعل الاصالة فی كافة الشؤون الانسانیة ـ الاقتصاد والسیاسة والثقافة والفن... الخ ـ للمعنویات، و«الانا» الحقیقیة والروحیة یتخذها ملاكاً، وینزل بالدین الى ساحة الدنیا والمجتمع.
ثالثاً: لا حدود فی الفكر اللیبرالی لحریة التعبیر والفكر لانها لن تؤدی الى سلب حریة التعبیر عن الآخر، وذلك لعدم احتكاك تفكیرنا وكلامنا بالحقوق المادیة للآخرین، اذن فبامكاننا ان نقول ونعبّر عمّا نشاء.
أما حریة التعبیر فی الفكر الالهی والدینی فهی محدودة، فكما تقدمت الاشارة الیه فان الاسلام یحرّم كتابة او تناول بعض الموضوعات ویحظر اقتناء وبیع المؤلفات المضلّة، والاساءة للمقدسات الدینیة والمعصومین الاربعة عشر(علیهم السلام)أشدّ خطیئة فی الاسلام من التعرض لاموال الناس ونوامیسهم وارواحهم، لذلك یتعین التصدی لها ومعاقبة مرتكبها. فمن الامور التی نختلف فیها مع الغربیین الآن هی قضیة اساءة سلمان رشدی للمقدسات الدینیة. ومنشؤ الاختلاف فی هذه الامور
یعود الى هذین النمطین من التفكیر والرؤیة للانسان والحریات القانونیة. ناهیك عن ان امتهان الاشخاص والافراد یعد جرماً یستحق التعقیب حتى فی الفكر اللیبرالی والغربی ایضاً فما بالك بتوجیه الاهانة لطائفة كبرى وافكارها.
رابعاً: ان حق التقنین فی الاسلام مختص بالله سبحانه، أما فی الفكر اللیبرالی فان الناس والبشر هم الذین یضفون الاعتبار على القوانین. ان الاسلام یشدد على المزید من القانون والهدایة فی جمیع الشؤون الانسانیة وله تعالیمه ایضاً حتى فیما یتعلق بالنظافة وحلاقة الرأس والذقن والاكل والنوم وكذلك فیما یخص الافكار والخواطر الذهنیة، اما اللیبرالیة فهی تدعو الى الحد الادنى من القانون وتصرح بان یكون سنّ القوانین عند الضرورة فحسب، واللیبرالیة تؤكد على ان حق التقنین هو للناس وغالبیة المجتمع. عن أی طریق؟ عن طریق السلطات الثلاث. وهل بامكانهم سنّ أی قانون شاؤوا؟ كلا. یجب ان تكون القوانین فی اطار دستور البلاد. وهل للدستور أن یتضمن ای قانون كان ویتم اكماله عن ای طریق كان؟ كلا فلابد ان یجری العمل فی اطار الاعلان العالمی لحقوق الانسان. وما هی كیفیة اعتبار الاعلان العالمی لحقوق لانسان؟ انه فی ضوء مصادقة مندوبی الدول، ولكن ما هو تكلیف الافراد والمجتمعات المعارضة لهذا القانون أو البلدان التی لم تصادق علیه؟ وأی حق یمتلكه البعض فی سنّ القوانین للآخرین؟ وهنا ینقطع الكلام ویأتی الجواب حاسماً وهو لیس سوى اتباع الاكثریة والدیمقراطیة.
وفی الاسلام فان اصل اعتبار القوانین یعود الى المالك الحقیقی للمخلوقات، وهو الذی یمتلك الحق فی وضع القوانین فی كافة شؤون الحیاة، ولا یعود هنالك مجال للسؤال.
خامساً: ترى اللیبرالیة ان الدولة المنشودة هی تلك التی تدافع عن الاُطر العامة للحیاة الاجتماعیة، فالدولة یجب ان تتولى نشر الرفاهیة وان تمارس الحد الادنى من التدخل فی شؤون الناس، واستناداً الى فكرة اصالة الفرد یجب ان تقلل من
القوانین الاجتماعیة الى ادنى مستویاتها، وان توفّر المزید من الحریات الفردیة، ومسؤولیة الدولة هی توفیر النظم والأمان لیتمتع الافراد بالمزید من الرفاهیة واللذائذ المادیة.
بید ان الدولة فی الفكر الاسلامی یجب ان تكون موفرة للرفاهیة وناشرة للفضیلة ایضاً. فهی تحافظ على ارواح الناس وممتلكاتهم ونوامیسهم، وتعمل ایضاً على الارتقاء بمعنویات الفرد والمجتمع واخلاقه، واذا ما حصل تزاحمٌ فان حقوق المجتمع تُقدّم على حقوق الفرد، وللفضیلة الاولویة على الرفاه والمادیة. فواجب الحكومة الاسلامیة هو هدایة المجتمع نحو المصالح المادیة والمعنویة.
تأملوا ـ على سبیل المثال ـ ان الاسلام لا یسمح حتى للاقلیات الدینیة واهل الذمة ان یقترفوا المحرمات جهاراً فی المجتمع كأن یشربوا علناً الخمر مثلاً. أو انه لا یسمح خلال أیام شهر رمضان المبارك سواءً للمسلمین أو غیرهم، للأصحاء أو المرضى، للمعذورین وغیرهم، بتناول الطعام امام الملأ العام وبمرأى من الآخرین، وان الحكومة الاسلامیة ملزمة بالتصدی لهذه الحالات والحیلولة دون وقوعها.
سادساً: ان من لوازم الفكر اللیبرالی هو التسامح والتساهل فی شتى المواقف، بالرغم من عدم عمل الدول الغربیة بهذا الاتجاه، فالملتزمون بالدین والمعنویات والاخلاق والاحكام الالهیة یتعرضون للادانة وهم محرومون من بعض الحقوق فی المجتمعات المتحضرة!
ان الاسلام وان كان شریعة سمحة سهلة، لكنه یقر المداراة فی اطار الاحكام الالهیة، ویوجه توبیخه للذین لا یلتزمون بالحدود الالهیة، ویتعامل بالشدة والغلظة فی بعض الموارد، حتى انه لا یسمح لاهل الكتاب بأی نشاط یتنافى مع الدین، مثلما لا یجوز للمسلمین ایضاً القیام بما شاؤوا وسط المجتمع.
وبهذا نجد ان الفكر الاسلامی یختلف مع الفكر اللیبرالی اختلافاً قدره 180 درجة، وانهما لا یجتمعان بأی حال من الاحوال. لكن مما یؤسف له هو تسلّل
الاصول والقیم الغربیة الى المجتمعات الاسلامیة ومن بینها بلادنا، بالاضافة الى الغرب، مما ادى الى حصول الترقیع الفكری، لاسیما فی اوساط الطبقات المثقفة، بل وحتى لدى بعض المسؤولین والخواص، ولابد من التحلی بالمزید من التعمق فی الافكار والقیم الاسلامیة الاصیلة لاستئصال هذه الشوائب.
* * * * *
حریة التعبیر
سؤال: هل ان حریة التعبیر مطلقة أم محدودة؟ وهل یُمكن منع أحد عن الكلام وهل یصح سماع أی كلام؟ وهل یجوز شراء أو قراءة أی كتاب أو مقالة؟
جوابه: لقد طرح فی سالف الازمان ان الافراد یتمتعون فی المجتمعات الدیمقراطیة بحقوق وحریات، ولیس لأی قانون ان یسلب هذه الحریات، وهذا الامر الذی جرى تدوینه فی الاعلان العالمی لحقوق الانسان فیما بعد انما یعتبر امثال هذه الحریات فوق القانون وان انتهاك أىّ منها انتهاكٌ لحقوق الانسان.
من معالم البلدان الدیمقراطیة ان المواطنین فیها یتمتعون بحریة التعبیر. وللناس حق الاحتجاج على الحكومة أو الحزب الحاكم أو مطبقی القانون أو المقننین أو أی شخص آخر، والتعبیر عمّا یرتضونه ویرونه صحیحاً. وفی بلادنا ایضاً یعتقد البعض ـ وتماشیاً مع مثل هذه الرؤیة ـ ان بلادنا بلد حرّ ویدار وفقاً للاسلوب الدیمقراطی، اذن لابد ان تُحفظ لنا هذه الحریات، وعلیه یجب ان یكون للشعب الحق فی ان یتحدّثوا بما شاؤوا مع أیٍّ كان، والتعبیر عن احتجاجهم بأی نحو شاؤوا.
ولكن هل یقر الاسلام والنظام الاسلامی مثل هذه الرؤیة فی حریة كل انسان بالتعبیر عما یرید وبأی اسلوب كان؟ وهل یمكن اطلاق أی كلام وسط أی تجمع، أو أن یوضع بین أیدی الآخرین أی مؤلَّف لیطالعوه؟ أم ان بعض الكلام ممنوع؟
یعلم الجمیع ان لا معنى ولا امكانیة للحریة المطلقة التی لا تعرف الحدود، وان لحریة العمل والتعبیر والحریات الاجتماعیة والسیاسیة حدودها على أیة حال. ونحن نعتقد ان حدود الحریة تتمثل فی المصالح الحقیقیة للمجتمع سواءً أكانت مادیة أم معنویة، واذا كان هنالك فعلٌ مخالف لقوانین الاسلام فلن یكون حراً ابداً. غیر ان حریة أی شخص فی الغرب محدودة بحریة الآخرین، أی بامكان أی امرئ
فعل ما شاء شریطة ان لا یضایق حریة الآخرین، ومن الواضح ان هذین المنطلقین مختلفان فیما بینهما ولا یمكن الجمع بینهما.
ان للكلام والسماع والقراءة وسائر النشاطات احكامها فی الاسلام، فلا یمكن التفوه بكل شیء أو الاستماع الیه، فلا یجوز ـ مثلاً ـ اطلاق الغیبة أو التهمة أو افشاء اسرار الناس، مثلما لا یجوز طباعة ونشر وبیع وشراء الموضوعات المضللة، وقد ورد فی موضوع المكاسب المحرمة فی المصادر الفقهیة بانه یحرم شراء وبیع الكتب الضالة، أی یتعین عدم شراء الكتب التی تتضمن موضوعات من شأنها ان تسبب انحرافاً فكریاً لدى القارئ ناهیك عن قراءتها أو نقلها للآخرین.
والاسوء من ذلك ان ینبری من یعیش فی بلد اسلامی ـ ومن خلال كتاب أو مقالة أو نشرة أو جریدة ـ للتبلیغ ضد الاسلام والقوانین الالهیة والمقدسات الدینیة أو توجیه الاهانة الیها أو التهكم والاستهزاء بالاحكام الاسلامیة، فمن المسلّم به ان هذا الفعل حرام ومنكر یتعین النهی عنه ومنعه، ویجب على المسلمین التصدی له بالقول والتذكیر أولاً وبتقدیم الشكوى الى الدولة والدوائر القضائیة فی المرحلة اللاحقة لتتخذ الاجراءات الجادة فی مواجهة هذه الممارسات.
من اهم واجبات الدولة الاسلامیة ایضاً التصدی للتحركات المنافیة للاسلام وللمنكرات فی مختلف الاصعدة الثقافیة والصحفیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة حفاظاً على المصالح المادیة والمعنویة والاخلاقیة للمواطنین وللمسلمین. وان القرآن الكریم اكثر من ای مصدر اسلامی آخر یحدد مسؤولیة المسلمین ازاء الكلام الذی یصدر منافیاً للاسلام واحكامه اذ یقول: «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَیْكُمْ فِی الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللّهِ یُكْفَرُ بِها وَیُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى یَخُوضُوا فِی حَدِیث غَیْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جامِعُ الْمُنافِقِینَ وَالْكافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعاً»(1).
1. النساء: 140
ان القرآن یحذر أن یا ایها المسلم! انك اذا ما جالستَ الكافرین والمستهزئین بآیات الله واحكامه واستمعت لحدیثهم، فاعلم ان ایمانك سیضمحل شیئاً فشیئاً وانك ستنضم الى صفوف الكافرین والمنافقین، وذلك لندرة ذوی الایمان الرصین من قبیل سلمان وابی ذر، وان ضعاف الایمان یتعرضون على الدوام لتضییع وفقدان ایمانهم.
ما نستنتجه من هذه الآیة هو عدم الجلوس عند أی حدیث، بل ینبغی عدم مجالسة أیٍّ كان، فلا یصح ولا ینبغی الإدلاء بأی كلام فی أی محفل، ولا ینبغی كتابة أو قراءة أی موضوع لاسیما فی الاوساط العامة وعلى مستوى الصحف والمجلات ووسائل الاعلام العامة.
ربما یتبادر السؤال هنا: أوَ لم یحث القرآن بالذات على الاستماع الى الكلام وان كان معارضاً ثم انتخاب الاحسن منه: «... فَبَشِّرْ عِبادِ * الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...»(1) أوَ لا ینبغی الاستماع لما یقوله مختلف الناس والتحقیق فیه والرد علیه ومعرفة نقاط القوة من نقاط الضعف فیه؟ أوَ لم یُدلِ المخالفون فی صدر الاسلام وفی عهد الائمة(علیهم السلام)بكلامهم الذی یعج كفراً؟
حری القول فی معرض الاجابة: ان الاسلام والقرآن لم ینه بشكل عام عن الحدیث المشحون كفراً وخطأً، وهو یسمح بالتطرق لبعضها وفق شروط، ولكننا نستطیع الاستماع للكلام الموافق والمخالف والاشكالات التی تثار حول اصل الدین واحكامه ومعارفه القطعیة أو نستطیع قراءتها عندما تكون لنا القدرة على تشخیص احسن القول لنتبعه لاحقاً؛ وبتعبیر آخر أن تكون لنا القدرة على تمییز الاحسن من بین الاقوال والرؤى وذلك نتیجة لامتلاكنا للمعلومات الكافیة عن ابعاد الدین على اختلافها وكذلك المعرفة لمنهجیة الاستدلالات ومضمونها والاحاطة بالمغالطات التی ربما یتم التشبث بها. وینبغی السماح بالتطرق للقضایا المنافیة للدین فی محضر الذین لا یتمتعون بالقدرة الكافیة للنقد والتحلیل عندما یكون الرد علیها ونقدها جاهزاً معها أیضاً.
1. الزمر: 17 و18.
وفی هذا المجال لا قیود تحدد النبی والائمة الطاهرین وعلماء الدین وبوسعهم ـ بل یجب علیهم ـ الاستماع للقول المخالف وأدلته وقراءته ومن ثم دراسته ونقده. أما فی مخاطبة الذین لا طاقة لهم على المجابهة أو لم تتوفر لدیهم هذه المقدرة بعد، فالقرآن الكریم ینصح بان لا یدخل مَنْ كان خفیفاً فی وزنه حلبة الصراع مع بطل العالم، وبالرغم من عدم وجود اشكال فی أصل مباراة المصارعة غیر أن كل عاقل یُقر بأن تجری المباراة بین مصارعَین من وزن واحد ومتساویین فی القابلیة، وإن خطر التباری بین مصارع من الوزن الخفیف وآخر من الوزن الثقیل إنما یأتی من انه یؤدی الى إیذاء احدهما وفنائه.
إن الاسلام یأمرنا أن اذا أردتم الدخول فی النقاشات الفكریة والدینیة والعقائدیة فعلیكم أولاً بترصین ایمانكم وترسیخ مرتكزاتكم العقائدیة والعملیة والنزول الى حلبة السباق بعد توفیر الظروف الضروریة للنزال، وأن لا تكتفوا هنا بالمنازلة بل علیكم بتحدّی الخصم ودعوته للمناظرة والنقاش.
* * * * *
إن الذین یعوزهم النضج الضروری للنقاشات الفكریة یتصورون حداثة وصواب كل حدیث یتمیز بأسلوبه الأدبی والمنمق، وربما یصدقون كلاماً متناقضاً تماماً، ونتیجة لفقدانهم القدرة الكافیة على التشخیص فانهم یرون انسجام كل بناء مع أی مبنىً. ولكن اذا ما جرى الحدیث أمام مَن یتمیزون بنضجهم والمفكرین والعلماء واصحاب الفن فانه عندئذ یجری النقد والتحلیل ویُعرف الغث من السمین. وبشكل عام إذا ما طُرحت النظریات والآراء الخاصة بأی علم أمام العلماء والمتضلعین فی ذلك العلم فسوف یسهل نقدها ودراستها؛ وحینها تتجلى القیمة الحقیقیة لأی كلام. فعلى سبیل المثال عندما تبحث النظریات المتعلقة بالفیزیاء والكیمیاء بین علماء الفیزیاء والكیمیاء، والآراء الفلسفیة والمنطقیة بین الفلاسفة والمناطقة، والمسائل والشبهات الدینیة والكلامیة بین علماء الدین إذ ذاك ستتجلى ماهیتها وقیمتها الواقعیة وستحتلّ المنزلة التی تناسبها.
أسس حریة التعبیر والصحافة
سؤال: ما هی أسس حریة التعبیر والصحافة فی الاسلام؟
جوابه: إن موضوع حریة القلم والصحافة من الموضوعات المهمة المتعلقة بحقوق الانسان بالنسبة للانسان المعاصر، وفی عصر التطور المذهل الذی شهدته الاتصالات یتعین إیلاء فائق الاهتمام لهذا الامر المهم. وكما تقدمت الاشارة فی المواضیع السابقة فإن الحریة أمر مقدس ومنشود بالنسبة لكافة البشر، بید أن أی عاقل لا یقر الحریة المطلقة وذلك لتلازمها مع الفوضى والفساد والهمجیة، ومن الطبیعی ان للحریة ومن بینها حریة التعبیر والقلم شروطاً وقیوداً. إذن علینا أن نوضح على أی أساس یجب المناداة بالحریة؟ والجواب بالایجاز هو: ذاك ما یجب أن یحدده القانون، ومباشرة یتبادر هنا سؤال آخر وهو: على أىّ شیء یستند المقنن فی تقییده للحریة؟
یمكن القول هنا باختصار: إن القانون یجب أن یُحدد فی ضوء مصالح المجتمع، بید أن هذا كلام كلی أیضاً، ویبقى السؤال قائماً فما مصالح المجتمع التی تؤدی الى تحدید الحریات؟
لو تأملنا الاختلافات القائمة فی هذا الصدد فسنجد أن النظریات على اختلافها فیما یخص الحریة وحدودها والمصالح الحقیقیة للفرد والمجتمع انما تعود لاختلافین اساسیین هما:
أ ـ الاختلاف المبنائی
ب ـ الاختلاف البنائی
والاختلاف المبنائی ینشأ عن اختلاف الناس فی ثقافتهم ورؤیتهم الكونیة، فالذین یعتقدون بأن الهدف من خلق الانسان هو الاستمتاع اكثر بلذات الدنیا ولیس
هنالك حساب بعد هذا العالم، لا یرون للحریة قیداً ولا حدوداً، الاّ أن تمس مقومات اللذة لدى الاغلبیة من الناس والمجتمع، أی أن حدود الحریة تتمثل فی اعاقتها لحریة الناس والمجتمع.
أما الذین یؤمنون بالیوم الآخر والقیامة ویقرون بوجود المتع الروحیة والمعنویة بالاضافة إلى اللذائذ الدنیویة بل هی أسمى منها ویقولون بأن لسلوك الانسان تأثیراً فی سعادته أو شقائه الأبدی، فهم لا محالة یؤمنون بأن الحریة ممدوحة ومباحة ما لم تمس سعادة الانسان الأبدیة بسوء.
وما لم تُحل هذه الاختلافات المبنائیة التی تدور حول الله والقیامة والسعادة الحقیقیة للبشر وعوالم الوجود فمن المتعذر الوصول إلى نتیجة مشتركة، وسیفترق طریقنا بشكل تام عن مخالفینا ونقف على طرفی نقیض.
أما الإختلاف البنائی فإن المراد به الإختلاف الذی یحصل بعد الاتفاق على وجود الله والقیامة والدین والحساب ثمّ یكون الاختلاف حول ما هی الأمور التی من شأنها توفیر مصالح المجتمع وما هی الأمور التی تؤدی الى تنامی المفاسد واتساعها فی المجتمع.
هنالك أناسٌ یقولون اننا نؤمن ایماناً قاطعاً بالعقائد الاسلامیة المسلّمة؛ ولكن إذا ما فقدت حریة التعبیر والقلم فی الظروف الراهنة وفی عصر التقدم وتطور الاتصالات فلا ینال البشر الرقی التام، ولا یتم دراسة الامور السیاسیة والاجتماعیة والعقائدیة على أحسن وجه، ولا یُكشف عن نقاط الضعف والقوة فی النظریات. فلابد من أن تكون حریة التعبیر والصحافة واسعة وقلیلة القیود والشروط أو لا حدود لها لیبلغ الناس الرقی وینتخبوا الأصلح.
وفی المقابل هناك آخرون یعتقدون: أن أبناء المجتمع على فئتین: فالبعض محصنون إزاء الشبهات والإثارات المنحرفة والمنافیة للدین والمصالح الحقیقیة للبشر، لذلك فهم لا یتأثرون بالمفاسد، فلا اشكال بالنسبة لمثل هؤلاء فی الاستماع
لأقوال المخالفین أو قراءتها، بل هی ضروریة وواجبة على البعض فی بعض الحالات.
الفئة الثانیة وهی التی تشكل غالبیة المجتمع وهم الذین یتأثرون بالشبهات والموضوعات الضالة وربما الكافرة اذا ما أثیرت بأسلوب وطریقة خاصة وعلى ألسن أناس معینین، لاسیما اذا كانت الشبهة یسیرة الفهم ولم یتم الرد على تلك الشبهة فی حدیث أو مقال أو كتاب... الخ بسرعة وبصورة جیدة. اذن مصلحة المجتمع تستدعی أن تقید حریة التعبیر والقلم بنحو لا تنتهی معه إلى إصابة الناس والمجتمع بالإنحراف الفكری والأخلاقی. وهذا الاختلاف فی البناء والمصداق وتشخیص أوضاع المجتمع وابنائه.
إن الاختلاف المبنائی لا یسهل علاجه دون حل القضایا الأساسیة فی الرؤیة الكونیة والدین، أما الاختلاف البنائی فهو مما یسهل حلّه من خلال الحوار والتفاهم والدقة فی المبانی.
ما یبدو صحیحاً هو أننا جرّبنا بوضوح أن إیراد الموضوعات الضالّة والمشبوهة بالكفر لا یصب فی صالح المجتمع إن طرحت بأی شكل وبین أی جمع كان؛ وكثیرون قد انجرفوا نحو الضلال والانحراف والفساد عن هذا الطریق، فبعض الشبهات ذات طابع بحیث یمكن إثارتها بقوة وبأسلوب معقول وتزویقها بهالة ادبیة أو سقریة أو قصصیة لتترك تأثیرها على المخاطَب، وقد ورد هذا الأمر فی القرآن الكریم وتمت تسمیة هؤلاء الناس بـ «شیاطین الانس»، اذ یقول تعالى فی الآیة 112 من سورة الأنعام «یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلى بَعْض زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً».
إذن، فی ضوء التجارب السابقة وطبائع البشر وما أكده علم النفس الاجتماعی واستناداً للتعالیم الاسلامیة، یمكن القول: ان أی مقال أو مؤلَّف من شأنه الاضرار بأبناء المجتمع ویؤدی الى انحرافهم ـ سواءً كان حدیثاً أو مقالة أو صحیفة أو كتاباً او فیلماً... الخ ـ فهو لیس مباحاً فی الاسلام.
والأمر الآخر الذی ینبغی الإنتباه الیه هو ان ثمة تكلیفاً ملقىً على عاتق الصحافة والكتّاب فی قبال الحق الذی یتمتعون به فیما یتعلق بالمصالح المادیة والمعنویة للمجتمع، اذ یتعین علیهم حسن تناول الموضوعات الضروریة والعقائدیة التی یتوقف علیها مصالح المجتمع وبیانها لتتضاءل مقومات انحراف الناس، ومن ثم تأخذ طریقها للزوال، وإن الارتقاء بمستوى وعی أبناء المجتمع وتحصینهم إزاء الشبهات وإثارة الأسئلة الدینیة مقرونة بالنقد والدراسة والجواب علیها تعد من واجبات الكتّاب والبلغاء واصحاب القلم والبیان فی زماننا وفی أی زمان آخر.
والنتیجة هی حری القول فیما یخص حریة التعبیر والقلم: ان ما یكفل المنفعة التی یستحقها المجتمع یجب قوله وكتابته؛ وما هو مضر ویهدم المصالح العامة للمجتمع فهو ممنوع، واَما غیر هذین فهو مباح وجائز.
* * * * *
قانون الصحافة والمخالفات الصحفیة
سؤال: هل للصحافة وما یسطره القلم حكمٌ فی الاسلام یختلف عن حكم ما یصدر عن الانسان من أقوال؟ وهل ان وضع الصحافة غامضٌ فی القانون؟ وما هی المشكلة الأساسیة فی التعامل مع المخالفات الصحفیة؟
جوابه: لإیضاح وضع الصحافة فی ایران ینبغی الرجوع الى الدستور وقانون الصحافة، فالدستور یوضح فی مقدمته والمواد الثانیة والثالثة والرابعة وضع الصحافة، ولو ان عارفاً بالقانون تأمل هذه المواد وسائر الفقرات فانه لا یبقى امامه أی غموض، وعلى افتراض حصول غموض فان مجلس صیانة الدستور هو الذی یفسر القانون ویزیل الغموض.
أما قانون الصحافة فهو وإن كان خالیاً من الغموض فی المفاهیم والعبارات بید أن السؤال الجوهری بشأنه هو: هل أن قانون الصحافة اسلامی مائة بالمائة ویحقق ما ینشده المقنن أم لا؟
للإجابة على هذا السؤال ینبغی فی البدایة الإنتباه إلى أن الصحافة والكتاب ووسائل الاعلام المكتوبة وكذلك الأفلام والمسرحیات والانترنت... الخ كلها مصادیق للتعبیر، إذ بمقدور الإنسان التعبیر عن ارائه عن طریق اللسان والقول، وكذلك عن طریق الكتابة والعلامات والحركات، فمن لا یحق له توجیه الإساءة والإتهام للغیر بلسانه، فانه لا یجوز له أیضاً القیام بمثل هذه الافعال بالقلم والصورة والفیلم... الخ.
لیس مقبولاً من الأساس أن نضع قانوناً للتعبیر عن الرأی بالقول وقانوناً آخر ایضاً للتعبیر عن الرأی بالكتابة والعرض، فمثلما یتعین التحقیق فی الجرائم اللفظیة فی المحكمة وطبقاً لقواعد القضاء الاسلامی، یجب التحقیق ایضاً بشأن الجرائم
الخطیة ـ ومنها الصحافة ـ فی المحكمة وطبقاً لقواعد القضاء الاسلامی.
لیس من الصواب أن نجعل میزة خاصة للصحافة فی قانون الصحافة بحیث نعتبر الجهة المؤهلة للتحقیق فی جرائمها هیئة صحفیة منصفة أولاً، ونعتبر المخالفات الصحفیة ـ وإن كانت ضد الاسلام والنظام وأمن البلاد ـ جرماً صحفیاً، ونرى بالتالی عقوبتها الإیقاف عن الصدور لعدة أسابیع أو عدة شهور، بینما یستحق الإدلاء بالرأی قولاً فی بعض الأحیان عقوبات شدیدة بل وحتى الإعدام، وإن التآمر على النظام والاسلام وإهانة المقدسات الدینیة مما لا یقبل الصفح، فما هو المبرر فی أن نفصل حكم التعبیر عن الرأی بالكتابة أو الصورة؟!
إن من أسباب عدم انسجام قانون الصحافة مع الأحكام الإسلامیة هو مصدره الذی هو عبارة عن ترجمة للقانون الفرنسی، وبالرغم من التعدیلات التی أجریت علیه الاّ أن هیكلیته ظلت على حالها(1). فالحكومة الاسلامیة ملزمة بإعادة النظر فی القوانین الواردة من الخارج وادخال التعدیلات علیها بحیث تتلاءم مع القوانین الاسلامیة.
وخلاصة القول، الظاهر للعیان انه لا فرق بین الكتابة والقول من ناحیة الأحكام والقوانین، وكل ما كان محرّماً ومحظوراً قوله كانت كتابته كذلك، وكلُّ ما كان واجباً قوله ـ من قبیل موارد الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر ـ كان كتابته كذلك. إذن یجب إعادة النظر بقانون المطبوعات من الأساس.
الأمر الآخر الذی یجب ان یؤخذ بالحسبان فی مثل هذه الموضوعات هو أن الدستور أو سائر القوانین عادة ما یتم تدوینها بشكل عام وهی لا تتعرّض للامور الجزئیة والشخصیة، وإذا ما طرأت مشكلة فی موارد التطبیق یتعین الرجوع لذی الاختصاص ولیس للرأی العام، لئلا یقال فیما بعد: نظراً للمشاكل التی تعترض
1. لقد جرى اقتباس أول قانون للصحافة عام 1268 هـ . ش ـ أی بعد سنة من الحركة الدستوریة ـ عن قانون الصحافة فی فرنسا، وقد جرى تعدیل هذا القانون أربع مرّات وفی سنوات 1321، 1334، 1358 و1364 هـ .ش.
عملیة جمع آراء عامة الناس فلابد من ان تنهص خلاصة الرأی العام وهی الهیئة المنصفة بهذا الدور، ولغرض ان لا یدعی كل مدع بانه صاحب اختصاص فلابد ان یوضع قانون من قبل مجلس الشورى الاسلامی أو المجلس الأعلى للثورة الثقافیة ویُعیَّن أُناس بشكل دائمی أو مرحلی وفقاً لهذا القانون كخبراء رسمیین لتحدید الحالات الصحیحة والخاطئة وما شابه ذلك فیما یخص المطبوعات.
ومن الطبیعی ان هؤلاء یجب ان یكونوا عارفین بأسس وقواعد الدستور، وبالإضافة إلى وجوب مطابقة وانسجام تدوین قانون المطبوعات مع الإسلام فمن الواجب ان تُسلم أزمّة التنفیذ لأناس یؤمنون ویلتزمون بالقانون، ویرصدوا المخالفات على الصعید العملی دون توان أو خطأ.
* * * * *
الفصل الثانی
الـتـعـددیــة
التعددیة ومجالاتها المختلفة
سؤال: ماذا تعنی التعددیة؟ وفی أی المجالات یمكن تداولها؟
جوابه: تعنی كلمة «بلورال» الجمع والكثرة، لذلك فان pluralism تعنی مذهب التعدد أو الدعوة للتعدد والكثرة. ویقابل مذهب التعددیة مذهب الوحدانیة Monoistic. ونحن فی مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة نواجه السؤال التالی وهو: هل ان الأمر ینحصر فی شخص واحد أو مجموعة واحدة أم هو بأیدی عدة اشخاص أو عدة مجامیع؟ فإذا ما قبلنا بتعدد الأفراد أو الفئات فذلك ما یقال له التعددیة، وعلى العكس إذا ما قبلنا بفرد أو فئة فهذا ما یسمى الوحدانیة.
ان الغرب هو مهد هذه المفردة، فكل من كان یشغل عدة مناصب فی الكنیسة أو كان یعتقد بامكانیته تصدّی عدة مناصب فی الكنیسة كان یدعى فی السابق بالتعددی. غیر أن التعددی تطلق الآن فی المیدان الثقافی على من یرى صحة كافة المناهج الموجودة على صعید فكری معین سواء كان سیاسیاً أو دینیاً أو فنیاً أو غیر ذلك. وهذا ما یقابل الإعتقاد بالمذهب الإحتكاری Exclusivism، أی القول بأحقیة مذهب واحد أو مدرسة واحدة لا غیر وان سائر المناهج والمدارس لا صحة لها.
تُطرح التعددیة فی مختلف المجالات، وفی كلٍّ من هذه المجالات تأتی تارة بمعنى الإعتراف بالكثرة وبتعدد الآراء فی مجال العمل، بما یعنیه ذلك من التعایش بوئام، واحترام الرأی الآخر، والسماح بالتعبیر عن وجهات النظر المختلفة، وهذه هی التعددیة العملیة. وتارة تأتی بمعنى التعددیة النظریة والعلمیة بما یعنیه من القول بصحة كافة الآراء على اختلافها فی مضمار السیاسة أو الثقافة أو الإقتصاد أو الدین. أو أن نقول بأن الآراء جمیعها تنطوی على جانب من الحقیقة، لا أن أحدها حقٌ محضٌ وخالصٌ والآخر باطلٌ وخاطئ.
فی السابق حیث لم تنل المجتمعات من التطور بقدر ما علیه الیوم وكان التواصل فیما بینها ضعیفاً لم تُثر قضیة خاصة تُسمى التعددیة، غیر أن هذه القضیة أُثیرت الآن مع اتساع المجتمعات وامتداد التواصل فیما بینها، لاسیما بعد تصاعد وتیرة الحروب الطائفیة والدینیة وعواقبها المدمرة الوخیمة حیث ترسّخت الفكرة القائلة بوجوب الاعتراف بأدیان ومعتقدات الآخرین والتعایش معهم، لأن مصلحة المجتمع البشری تكمن فی التلاؤم فیما بین الأدیان والمذاهب على اختلافها.
إن قوام التعددیة فی بعدها العملی هو التعایش السلمی، لذلك تأتی التعلیمات بأن تبادر الأطراف المتعددة داخل المجتمع لتكریس طاقاتها للبناء الذاتی والتعایش سلمیاً فیما بینها، بدلاً من الإحتكاك مع بعضها، وهذا لا یعنی أن تقول الجماعات كافة بأحقیة بعضها البعض، وإنما الإقرار بوجود الكثرة كأمر واقع، بید أن هذا لا یتنافى مع اعتبار كل فئة انها على حق وان الآخرین على باطل.
ومقتضى التعددیة فی البعد النظری والعملی هی أن لا یكون الإنسان متصلباً متعصباً لفكر معین معتبراً إیاه صواباً مائة بالمائة، وهذا فی الحقیقة إنما یعود إلى نوع من الشك فی مضمار علم المعرفة.
* * * * *
مفهوم التعددیة الدینیة
سؤال: ماذا تعنی التعددیة الدینیة؟
جوابه: تُطرح التعددیة الدینیة تارة فی البعد النظری والفكری، واخرى فی البعد العملی.
والمراد من التعددیة الدینیة فی البعد العملی هو احترام عقیدة الطرف المقابل وما یؤمن به من دین ومذهب، والتعایش السلمی مع الآخرین. والتعددی هو الذی یؤمن بالتعایش السلمی بین نوعین أو أكثر من الأفكار ـ بغض النظر عن إثباتها أو نفیها نظریاً ـ وأن لا تفتعل المشاحنات فیما بینها على الصعید الإجتماعی. وأمّا مَنْ قال بإلغاء أحد الطرفین من المجتمع والسماح بالعمل لأحدهما فهو ضد التعددیة، ففیما یتعلق بالمذهب الكاثولیكی أو المذهب البروتستانتی ـ مثلاً ـ یقول البعض: یجب أن یحكم أحدهما لذلك یتعین مقارعة الآخر حتى یخرج من الساحة.
ولكن فی ضوء التعددیة الدینیة ینبغی لهذین المذهبین التعایش باخوة من الناحیة العملیة بالرغم من أن كلاً منهما یرى الآخر باطلاً من الناحیة النظریة.
وأما التعددیة الدینیة فی البعد النظری فهی تعنی أحقیة الأدیان والمذاهب برمتها، وسیأتی المزید من التوضیح والتفصیل لهذا الموضوع فی إطار الأسئلة اللاحقة.
* * * * *
تقییم للتعددیة الدینیة فی البعد النظری
سؤال: ماذا تعنی التعددیة الدینیة فی البعد النظری؟ وهل یمكن القبول بها؟
جوابه: إن التعددیة الدینیة تعنی على نحو الاجمال والایجاز حقانیة الأدیان على تعددها، بید أن بیان وتفسیر هذا الكلام فی إطار مفرداته یأتی على ثلاثة أنماط هی:
أولاً: لیس هنالك دین باطلٌ محض أو حقٌ مطلق، وإنما فی كل دین تعالیم صائبة واخرى خاطئة.
ثانیاً: ان الحق واحد وكل دین من الأدیان یمثل صراطاً نحو ذلك الحق.
ثالثاً: ان المسائل الدینیة تعد من القضایا التی لا تقبل الإثبات، وهذه القضایا إما ان تكون لا معنى لها وإما انه مما یتعذر إثباتها ان كان لها معنىً. بناءً على هذا فهی على مستوىً واحد، ولكل انسان أن یختار أیَّ دین یرتضیه.
توضیح التفسیر الاول
یرى القائلون بهذا الرأی أن الحقیقة تتكون من مجموعة من الاجزاء والعناصر وإن كل جزء من أجزائها یتبلور فی دین معین. لا ان الدین الواحد یكون خاطئاً وباطلاً بأكمله ولا وجود فیه لأی مرسوم أو حكم صحیح وصالح، كما أننا لا نمتلك دیناً یخلو من أی حكم خاطئ ومناف للواقع، فالكثیر من أحكام المسیحیة وردت فی الإسلام بنحو من الأنحاء، لذلك لا یصح القول ببطلان المسیحیة كلیاً، كما أن الإسلام یتفق مع الیهودیة فی الكثیر من الموارد. إذن لا یمكن القول برفض الیهودیة أو الإسلام كلیاً.
إذا ما توزعت المحاسن والحقائق فیما بین الأدیان إذ ذاك لا یمكن القول بصحة
دین بشكل تام وخطأ آخر بشكل تام، بل یتعین إحترام كافة الأدیان والمذاهب على حدٍّ سواء. بل ویمكن القیام بعملیة تفكیك فی الأدیان، بمعنى إلتقاط التعالیم الصحیحة من كل دین من الأدیان والإعتراف بمزیج منها، فنأخذ جانباً من الیهودیة وجانباً من الإسلام وجانباً من دین آخر.
نقد التفسیر الاول
إن أساس القول بأن الكثیر من الأدیان بل جمیعها تتضمن نوعاً ما من عناصر الحق هو موضع قبولنا. ولا یوجد فی هذا العالم باطل مائة بالمائة. ومثل هذا الكلام لا یحظى بالقبول من لدن أی إنسان. ولكن إذا كان المراد ـ من ناحیة أخرى ـ ان كافة الأدیان فی العالم تتضمن أحكاماً ومعتقدات باطلة ولیس هنالك دین كامل وجامع، فإن هذا الكلام مما لا نقبله، فالإسلام یصرح: ان دین الله وشریعة محمد(صلى الله علیه وآله)كامل وصحیح وقد اكتمل الدین وتمت النعمة بظهور الإسلام. وإن ما ورد فی سائر الادیان فهو صحیح إن كان منسجماً مع الإسلام وإلا فهو باطل. فعبادة الأصنام والحیوانات... الخ لا تنسجم مع الإسلام ودین التوحید المصون من التحریف. وإن وجدان كل منصف یرى تناقضاً واضحاً بین هذه الأدیان وتعالیمها مع بعضها.
بالاضافة إلى أن الإسلام دینٌ یرفض بكل وضوح الإیمان ببعض الآیات والكفر ببعضها الآخر، ویصرح بأن التمییز بین تعالیم الدین وأحكامه یوازی الرفض لكل الدین والكفر به، وخلاصة القول ان الإسلام وما ورد عن الثقلین حقٌ كله ولا سبیل للباطل فیه.
توضیح التفسیر الثانی
ویرتكز هذا الرأی على أن الدین الحق بمثابة قمة وإن كافة الأدیان السائدة فی العالم تمثل سبلاً تؤدی إلى تلك القمة، فای دین فهو یرید الأخذ بأیدینا إلى ذلك
الحق الواحد ویوصلنا الغایة على أیة حال، سواء كان سبیله طویلاً أم قصیراً أم مساویاً للسبل الاخرى؛ فالّذی یتوجه إلى المسجد أو الذی یتوجه إلى الكنیسة أو إلى معبد الأوثان أو الدیر بأجمعهم یتوجهون إلى معبود واحد هو الحق.
نقد التفسیر الثانی
هذا الكلام یمكن تصوّرة فی مقام التمثیل والتشبیه، لكن العلاقة بین الأدیان على اختلافها لا تُرسم بهذه الصورة، فعندما یكون نداء «الله واحد» أول قضیة وأول حدیث فی الإسلام وأن سبیل الفلاح هو الاقرار بالتوحید فكیف یتلاءم هذا السبیل مع طریق المسیحیة التی تنادی بالتثلیث؟! وكیف یوصلان إلى نقطة واحدة یا ترى؟ وهل یلتقی فی نقطة واحدة خطان یمتدان باتجاهین متعاكسین؟ وهل یشترك القرآن ـ الذی یقول فی تعاطیه مع عقیدة التثلیث ـ: «تَكادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الأَْرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً»(1) بالخط والهدف مع القائلین بالتثلیث؟! وهل یصل الدین الذی ینهى عن أكل لحم الخنزیر وعن تناول المشروبات الكحولیة مع الدین الذی یجوزهما إلى نتیجة واحدة ونهایة واحدة؟
توضیح التفسیر الثالث
وهنا یعتبر بعض الوضعیین وبشكل إفراطی ان هذه القضایا تخلو من المعنى. ویقول البعض: ربما تنطوی على المعنى لكنها لیست قابله للإثبات؛ ولعلها تكون صالحة وصائبة بالنسبة لبعض وخاطئة بالنسبة لآخرین؛ أو انها تكون صالحة فی عصر وسیئة ومخطئة فی آخر. إننا لا یمكننا الحصول على معرفة قطعیة وتامة بالواقع، وان تحقق الیقین التام بأی قضیة دلیل على عدم الدقة والتأمل فیها، وما شابه هذه النظریات.
1. مریم: 90 و91.
وخلاصة القول، ان هذه الأمور ضربٌ من التلاعب بالألفاظ وتابع للتوجهات الإجتماعیة والفردیة. وان أهمَّ دواعی وجذور الدعوة للتسامح والتساهل المنطلقة فی عالم الیوم انما یعود إلى هذا الأمر.
واستناداً إلى هذا المنطلق الفلسفی قال البعض بالتعددیة الدینیة وصرحوا بانه لیس لدینا دین صحیح ودین خاطئ أو دین حق ودین باطل، فاستخدام الصواب والخطأ فی هذه الامور خطأ بحد ذاته، وهذه القضایا إمّا انها بلا معنى واما انها لا یمكن اثباتها أو نفیها. وبتعبیر آخر یمكن القول ـ مع شیء من التسامح ـ أن كافة الأدیان والسبل حقّة ومستقیمة.
ولقد فرّق البعض هنا بین القضایا الدینیة قائلین: ان ما یتحدّث عن الحقائق والوجودات فهو ذو معنىً، وفیه مجال للصدق والكذب من قبیل مسألة «الله واحد» وامّا ما كان من قبیل الواجبات والمحرمات فانه لا سبیل للصدق والكذب الیه من قبیل قضیة «لابد من اجراء العدالة» و«لا ینبغی القیام بالظلم».
نقد التفسیر الثالث
ان الحدیث عن الفلسفة الوضعیة وكون القضایا غیر الحسیّة ذات معنى والحدیث عن الاتجاه الحسی أو الاتجاه العقلی فی مجال المعرفة یرتبط بموضع آخر وقد جاء بالتفصیل فی البحوث الفلسفیة والمعرفیة.(1) ونحن هنا نكتفی بالإشارة إلى أنه نظراً لرفضنا الإعتماد التام على الحس وعدم الإعتماد على العقل فی مضمار المعارف والعلوم الانسانیة ونظراً لان الحس والتجربة لا تمثل الطریق الوحید لبحث صحة أو سقم كلام ما ـ بل یمكن إثبات بعض القضایا أو نفیها عن طریق العقل ایضاً كما فی الأبحاث الریاضیة والفلسفیة ـ فان هذه النظریة مرفوضة بشكل تام من قبلنا، بالإضافة إلى ما نراه بالوجدان من فارق بین قضایا من قبیل «الله موجود»
1. راجع كتاب المنهج الجدید فی تعلیم الفلسفة، محمدتقی مصباح الیزدی، ج 1، الدرس الثالث عشر حتى التاسع عشر.
و«لا ینبغی القیام بالظلم» و«لابد من أداء الصلاة» وبین قضیة «نور المصباح مرّ الطعم»، فلو كانت المسائل الثلاث الاولى تفتقد المعنى فینبغی ان لا تختلف عن المسألة الرابعة من حیث المعنى.
فاذا كانت المفاهیم الدینیة معقولة وقابلة للبحث وممكنة الإثبات والنفی ففی مثل هذه الحالة ینقدح الإشكال السابق وهو انه كیف یمكن الجمع بین هذه القضایا الثلاث «الله غیر موجود» و«الله واحد» و«الله ثالث ثلاثة» وان تكون صحیحة بأجمعها؟ فهل یمكن الاعتقاد بصحة هذه القضایا الثلاث حقاً فی ضوء نظریة التعددیة؟
* * * * *
التعددیة الدینیة فی البعد العملی
سؤال: هل كان للتعددیة الدینیة فی بعدها العملی وجود على امتداد التاریخ الإسلامی؟
جوابه: یمكن طرح التعددیة الدینیة بین طائفتین من مذهب واحد أو بین مذهبین من دین واحد بل وحتى بین دینین ایضاً. فیمكن تصورها بین الإسلام والمسیحیة والیهودیة فی المجتمعات التی تعیش متقاربة مع بعضها أو فی حدود منطقة جغرافیة واحدة أو فی مدینة واحدة، حیث یعیش أتباع هذه الدیانات مع بعضهم حیاة وئام بعیداً عن أی صراع، فی وقت یعتبر كلٌّ منهم نفسه أنه على حق والآخر على باطل، بل وتدور بینهم جدالات ومناظرات أیضاً؛ وفی الإسلام هنالك وجود لمثل هذا الأمر أیضاً، فالقرآن الكریم وسیرة النبی الأكرم(صلى الله علیه وآله) والأئمة الأطهار(علیهم السلام) تحث المسلمین على التحلی بمثل هذه العلاقات، وان الوحدة التی ننادی بها فی شعاراتنا الآن وندعو الشیعة والسنّة إلیها، كانت مطروحة فی عهد الإمام الصادق(علیه السلام) أیضاً، وكان(علیه السلام)یحث على المشاركة فی صلوات الإخوة أهل السنة وجنائزهم، وكان(علیه السلام)یعود مرضاهم ولا یتوانى عن تقدیم أی مساعدة یستطیعها إلیهم.
والأكثر مدىً من ذلك أن علاقة المسلمین بأهل الذمة كانت منذ صدر الإسلام حمیمة وودّیة فكانوا یتبادلون المعاملات ویتشاطرونها ویتبادلون الاقتراض ویعود بعضهم مرضى بعضهم الآخر، لكن فی نفس الوقت كان كلٌّ منهم یرى دینه هو الحق من الناحیة النظریة والفكریة.
على أیة حال، هذا الأمر من المسائل القطعیة فی الإسلام ولا مجال للشك فیه، ولا یراود الشك علماء المسلمین شیعة وسنة بأن حیاة الوئام مع أهل الكتاب هی من الامور المتسالم علیها، وإن كانت هنالك فوارق فی طبیعة هذه الحیاة بین
الطائفتین، ولكن هنالك على أیة حال سبل علاج للمسائل والعلاقات المشتركة، وهذا الموضوع لا یعنی ـ بطبیعة الحال ـ تاییداً لدینهم ـ أهل الكتاب ـ بل یمكن القول واستناداً لما یراه الإسلام بإمكانیة التعایش السلمی مع المشركین فی حالة توقیع معاهدة معهم تحت عنوان الحكم الثانوی، كما شهدنا فی صدر الإسلام الصلح الذی عقده النبی(صلى الله علیه وآله) مع المشركین والمعاهدة التی أبرمها الطرفان فی عدم التعرض لأرواح وممتلكات الطرفین.
* * * * *
أحقیة الأدیان والمذاهب وإن تعددت؟
سؤال: هل یمكن القول بأحقیّة الأدیان والمذاهب وإن تعددت؟
جوابه: كما تقدم أن للتعددیة والكثرة بعداً عملیاً، وذاك ما یدعو إلیه الإسلام من المداراة والوئام والتعایش السلمی بین اتباع الأدیان والمذاهب المختلفة، واذا لم نقل أن الإسلام كان مبدعاً وسباقاً فی هذا المضمار فهو الملتزم باحترام حقوق مختلف الأقلیات الدینیة والمذهبیة على أقل تقدیر؛ ویكفینا بهذا الإتجاه العودة إلى الكلام الرائع والمشهور عن الإمام علی(علیه السلام) عندما سمع بأن جنود معاویة قد انتزعوا من امرأة یهودیة خلخالها فقال: فلو انّ امرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً.
بید أن الحدیث یدور حول ما إذا كان ممكنا اعتبار كافة الأدیان والمذاهب حقاً حین التعاطی مع ظاهرة الكثرة فی الأدیان والمذاهب؟ هل یمكن القول إن الإسلام حق، والمسیحیة حق ایضاً؟
للإجابة على هذا السؤال نُلقی نظرة على مضمون الإسلام والمسیحیة حتى نرى ما إذا كان بالإمكان الإقرار بأحقیتهما أم ان الإعتراف بأحقیة أحدهما یستلزم إنكار الآخر؟
إنّ «التوحید» هو القضیة الأولى فی الإسلام، أی ان الله واحد لا یقبل التجزئة والتعدد، ولم یلد ولم یولد، غیر أن التثلیث هو الأصل الأول فی المسیحیة، وناهیك عن ما شذ وندر من الفرق فإن مذاهب الكاثولیك والبروتستانت والأرثوذوكس وهی المذاهب الثلاثة فی المسیحیة، تقول بان الله ثلاثة: الاب والابن وروح القدس. وان سبیل الخلاص من الشقاء والعذاب هو الإعتقاد بالتثلیث. وقد قیل وكُتب الكثیر فی تفسیر هذه الأصول والأقانیم الثلاثة، وماعدا الثلة القلیلة من الذین یرون التثلیث
أمراً خارجاً عن أصل المسیحیة، فإن الباقین یؤمنون به، ویقبلون بنحو ما بألوهیة المسیح أو انه ابن الله.
یقول القرآن فی تعامله مع مثل هذا الكلام: «تَكادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الأَْرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً»(1)، أو قوله فی موضع آخر «... فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَیْراً لَكُمْ»(2)، أو ما یقوله «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّ اللّهَ ثالِثُ ثَلاثَة...»(3).
هل یقبل عقل إنسان ـ ناهیك عن المسلم ـ ان التوحید والتثلیث حق وصواب، فالأول یقول إنك لن تدخل فی جماعة المسلمین ما لم تصبح موحداً وتؤمن بالله الواحد، وإن أول شرط لاعتناق الإسلام ودین الحق هو التوحید، فیما یقول الثانی إنك لن تدخل المسیحیة وتحرز النجاة وتبلغ السعادة ما لم تؤمن بالتثلیث، فشتان ما بین هذین المنطقین، وكذا إذا ما قارنا بین هذین الدینین وبین البوذیة القائلة بعدم وجود الله وانه لن یوجد، فإنها لا تجتمع ابداً، إذ ان «الله موجود» تتنافى مع «الله غیر موجود»، كتناقض «الله ثالث ثلاثة» مع «الله غیر موجود»، والجمع بینها أقرب للمزاح والأسطورة منه إلى الجد والواقع.
وكذلك لو ألقینا نظرة على الشریعة والاحكام الاسلامیة والمسیحیة لوجدنا عدم إمكانیة الإعتراف بحقانیتهما معاً، فالإسلام یقول بحرمة أكل لحم الخنزیر، فیما تقول المسیحیة بأن أكل لحم الخنزیر حلال وطیب. وعلى صعید الإسلام یقول علی(علیه السلام): لو ألقیتم قطرة من خمر فی بئر ونما من ذلك الماء نبات وأكله خروف فإنی لا آكل من لحم ذلك الخروف، أما فی المسیحیة فقد ورد: لو أن قسیساً غمس رغیفاً فی الخمر ووضعه فی فمك فإن ذلك الرغیف الذی أكلته سیتحول إلى دم عیسى.(4)
1. مریم: 90 و91.
2. النساء: 171.
3. المائدة: 73.
4. إشارة إلى مراسم العشاء الربانی، راجع الكتاب المقدس، العهد الجدید، انجیل متى، الباب 26.
وفی ضوء هذه الموارد وما ناظرها هل یعقل إنسان ان الاسلام صراط مستقیم یوصل إلى الحق وقمة الكمال والسعادة، والمسیحیة كذلك وهكذا البوذیة... الخ؟!
* * * * *
هل هناك أكثر من صراط مستقیم؟
سؤال: هل من الصواب القول بوجود اكثر من صراط مستقیم فی إطار الإسلام؟
جوابه: كما نوهنا لدى الإجابة عن السؤال السابق، فإن الإعتقاد بأكثر من صراط مستقیم وفقاً لما تفسره التعددیة بوجود حقائق متعددة ومختلفة للمسألة الواحدة، مما لا یمكن القبول به بأی حال.
أما فی ضوء تفسیر التعددیة لوجود حقیقة واحدة لیست بمتناول البشر، فإن الإعتقاد بأكثر من صراط مستقیم فی هذا الإفتراض أیضاً باطل على نحو العموم، ولكن بالإمكان القبول وبذلك فی إطار دائرة ضیقة جداً فقط، وهی ما عبّر عنه المفسرون فی كتبهم بـ «السبل» ولیس كثرة الصراط، فالصراط إنما یعنی جادة كبرى لا تتعدى الواحدة وتثبت بالیقینیات. ففی بعض الموارد هنالك طرق فرعیة ربما تعتریها المنعطفات التی لا تلحق الضرر بأصل الدین وان القبول بهذه الطرق لا یعنی تعدد «الصراط المستقیم» لذلك فقد أشار الله سبحانه وتعالى فی القرآن الكریم إلى «صراط» واحد، فیما أشار إلى «سبل» متعددة، إذ یقول: «وَأَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ»(1)، والصراط المستقیم هو الأصل طبعاً وإلى جانبه تمتد منه سبل متعددة وهذا مما یمكن قبوله فعلى سبیل المثال یقول تعالى: «وَالَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا»(2)، ففی هذه الآیة هنالك سبل یمكن الاعتراف بها وهی بمثابة فروع للجادة الكبرى المتمثلة بالصراط المستقیم.
* * * * *
1. الانعام: 153.
2. العنكبوت: 69.
دوافع الترویج لفكرة التعددیة الدینیة فی مجتمعن
سؤال: ما هی دوافع الترویج لفكرة التعددیة الدینیة فی مجتمعنا؟
جوابه: منذ مدة یجری الترویج فی الصحافة والنشرات والمحاضرات ومن قبل بعض المشبوهین لفكرة التعددیة فی الأدیان، ویتم التأكید على أن للإسلام محاسنه وكذلك للمسیحیة وسائر الأدیان محاسنها أیضاً. وینبغی النظر إلى عقائد الآخرین بعین الإحترام والرأفة والتسامح، وكما نحب أن یحترم الآخرون عقیدتنا وندعوهم لدیننا یتعین علینا أن نمنح الآخرین حقهم فی أن یعتبروا أنفسهم على حق ویدعوا لدینهم، ومعتقدهم هذا یحظى بالإحترام والإعتبار.
ربما تكون دوافع الترویج لمثل هذه الموضوعات والأفكار فی مجتمعنا ما یلی:
أ ـ الحیلولة دون تصدیر الثقافة الإسلامیة والثوریة: إذا ما كانت الموضوعات والأدیان والمعتقدات بأجمعها صحیحة، فلا ضرورة إذن لدعوة الآخرین للإسلام، فإذا كان منطق المسیحی صحیحاً ایضاً فما الضرورة فی أن یعتنق المسیحی الإسلام؟ واذا ما كان المادیون على حق فی منطقهم الذی یتفق مع اذواقهم فما الداعی فی أن یدعوهم الربانیون إلى الله؟ ولماذا یدعو الموحد المشرك إلى التوحید؟... الخ، وبالنتیجة یظل الفكر الثوری والإسلامی قابعاً فی دائرة معینة ویفقد زهوه ونشاطه ودعوته ویصبح عقیماً.
ب ـ تمهید السبیل لتغلغل الأفكار والمعتقدات والقیم المادیة والغربیة فی مجتمعنا: فحینما یفتقد دیننا وثقافتنا وقیمنا صفة الإطلاق ولا نعتبر الإسلام هو الدین الحق الوحید، فلا محالة أن یُفْسَح المجال أمام سائر الأدیان والمذاهب؛ فإذا ما كانت سائر الفِرق والمذاهب حقةً أیضاً فلماذا لا نتبع الآخرین فی میولهم واذواقهم وخصالهم وقیمهم؟
إن نتیجة الأمرین الآنفی الذكر هی زوال الحمیة والغیرة الدینیة، وإذا ما تزعزعت الحمیة والغیرة الدینیة التی تقف بوجه تغلغل الأفكار الضالة والخاطئة وترسخت روح التسامح والتساهل واللامبالاة ازاء المعتقدات والمقدسات والقیم فی أوساط الشباب وأبناء المجتمع إذ ذاك یبلغ أعداء الإسلام والنظام مرامهم، وذلك لفسح المجال أمام نفوذ وإملاء القیم المادیة والغربیة وتمهید الأرضیة لعودة هیمنة الكفر والإستكبار العالمیّ.
* * * * *
الأدلة على الفكر التعددی
سؤال: ما هی الأدلة والشواهد التی یقدمها دعاة التعددیة على نظریتهم؟
جوابه: ینبغی فی البدایة معرفة أن القائلین بالتعددیة یقدمون أدلة وشواهد عدیدة لنظریتهم منها العقلی والتاریخی والقرآنی والأدبی... الخ، ولیس مرادنا التطرق إلیها جمیعاً بل نكتفی هنا بإیراد طائفة منها، فالقائلون بالتعددیة یستعینون بثلاث مسائل فی هذا الاتجاة هی:
1 ـ التعددیة فی القضایا السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة.
2 ـ النسبیة فی القیم.
3 ـ النسبیة فی المعرفة.
وهنا نتطرق لإیضاح كلٍّ من هذه الموارد بإیجاز:
1 ـ أ ـ التعددیة السیاسیة والإجتماعیة: هنالك فی عالم الیوم دول مختلفة تختلف فیها الحكومات، فبعضها نظام ملكی، وبعضها الآخر نظام جمهوری، وبعض رئاسی والآخر برلمانی. وكلّ منها یتصدى لإدارة بلده بطرق مختلفة.
وعندما نسأل ـ على صعید الفلسفة السیاسیة ـ أی نمط من أنظمة الحكم هو الافضل؟ لا یُقدّم جواب قاطع بل یقال لكلٍّ منها مزایاه ومحاسنه، وكذا لكلٍّ منها نواقص وعیوب.
وكذلك فإن الدیمقراطیة الیوم تمثل أمراً مقبولاً ویقال: یجب أن یؤدی الشعب دوره فی ادارة دفة الحكم عن طریق الأحزاب، فإذا ما أحرز احد الاحزاب الأكثریة واستلم الحكم إلى الأبد فذلك لیس مرغوباً فیه ولیس مقبولاً ـ بل لابد من أن تتصادم الآراء وتختلف وجهات النظر ویستلم كل حزب زمام الأمور لفترة معینة. إذن التعددیة الحزبیة أمر مقبول الآن أیضاً.
ب ـ التعددیة الإقتصادیة: إن وجود أقطاب إقتصادیة متعددة على صعید البعد الإقتصادی من شأنه القضاء على الظلم والإجحاف الذی یمارسه أُناس معدودون، وتحقیق التطور والنمو الإقتصادی فی ظل وجود قوى إقتصادیة متعددة فی المجتمع.
من خلال ذكر مثل هذه الأمور ألحق دعاة التعددیة الدین بالسیاسة والإقتصاد والحزب، ویستنتجون من ذلك أن التعددیة مستساغة فی شتى المجالات الإجتماعیة، ولابد من السعی لإقامتها وتنمیتها. ومن خلال التوضیح الذی قدمناه فی الرد على الأسئلة السابقة فیما یتعلق بالتعددیة الدینیة، تبین خطأ هذا القیاس.
2 ـ النسبیة فی القیم: هنالك الكثیر من المسائل والعلوم لا تتحمل الكثرة، أی یتعذر الإعتقاد بصحة نظریتین أو عدة نظریات بشأنها، ومن هذا القبیل المسائل الفیزیاویة والكیمیاویة والریاضیة والهندسیة.
فی ضوء هذا نوجّه السؤال الى أنصار التعددیة: لماذا تشبهون القضایا الدینیة والدین بالإقتصاد والسیاسة؟ ولماذا لا یكون الدین وقضایاه كالمسائل الریاضیة والفیزیاویة فی عدم تحملها لأكثر من إجابة صحیحة واحدة؟ كما فی تساوی أو عدم تساوی زاویة الاشعاع مع انعكاس الأشعة، وحاصل ضرب اثنین فی اثنین أما ان تساوی أربعة أولا، فاذا واجهنا هذا السؤال على الصعید الدینی «هل الله موجود أم لا» فانه لا یتحمل أكثر من إجابة صحیحة واحدة، ولا یمكن القبول بـ «تعدد الأجوبة الصحیحة».
هنا یقدم التعددیون موضوعاً آخر فی معرض الإجابة ویقولون إن المسائل الإنسانیة والقیمیة والثقافیة ـ التی من بینها القضایا الدینیة ـ هی أمور إعتباریة لا وجود لها على أرض الواقع، وعلیه فهی تابعة لذوق الإنسان. تأملوا فی هذا الموضوع ـ على سبیل المثال ـ فانه لا یمكن الجزم والبت فی القول أن اللون الأخضر أو الأصفر هو الأفضل من بین الألوان، أو أن العطر الفلانی هو الافضل، أو
أن الطعام الفلانی أطیب الأطعمة، أو أن فلاناً هو الأجمل من غیره، أو أن الماء أو الهواء الفلانی هو الأفضل، أو أن تقالید واعراف الشعب الصینی أو الیابانی أفضل من تقالید البلدان الإفریقیة.
وعلى هذا المنوال تأتی الأمور الدینیة، فلا یمكن ـ مثلاً ـ القول بحزم وبشكل قاطع ما إذا كانت الصلاة باتجاه مكة أفضل أم القدس؟ هل الإسلام أفضل أم المسیحیة؟ التوحید والدین الإلهی أفضل أم التثلیث أو المادیة؟ فهذه الأمور بأجمعها والآلاف من أشباهها تابعة لعادات الناس واذواقهم ولا حقیقة لها سوى اعتبار الناس لها واُنسهم بها. وبناءً على هذا فهی قابلة للتغییر، وبالوسع القبول باللون الأخضر لفترة معینة وأخرى بالأصفر وتارة باللون البنّی، فالجلوس علامة الإحترام لدى مجتمع ما، والوقوف لدى مجتمع آخر فیما یكون الإنحناء ومن ثم الاستقامة لدى مجتمع ثالث.
3 ـ النسبیة فی المعرفة: الركن والأصل الثالث الذی یُستفاد منه فی ترسیخ التعددیة هو النسبیة فی المعرفة وهو أصل المبدأین المتقدمین وأهم الأمور فی هذه القضیة. إذ یقال لیست المعرفة فی مجال القیم وحدها نسبیة بل هی نسبیة فی كافة المجالات، ولو أردنا التحدث بشكل أكثر شفافیة، فإننا نقول أن المعرفة تستحیل بدون النسبیة، غایة الأمر أنها واضحة وجلیة فی بعض الأمور وخفیة ومحجوبة فی بعضها الآخر، فثمة نسبیة فی العلوم الحقیقیة وكافة العلوم الإنسانیة وإن كافة علومنا تترابط فیما بینها ویؤثر بعضها على بعض، وإن هندسة العلوم البشریة منظمة وتعیش حالة التغییر بتغیر الفروع العلمیة المختلفة.
ونضیف فی الختام، بالاضافة إلى الأمور الآنفة الذكر فان هناك أناساً فی مجتمعنا ممن یتجلببون بظاهر اسلامی ودینی حاولوا إقامة الدلیل والقرینة على هذا المعتقد متوسلین بالمفاهیم الدینیة والنصوص المقدسة، بل وتشبثوا فی بعض الحالات بالنصوص الأدبیة والأشعار من قبیل شعر مولوی وعطار، حیث هنالك موارد عدیدة
طالتها الغفلة أو التغافل فی كل واحد من هذه الأدلة والأسانید، وقد جرى نقدها فی محله وتحت الإشارة إلى بعضها فی كتابنا هذا ایضاً.
* * * * *
الدوافع لظهور فكرة التعددیة
سؤال: ما هو الدافع أو الدوافع التی أدت على نحو الإجمال إلى ظهور فكرة التعددیة؟
جوابه: بالإمكان ذكر دافعین عقلائیین لفكرة الجنوح نحو التعددیة هما:
1 ـ الدافع العاطفی والنفسی.
2 ـ الدافع الاجتماعی.
اولاً: یقول البعض إذا أردنا اعتبار دین أو مذهب واحد هو الدین الحق والقول بان اصحابه هم الناجون فذاك أمر مستبعد، لأن كل إنسان یولد فی قوم ووسط تیار وقد نما وترعرع فیه فهو یرى أحقیة ذلك المعتقد والخط، وبطلان وضلال الآخرین. ولا تقتصر هذه الفكرة علینا نحن المسلمین أو الشیعة أو الإمامیة، فمثلما نعتبر الآخرین لیسوا على حق، فانهم یعتبروننا على غیر حقٍّ ایضاً، فلو كنا قد ولدنا وسط أمة ودین آخر ومن والدین مختلفین لكُنّا قد آمنا بفكرة أخرى، وكذا لو أن مسیحیاً أو یهودیاً أوربیاً أو امریكیاً قد ولد فی طهران أو قم لكان قد آمن بدین آخر. ومثلما یتعین علیهم إحتمال أحقیة الدین الإسلامی ونبیه الأكرم وان یبادروا للتحقیق عن ذلك دون توان، فإن علینا فی المقابل أن نحتمل أن تكون السبل الأخرى على حقٍّ وان نبادر للتحقیق فی ذلك، لأن ولادتنا الإجباریة فی بقعة من الأرض ومن والدین معینین لا یستلزم القول بأحقیتنا من ناحیة وعدم أحقیة الآخرین من ناحیة أخرى.
ومن جانب آخر هل یمكن القبول بأن 100 ـ 200 میلیون فقط من بین ستة ملیارات من البشر الذین یعیشون على وجه الكرة الأرضیة ـ ولیس هؤلاء كلهم وانما فی حالة التزامهم بالواجبات والمحرمات الشرعیة بحیث لا تغلق بوجوههم أبواب النجاة والجنة ـ هم على حق ومن أهل الجنة، وإن كل من كان غیر مسلم
سواءً كان یهودیاً أو مسیحیاً أو زراتشتیاً أو بوذیاً أو هندوسیاً... الخ، وكل من كان غیر شیعی ـ أی من شتى الفرق الإسلامیة ـ ومن لم یكن اثنی عشری ـ أی من سائر فرق الشیعة ـ هؤلاء بأجمعهم ضالون ومعذبون فی جهنم؟!
هذا التحلیل من شأنه أن یتحول إلى دافع نفسی لان یعتبر البعض سائر الأدیان والمذاهب على حق ایضاً فیقولون: نحن على حق وهؤلاء أیضاً من الناجین وأهل الجنة، فهم فی نظرهم محقون ولربما أكثر منّا ورعاً وزهداً وعملاً بدینهم.
ثانیاً ـ الأمر الآخر الذی أدى للجنوح نحو هذه النظریة هو مواجهة النزاعات والأحقاد والحروب المدمرة التی نشبت على امتداد التاریخ البشری وحتى الآن، فما أكثر الدمار وحالات الهدم وسفك الدماء التی وقعت بسبب الصراع على أحقّیة هذا الدین أو ذاك وتزمّت الناس وتعصّبهم لمعتقداتهم الخاصة، وإن الحروب الصلیبیة بین المسلمین والمسیحیین والحروب الطائفیة بین الشیعة والسنة أو بین الكاثولیك والبروتستانت كلها نماذج على ذلك. فأساس كل هذه النزاعات والتوترات هو التعصب والإصرار على الرأی. ولغرض إزالة التوتر ووضع حدٍّ لهذه النزاعات یتعین التحلی بقدر من التسامح والتساهل، فإذا ما أخذنا المبادرة وقلنا: نحن وأنتم على حق، فالإسلام حق وكذا المسیحیة، التشیع والتسنن كلاهما على حق، والكاثولیك والأرثوذوكس والبروتستانت... الخ جمیعاً على حق اذ ذاك ستُسأصل جذور الفتنة وتنال البشریة السلام والوئام والصفاء.
لقد دار الكلام لحد الآن حول توضیح هذین الدافعین، أما الآن فهل یتعین تأییدهما؟ وفی حالة تأییدهما هل هنالك طریق حلٍّ آخر سوى التعددیة أم لا؟ وإذا كان هنالك سبیل آخر للحلّ، فأی سبیل هو المنطقی والصحیح؟
للإجابة على السبیل الذی طُرح فی الدافع النفسی ینبغی الإشارة إلى ملاحظتین هما:
1 ـ إن لمفردة المستضعف فی معارفنا ما لا یقل عن مصطلحین هما:
أ ـ المستضعف إجتماعیاً وإقتصادیاً وهم الطبقة المحرومة فی المجتمع.
ب ـ المستضعف فكریاً ویُطلق فی علم الكلام على الفئة التی لا تعرف الحق نتیجة قصورها الفكری، فلم تفهم ـ مثلاً ـ الدلیل على وجود الله أو أحقیة الإسلام، أو أنها لم تصادف هذه المسائل وإذا ما صادفتها أو سمعت بها لم تحتمل صحتها ولم تتعقبها فی النهایة؛ وهذه الأمور إما ان تكون ناجمة عن البیئة العائلیة أو الاجتماعیة أو فقدان التبلیغ أو التبلیغ المضاد، فكان أن سلكت هذه الفئة طریقاً آخر على أیة حال.
2 ـ الجاهل إصطلاحاً على قسمین هما:
أ ـ الجاهل المقصر، أی مَن كان العلم فی متناوله أو انه یحتمل الخلاف فی معتقده لكنه یتوانى ولا یسعى للعثور على جادة الصواب والحق، وهذه الفئة مذمومة عرفاً وشرعاً.
ب ـ الجاهل القاصر: أی من كان إما غافلاً ولا یحتمل المخالفة فی قوله وفعله. وإما أن یحتمل ویرى ویستمع القول، لكنه لا یمتلك الوسیلة للوصول إلى الحق. وهذه الفئة لیست موضع ذم من قبل العرف والشرع.
الآن وفی ضوء هاتین النقطتین نقول: ان المستضعف الفكری والجاهل القاصر ـ أی مَن لم یدرك أحقیة الإسلام والتشیع واقعاً ـ معذورٌ وإن شطَّ وكان معتقده لیس على حق ـ لأن الحق لا یمكن أن یكون متعدداً، فاما ان الله موجود أو لا، وإما محمد(صلى الله علیه وآله) نبی الله وخاتم النبیین أو لا، والجمع بین ذلك بأجمعه جمع بین النقیضین وهو مستحیل ـ لكننا لا نعتبر هذه الفئة من أهل جهنم والعذاب، وإن الكثیر من العالمین یدخلون فی إطار هذه الفئة. نعم لو أن امرءاً قصَّر فی معرفة الحق أو انه رأى الحق وعانده، فمن الطبیعی أن العقل والشرع معاً یعتبرانه مستحقاً للعقوبة، وإن كل إنسان یستحق العقاب بمقدار تقصیره وعصیانه. والشاهد على هذا الرأی المقطع التالی من دعاء كمیل للإمام علی(علیه السلام) حیث یقول: «أقسمتَ أن تملأها من الكافرین
من الجِنَّة والناس أجمعین وأن تخلّد فیها المعاندین».
إذن كل من كان كافراً لا یسلك طریق الحق إنما یرد جهنم بمقدار تقصیره، أما الخالدون فی العذاب فهم المعاندون المحاربون، وخلاصة القول: إن الناجین وأهل الجنة فی عصرنا لا یقتصرون على الـ 100 ملیون أو الخواص من المذهب الإمامی.
الأمر الآخر الذی یجدر الإنتباه إلیه هو أن الحدیث فی موضوع التعددیة لا یجری حول أنّنا فی أی مدینة أو بلد، أو من أی أب وأم ولدنا وترعرعنا وكبرنا؟ بل الكلام فی أن رأیاً واحداً فقط ولیس أكثر هو الصحیح ـ من حیث الواقع وعلم المعرفة ـ من بین الأقوال والآراء المختلفة والمتناقضة. وأما ما سیحل بالمخالفین فهذا أمر آخر تمت الإشارة إلیه سابقاً.
واما فیما یخص الدافع الاجتماعی المتمثل بتجنب الحروب وسفك الدماء فحری القول ان هذه الأمور لم ولن تستدعی أحقیة المزاعم على اختلافها وتناقضها، فمقولة الأحقیة وعدمها والصواب والخطأ فی الأفكار تختلف عن مقولة عمل البشر وأحقادنا وأخطائنا، فلا یمكن ربط احداهما بالأخرى ولا العبور من احداهما الى الاخرى، بل هنالك سبیل حلٍّ صحیح لتجنب الحروب واعمال سفك الدماء غیر الضروریة، وهو الذی سلكه الإسلام على أفضل وجه، وتوضیح ذلك: یقسم مَن لیسوا شیعة اثنی عشریة إلى عدة فئات لها أحكامها الخاصة بها وهی:
أ ـ فرق الشیعة والسّنة: وهم مسلمون ماعدا ثلة قلیلة ـ أی النواصب الذین یسبون المعصومین(علیهم السلام) ویعاندونهم ـ وهؤلاء یشتركون مع الإمامیة فی أصل وجود الله والدین والكتاب وضروریات الدین، ویتمتعون بأجمعهم بالحقوق التی تناسبهم فی ظل الحكومة الإسلامیة بوصفهم أناساً مسلمین، ولم یأمر الدین أبداً بالحرب والتنازع بین هذه الفرق.
ب ـ غیر المسلمین أو من كانوا یهوداً أو مسیحیین أو زراتشتیین أو ما یصطلح علیهم بأهل الكتاب؛ وهؤلاء یتمتعون بحمایة النظام الإسلامی على أساس الذمّة،
وتُحترم أرواحهم وأموالهم ونوامیسهم؛ ومثلما یدفع المسلمون الخمس والزكاة والضرائب فإن هؤلاء ملزمون أیضاً بتسدید نوع من الضرائب وهی «الجزیة» إزاء الخدمات التی تقدم إلیهم. ولم یُصدر الإسلام أبداً الأمر بمقاتلتهم ابتداءً.
ج ـ مَن لیسوا أتباعاً للأدیان السماویة لكنهم أبرموا عهداً ومیثاقاً مع الحكومة الإسلامیة، وهؤلاء یُسمون كفاراً معاهدین یعیشون إلى جانب المسلمین، ویعیشون فی بلاد المسلمین على أساس المعاهدة، ویتعین على الطرفین العمل فی ضوء شروط المعاهدة ـ التی ربما تختلف ـ وطبقاً لهذه المعاهدة یُسلب حق التعرض والمواجهة والنزاع من الطرفین.
د ـ مَن لیسوا معاهدین أو أنهم یعاهدون ثم ینكثون عهدهم، وهؤلاء هم المتمردون الطغاة ولا یمكن تحملهم فی ظل أی نظام أو حكومة، ولابد من إجبارهم على الإستسلام أو استئصالهم من خلال التوسل بالقوة والحرب.
إن هذا المبدأ هو السائد فی كافة الأنظمة العالمیة ولیس هنالك حكومة سلیمة تسمح بالتطاول والعدوان على حقوق الآخرین، ولا تتصدى للمخالف.
وإلى جانب ما تقدم فإن الإسلام ـ دین المنطق والعقل ـ طالما دعا المخالفین للبحث والحوار مصرحاً بأننا دعاة النقاش والمناظرة، فان اقنعتمونا واثبتم أحقیة خطكم وصحته فنحن نتخلى عن موقفنا ونتبعكم، وإذا ما أثبتنا أننا على حق فعلیكم المبادرة والإلتحاق بنا، بل الأكثر من ذلك، إنه یقول: حتى وإن لم تُسلّموا للمنطق والحق فتعالوا نتعایش معاً على أساس المعاهدة والمیثاق ونتجنب اهراق دماء بعضنا البعض، فإن لم تشاؤوا فلا تقبلوا منطقنا.
وبالتالی اذا لم یذعن امرؤ لحدیث المنطق والحق ولم یكن على استعداد للتصالح والتعاهد والتعایش السلمی، فان كل مراقب منصف یصدّق اذ ذاك بعدم وجود سبیل سوى المواجهة، فلا یكفی لدى النزاع والمواجهة أن یكف طرف واحد عن الهجوم والتنازع بل یتعین على كلا الطرفین الكف عن التعدی والهجوم لكی
تُزال حالة الخصام والحرب. إذن لیس سبیل الصواب هو أن نقول: إن الجمیع على حق، بل یمكن للمرء اعتبار نفسه على حق، وهنالك ـ فی الحقیقة ـ طائفة واحدة محقة فقط، لكنه مع ذلك لا یعلى الخصام والحرب على الآخرین أبداً.
* * * * *