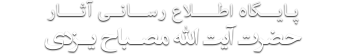الاهتمام بالثقافة شرط مهم لتحقق أهداف الخطوة الثانية للثورة[1]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله.
اللهُمّ كُن لوليّكَ الحجة بنِ الحسن، صلواتُك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعةِ وفي كلِّ ساعة، وليًّا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعَينًا، حتى تُسكِنه أرضَك طَوعًا وتُمتِّعه فيها طويلًا.
أرحب بالإخوة الكرام الذين أعُد لقائي بهم عن قُرب سعادةً لي، وأسأل الله تعالى أن أُشمل بدعواتهم.
الآراء والنظريات ذات الصلة بالثورة الإسلامية في إيران
ما يتبادر إلى ذهني القاصر إجمالًا هو أننا تارةً ننظر إلى هذه الثورة من زاوية أنها ظاهرة حصلت مرة واحدة في سجل تاريخ بلدنا، ولم يكن يحدونا في بداية انطلاقها أمل كبير بأن تتكلل بالنجاح والانتصار، لكنها – في النهاية – بلغت الأربعين، ولله الحمد فقد أمهَلنا الله أربعين سنة أُنجزت خلالها منجزات، وأن هذه الظاهرة، حالها حال سائر الظواهر الاجتماعية، ستنتهي هي الأخرى يومًا ما. وعلى حد قول علماء الاجتماع: "إن لكل ظاهرة اجتماعية عمرًا." وهذه الظاهرة أيضًا قد أخذَت نصيبها من العمر وبلغَت الأربعين، ولا بد من انتظار ما سيحصل بعدها من ظروف، وما الذي يجب صنعه حينها؟
لكننا – تارةً أخرى – ننظر إلى هذه الظاهرة على اعتبارها مرحلةَ ازدهارٍ لعصرٍ افتتَحه نبي الإسلام محمد المصطفى (صلّى الله عليه وآله)، وسيستمر حتى ظهور صاحب الزمان (عجّل الله تعالى فرَجه الشريف) وما بعده، وأن هذه الثورة ما هي إلا حلقة من هذه السلسلة الطويلة، ليس لها عمر محدد، وأن عمرها حتى نهاية هذا الزمان معلومٌ عند الله تعالى، وأن علينا أن نحسب طبيعة ارتباطها بالماضي، وما النفع الذي ينبغي أن نجنيه من ماضيها، وما الممهِّدات التي علينا إعدادها لمستقبلها.
ثمّةَ فَرق كبير بين هاتين الرؤيتين؛ فالأولى عبارة عن رؤية سياسية، شأنها شأن أي حركة سياسية تحصل في أي بلد؛ وهو أن يحرّك شخصٌ ما انقلابًا، أو يحصل تحوُّل فكري ما، أو يغلب حزب من الأحزاب، أو تسيطر إيديولوجية معيَّنة، ثم بعد عشرٍ أو عشرين من السنين يتغيّر الوضع وتنقلب الصفحة. والكل يعلم أن هذه هي العاقبة، لكن من أجل أن نطيل عمرَها بعض الشيء ترانا نؤسّس لشبكةٍ، أو نمارس أنشطةً، أو نقيم تنظيمًا، لكن أفُق فكرنا هو هذا ولا غير؛ وهو أن هناك حدًّا معيّنًا تنتهي عنده، ولو بالَغنا في التفاؤل فلن تدوم لأكثر من عشرة أعوام أخرى!
هذه الرؤية تختلف كثيرًا عن تلك التي نرى فيها أن الثورة حلقةٌ من سلسلةِ أحداث تمتد لبضع آلاف من السنين لا ندري متى ستكون نهايتها، ولكنّ دورَنا في هذه الثورة – على أية حال – لا بد أن يتناسب مع هذه الرؤية، وهو أنه لا يمكن تعيين حد معيَّن لها، فهي إلى أن يشاء الله.
إذًا علينا – أولًا – أن نحدد نوع رؤيتنا، وهو أننا بأي رؤية نريد أن ننظر إلى هذه الظاهرة؟ ونسأل الله عز وجل أن تكون من النوع الثاني، وأن لا تكون سياسية محضة من جنس الانتصار السياسي على الخصوم!
نموذج من ذلة شاه إيران وحقارته في مقابل أمريكا
النقطة الثانية هي أننا لو أجرينا دراسة على تاريخ ثورتنا هذه؛ سواء تاريخ الأربعين عامًا من انتصارها، أو تاريخ الخمسة أو الستة والخمسين عامًا منذ انطلاق نهضة الإمام الخميني (رحمه الله)، سنرى – بحسب تخميني الشخصي – أن أهم عامل أدى إلى اندلاع هذه النهضة، ومن ثم إلى انتصار الثورة، هو العامل الثقافي؛ وهو الإمام الخميني نفسه، وفكره، ونظرياته، وإيمانه، وحبه للإسلام، وإلا فلم تكن جماهير شعبنا تملك تلك الثروات الطائلة، أو تحمل معلومات عسكرية وأمنية مهمة؛ فلم نكن نملك شيئًا في ميدان التجارة والصناعة والعسكر والأمن، وإن كان ثمة أشياء، فكلها تحت إشراف الولايات المتحدة. كنا في الحقيقة – ولو أن الوصف غير لائق - عبيدًا عند أمريكا! إن أمرَتنا بالتوجه يمينًا وجبَ علينا التوجه يمينًا، وإن أمرَتنا بالانحراف شمالًا فلا بد أن ننحرف شمالًا!
طالما نقَلتُ أنه قبل الثورة اندلعَت في محافظة ظَفار بعُمان قلاقل واضطرابات أثارتها ما يسمّى بـ"جبهة تحرير ظَفار". يومها أصدرَت أمريكا لشاه إيران أمرًا بضرورة إرسال قوات عسكرية إيرانية إلى عمان لإخماد الاضطرابات! حينها لم يكن أحد يجرؤ على القول: "وما شأننا نحن؟! عمان دولة عربية، ونحن هنا، فما شأننا نحن لنذهب ونخمد اضطرابًا هناك؟!" ولو فتح امرؤ فمه لقالوا له: "إنها الأوامر! إننا نبيعكم السلاح، وإن عليكم النزول عند أوامرنا!" ثم إنهم كانوا يبيعوننا هذا السلاح ببضعة أضعاف ثمنه، وينهبون أموال نفطنا بالمجّان، وفوق ذلك: يأمروننا: "اذهبوا وقاتلوا في بلد آخر، أرسلوا جنودكم هناك ليُقتلوا، من أجل تأمين مصالحنا نحن!" هذا كان وضعنا!
دور العوامل الثقافية في انتصار الثورة الإسلامية
العامل الرئيس الذي أدى إلى انقلاب تلك الصفحة من التاريخ هو العامل الثقافي؛ الدين، والله تعالى، وعزة الإسلام، وأمثال هذه الأمور، وإلا فإن الجماهير التي نشأت في تلك الحقبة، سواء في الجامعات أو في المراكز الأخرى، لم تكن تجرؤ على مثل هذه الأعمال. فأينما طُرحت قضية الإيمان، والله عز وجل، والإمام الحسين، والتضحية، وأمثال ذلك انطلقَت حركةٌ ما، وإلا فإنّ هَمّ الجميع كان بطونهم، إذ قد ترَبّوا على الثقافة الأمريكية! لكن بعد ذلك ماذا حصل؟! هذا العامل أصبح هو عامل انتصار الثورة. ثم تقدَّمنا على جميع الجبهات؛ العلمية، والتقنية، والصناعية، والسياسية، والدولية.. تقدُّمًا لم يكن أشدُّ الأشخاص تفاؤلًا يتنبّأ أنه سيبلغ هذا الحد! نعم المتفائلون جدًّا تنبَّؤوا ببعضه، أما أن يبلغ الحال بأن تشعر الولايات المتحدة نفسُها أن خصمَها في العالم هو إيران، وأن تتحوّل إيران المحور الأساسي للخطابات والناقشات السياسية والمقالات في أمريكا، فهذا ما لم يتنبّأ به أحد!
فماذا حصل ليتحوّل هذا "العبد" من تلك الحال إلى هذه؟!
حزب الله اللبناني ثمرة صغيرة من ثمار الثورة الإسلامية في إيران
في الجانب الصناعي، ولا سيما الصناعات العسكرية، وفي جوانب أخرى حقّقنا تطوّرًا اطّلَع العالم عليه، لله الحمد، ولا بد أن نشكر الله على ذلك؛ من عزٍّ حظينا به في المنطقة، وما بلغناه من مكانةٍ ريادية ونفوذٍ معنوي بين الدول الإسلامية، وكوننا أصبَحنا قدوة للكثير من الحركات حتى تعلّمَ الآخرون منا. وإن من جملة ثمار هذه الثورة هو حزب الله بلبنان! طالِبا علومٍ دينية، هما الشهيد السيد عباس الموسوي، والسيد حسن نصر الله، قَدِما إلى هنا أثناء الحرب مع صدام، فقال لهما الإمام الخميني الراحل (رضوان الله عليه): "اذهبا إلى لبنان وابدَآ العمل". فعادا إلى لبنان، وتوجَّها إلى بعلبك، وهناك أطلقا حركتَهما من أجل هذا اليوم. هذه واحدة من الثمار الصُغرى لهذه الثورة.
تقَصّي الإخفاقات الثقافية للثورة الإسلامية
نحن تقدَّمنا في جميع هذه الجبهات، لكن ماذا عن الجبهة الثقافية؟!
نعم، تارةً لا نريد الاعتراف أمام أنفسنا، فنقول: "الحمد لله، الكتب والبحوث والمحاضرات الدينية كثيرة جدًّا!" لكن حين نرجع إلى أعماقنا، خصوصًا أعماق مسؤولي الثورة ونُخبها والقائمين عليها، نراها خاوية جدًّا! فأولئك الذين ينبغي أن يكونوا بركانَ نشاط وطاقةً وقّادة وهائلة من الإيمان والمعرفة والحب والإقبال على الحقيقة والإسلام، نرى أن هذه الأمور باهتةً جدًّا فيهم! لعل إيمان الكثير من عوامّنا بالإسلام والدين يفوق إيمان مسؤولينا! حتى الطيّبين والصالحين منّا إذا أرادوا أن يخدموا بإخلاص تراهم يستلهمون أفكارهم من حزبِ كذا الأمريكي، أو الحزب الألماني أو الفرنسي الفلاني! اعتقادًا منهم أنّ هذا هو العلم ولا غير! وأن سبيل التقدُّم هي هذه، وأن علينا أن نذهب إلى هناك، ونتعلّم، ونحصل على شهادات الدكتوراه، ثم نعود إلى بلدنا لتطبيقها! هذا فضلًا عن المندَسّين ومَن لا إيمان له أصلًا، فهؤلاء وضعهم معلوم ولا عتَب عليهم.
إن علينا أن نُقرّ بأننا في مركز الثقافة الإسلامية [قُم] ضعفاء ثقافيًّا، فما بال الدوائر الأبعد عن المركز؟! لا ينبغي للمرء أن يبوح بكل شيء، بل لا لزوم للبوح به أصلًا، لكنني أُشير مجرد إشارة: إننا، في مركز دائرة ثقافتنا، ما زلنا نناقش أنه: ما هي ولاية الفقيه أصلًا؟! وأنه: أساًسا هل لدينا في الإسلام والفقه الإسلامي شيء يُدعى الحُكم الإسلامي أيضًا؟! نعم، لدينا قضاء، لكن ليس لدينا حُكم ودولة! هذا في مركز ثقافتنا الإسلامية! أما في الدوائر الأبعد عن المركز فالكلام هو أنّ الإمام الراحل (رحمه الله) - في النهاية - كان قد استمد زخمًا من تيار ما، فأتى بحركةٍ ما، ولا يُدرى إلى متى يمكنه الاستمرار في حركته هذه، وأنه لا بد لنا من الجلوس على هذه المائدة والانتفاع منها قدر المستطاع!
وعلى الرغم من أن الإمام (قدس سره) كان قد أَولى اهتمامًا كبيرًا للجانب الثقافي منذ اليوم الأول، ومن أجل هذا أُغلقَت الجامعات مدة من الزمن بُغية تغيير وضعها الثقافي، لكن الظروف – في النهاية - لم تتهيأ بالشكل الذي ينبغي، واقتضَت الضرورة أن تَستأنف الجامعات نشاطها، وتراجعَت سرعة تلك الحركة.
الاهتمام بالثقافة هو روح بيان الخطوة الثانية للثورة
ولو دققتم النظر اليوم في بيان الخطوة الثانية للثورة لرأيتم أن روحه ولبه هو القضية الثقافية. كل ما هنالك هو أنه لو ركَّز سماحة الإمام القائد (حفظه الله) على الجانب الثقافي فقط والشعب يعاني هذا الغلاء والصعوبات المادية والاقتصادية وما إليها، لما لاقى الأمرُ قبولًا بين أفراد المجتمع، لكن سماحته - بكل ما أوتي من فراسة وبراعة - أودَع هذه الروح في هذا البيان. وإن الخبير يفهم ما هو محور هذا البيان ولُبه من أوله إلى آخره!
على أية حال، فيما إذا أسّسنا نحن جبهة ثقافية فعلينا نحن أن نلتفت إلى أنه - أولًا - ما الضعف الثقافي الذي نعاني منه نحن أنفسنا؟ وكم ستكون أجيال المستقبل متخلّفة عن مستوانا الثقافي هذا؟ بالنسبة إلى جيلنا نحن، فلقد كان الإمام (رحمه الله) بلَحمه ودَمه بيننا، وهو الرجل الذي كان كلامه يُعَد آخر الكلام وفصل الخطاب؛ فكانوا إذا أرادوا فتح باب ثقافي معين، اتخذوا جملةً من كلام سماحة الإمام عنوانًا، فكانت – بلا تشبيه – كالوحي المنزَل، أما شباب جيلنا الحالي فإنهم لم يروا تلك الحقبة، ولم يعيشوا أيام الجبهات، ولم يعانوا مَشقّات الحرب، ولم يرَوا التخريب والدمار والقصف.
أهم أهداف الغزو الثقافي هو إضعاف الدين والإيمان
الأطفال أخذوا من عمر الرابعة أو الخامسة يستأنسون بالجوالات حتى انتصاف الليل، سواء بلُعَبها أو بأفلامها! يَقضون الوقت معها وحيدين في الحجرة أو في فراش النوم. حتى أنهم لم يعودوا يأنسون بوالديهم! واقتصرَت علاقتهم بهما في حدود الجلوس على المائدة لتناول بضعِ لُقَيمات، بل قد يُضطرون لأخذ شيءٍ [من الطعام] إليهم أيضًا! وإن الأمور التي تُبَث في هذه الجوالات، من خلال مئات شبكات التواصل وأمثالها الـمُتاحة للكل والموضوعة عبر الإنترنيت في متناول أيديهم، هدفها جميعًا إضعاف دين الأطفال والشباب وإيمانهم، بصوَر شتّى، وبمهارة عالية، استلهموها من مبادئ علم النفس، وجرّبوها على مدى مئات السنين أثناء استعمارهم للبلدان المختلفة. فهم [الأعداء] يعملون في هذا المجال، ولو أنهم يَئسوا من كل شيءٍ وطريقةٍ فإنهم لم يَيأسوا من هذه، بل إنهم الآن يضعون كل أملهم في هذا المجال. فلو يئسوا من الحَظر الاقتصادي فإنهم لم ييأسوا من أن يستطيعوا التأثير في أجيالنا الشابّة وإضعاف إيمانها، فهم يشتغلون على هذا الخط بكل ما أُوتوا من قوة. على أنهم لا يقفون مكتوفي الأيدي حيال الشرائح الأخرى من المجتمع أيضًا.
إشاعة العلمانية خيانة المثقفين للإسلام والثورة
وما زال بعض الأساتذة، وأحيانًا أشخاص ممن لا نتوقع ذلك منهم أبدًا يتفوّهون في قاعات درس جامعاتنا علَنًا بكلام عجيب؛ مثلًا: "ما علاقة الدين بشؤون الدنيا؟! الدين هو العلاقة بالله تعالى، هو الصلاة والعبادة، وبعض العزاء على سيد الشهداء (عليه السلام)، ومن ثم ندخل الجنة. أما الحكم والدولة فهما مهارات وعلوم وينبغي للمرء أن يتعلّم علومها. لا بد للمرء من امتلاك الخبرة العملية والمهارة لكي يستطيع إدارة الدولة. فليس بمقدور الصلاة والصيام أن يديرا دولة! وأين علوم الحكم والدولة؟ أهي في القرآن؟! كلا، فليس في القرآن إلا: (وَأَقيموا الصَّلاةَ وَآتوا الزَّكاةَ).[2] إذًا يتوجّب علينا السفر إلى البلدان الأجنبية وتعلّم مناهجها وأخذ شهادات الدكتوراه منها ثم العودة لتطبيقها هنا. بل إننا نـَمُن عليكم أن ندير بلدكم من أجلكم لكي تتفرغوا أنتم لدينكم وتعملوا به! وإلا فإن هذه القضايا تخضع لعلوم، وإن لكل واحدة منها عشرات الفروع والاختصاصات العلمية التي يجب الاجتهاد في تعلّمها وممارستها. وإن من هذه الأمور الشؤونَ العسكرية التي ترون. فهل تراكم تعلّمتموها من القرآن يا ترى؟! وكذا الحال مع الشؤون الأخرى. فإن إدارة البلاد هي الأخرى علم يجب أن يُدْرَس. صحيح أنه جاء في القرآن الكريم قوله: (إِنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسان)،[3] وكلنا يعلم هذا، أما أنه: كيف ندير البلاد ونحكُمها؟ فهذا ما لا صلة للدين به!"
هذه الأمور تملأ أذهان بعض خواصّنا! وإنهم إن لم يتفوّهوا به فلأنهم لا يجرؤون على ذلك، وإلا فإن ما يَعتلِج في صدورهم ويدور في عقولهم يُفهم من بعض الكلمات التي تفر من أفواههم بين الحين والآخر؛ وهو أن "واجبنا هو تأمين اقتصاد شعبنا وأمنه، وكل ما عدا ذلك فهو واجب الحوزات!" وهذا بالضبط ما قصدتُه، إنه العلمانية بعينها! يعني: "الدين للحوزة، وإدارةُ الدولة لنا! فلا أنتم تُقحمون أنفسكم في عمَلنا، ولا نحن لنا صِلة بما تعملون؛ نحن لا نقول: صَلّوا أو لا تصلّوا، وأنتم أيضًا لا تَدُسّوا أنوفكم في هذه الأمور، بل إنكم أينما أقحَمتم أنفسكم أفسَدتم الأمور!"
التفاوض مع الولايات المتحدة وفراسة الإمام القائد
في قضية بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة وأوربا كانوا ينتظرون أن ينهاهُم الإمام القائد الخامنئي (دام ظله) قائلًا: "لا تفعلوا"، ليقولوا من غَدِهم: "أرأيتم؟! إنه لا يَفهم في هذه الأمور، وهذا هو السبب وراء كل بلاء حل بكم!"
لكن الإمام القائد قال لهم، بما أوتي من الله من فراسة: "لا بأس، تفاوَضوا، لكن ضمن هذه الخطوط والمبادئ." وبهذه الطريقة جرّدَهم من سلاحهم، ثم نبّههم أيضًا بالقول: "إننا لا نأمل من هذه المفاوضات خيرًا، وإن القوم لا ثقة بهم!" وكان هذا متوقّعًا. وقد اضطروا، بعد ست أو سبع سنين، إلى الاعتراف بذلك، وإن كان بعضهم ما زال لا يريد الاعتراف! لأنهم إن فقَدوا هذا أيضًا فلن يعود في أيديهم شيء. هذه حقائق مجتمعنا.
مستلزمات تشكيل الجبهة الثقافية للثورة الإسلامية
لكن ما الذي يتعيّن علينا صنعه إن شئنا تشكيل جبهة ثقافية؟ أول معضلة سنواجهها هي: "ما معنى الثقافة أساسًا؟"
أيام كنا صغارًا وكنا نذهب إلى المدرسة كانت تعلو باب مدرستنا يافطةٌ كُتب عليها: "وزراة الثقافة، مدرسة سعدي الابتدائية". الوزارة في ذلك الزمن كانت "وزارة الثقافة" وكانت التربية والتعليم وما يتصل بهما تصنَّف في خانة الثقافة. لكن في أيام "البهلوي الثاني"[4] أصبحت الثقافة قرينة للفن، فتأسسَت "وزارة الثقافة والفنون". ما هي تلك الثقافة؟ إنها الموسيقى، والرقص، والرقص الوطني، ...إلخ. هذه الأمور صارت هي الثقافة، إنها ثقافتنا الوطنية! ومنذ ذلك الحين اقترَن الفن بالثقافة، وحُذفت كلمة "الثقافة" من الأولى، فصار اسمها "وزارة التربية والتعليم".
وما زال هذا الإرث محفوظًا إلى يومنا هذا بشكل من الأشكال. سماحة الإمام الخميني (رحمه الله) حينما كان يقول: "ثقافة"، كان يعني شيئًا، أما إذا قلنا نحن: "ثقافة" فالثقافة في ذهننا هي ثقافة أيام الشاه، الثقافة والفنون؛ وهي التقاليد، والأعراف الوطنية، وأن على الشعب أن يحافظ على استقلاله، ويصون قوميّته! في النهاية هذه هي الثقافة! لا يُنتظَر منها استدلال منطقي وبرهاني. الناس يحبون أن تكون الأمور هكذا، فتُصبح هذه الأمور ثقافة! بل هي أساسًا قضية لا صلة لها بالعلم والمعرفة والحقيقة وما إلى ذلك. إذًا هذا أول الكلام؛ وهو أنه: ماذا تختارون؟ أصلًا ما معنى أنْ تُعَرّفوا أنفسكم بأننا نريد أن نمارس عملًا ثقافيًّا؟!
ولنفترض أننا تجاوزنا هذه المرحلة، وأننا أيضًا قَبِلنا وأحببنا – بإذن الله - ذلك المعنى من الثقافة الذي كان سماحة الإمام الراحل يقصده. السؤال الآن هو: إن كنا نريد ممارسة العمل الثقافي، فمن أين نبدأ، وإلى أين ينبغي أن نصل؟ ما هي مستلزمات هذا العمل؟ فلو كان مرادنا تلك الثقافة المرادفة للفن والمقترنة به، فبوسعنا تعلّمها من العالم، أما إذا كان مرادُنا هو "الثقافة الإسلامية"، التي أساسها الإيمان، والاعتقاد بالله تعالى، وبأبدية الإنسان، وما إلى ذلك، فمن أي بقعة من العالم نأخذها؟
مناقشة أسباب عدم التنمية الثقافية في بلدنا
ما أود أن أقوله هنا هو: إن أحدَ أسباب عجزنا في التقدم على الصعيد الثقافي هو أن المجالات الأخرى كان لها نماذج تَحتذي بها؛ فنموذج الثورة الاشتراكية كان الاتحاد السوفيتي، ونموذج الماركسية كان الصين، ونماذج الأشياء الأخرى بلدانٌ أخرى، هذه كانت نماذج. في تلك البلدان حصلَت ثورات، وكان باستطاعتنا أن نختار من بينها ما يناسب بلدَنا أكثر. لكن الثقافة الإسلامية أين طُبّقَت؟! هناك ثقافة تكفيرية وهّابية مركزها مَهد الإسلام [مكة]، وهي موضع سخرية العالم بأسره، ثقافةٌ لا يرتضيها الله تعالى، ولا رسوله، ولا أي إنسان عاقل! أفَنجعل من هذه الثقافة نموذجًا لنا؟! [بالطبع كلا]، إذًا من أين نأخذ نموذجَنا؟! الجواب: نحن مَن يجب أن يصوغ هذا النموذج، وهذه هي إحدى العقبات التي تواجه عملنا.
لو كان الأمر يتصل بأي مجال آخر لكان بوسعنا أن نقول: "نأخذ نموذجَنا من البلد الفلاني." لو كنا في بلد آخر لكان بوسعنا - على الأقل –أخذَ النموذج من كوريا الشمالية مثلًا! لو أن أهلَ بلدٍ آخر هم المبتلون لكانوا فعلوا ذلك؛ فإما أن نتعاون، أو نتّبع نموذجهم، أو نُبرم عقودًا في الخفاء! كُنّا سنفعل أمثال هذه الأمور، ونقول: فعلناها وانتهى الأمر! لكن من أين نأخذ نموذجنا الثقافي، وبمن نستعين في ذلك؟! بل الأدهى - حينها - أننا نحن أنفسنا لا ندري ماذا نريد أن نصنع؟! فإن لم نأخذ نموذجنا من الآخرين كان من الجميل أن نملك نحن هدفًا جليًّا واستراتيجية واضحة! لكن المشكلة أننا أنفسنا مختلفون فيما بيننا. هناك مفاهيم غامضة طُرحَت لا نملك لها تفسيرًا واضحًا، فما بالك بأن نعرف استراتيجياتها! بل أن نضع لها التكتيكات، ونصمّم الأساليب العملية، والمناهج التنفيذية!
الثورة الإسلامية والتحول الثقافي
لكن - لله الحمد – هناك خطوات اتُّخذت في هذا المجال ببركة إرشادات سماحة الإمام الراحل (رضوان الله عليه)، وإن مجتمعنا اليوم يختلف اختلافًا كبيرًا عن مجتمع ما قبل الثورة من ناحية اطّلاعه على الثقافة الإسلامية، لكن ما زالت المسافة التي تفصله عن الهدف المنشود شاسعة؛ فما زال الغموض الذي يلُفّ هذه الأمور كبيرًا جدًّا، أضف إلى ذلك وجود جماعات مقتدرة تحمل تلك المعاني الخاطئة، وتدعمها، وتوظّفها مثل ما تشاء. يقولون: "الإمام قال ثقافة، أجل أجل، الثقافة! الإمام هو الذي طرَحها!" لكن ما هي هذه الثقافة التي يعنون؟ إنهم يروّجون لأمور باسم الثقافة، كان الإمام الراحل يَعُدّها مناهضةً للثقافة!
إننا لا نملك مفهومًا واضحًا للثقافة، ولا نعرف ماهيّتها، لكي نقول: "ما دام الإمام الراحل قال كذا فيجب أن يُفعل ذلك"، فضلًا عن أن تكون مبادئها محدَّدة، واستراتيجياتها معيَّنة، بحيث يكون بوسعنا أن نصوغ على أساسها خُطة تنفيذية بما يناسب ظروف الزمان والمكان. هذا ونحن كثيرًا ما نجد أن جماعتين متديّنتين ثوريّتين في مدينة واحدة تختلفان فيما بينهما حول القضايا الثقافية! فكيف لنا أن نؤسس لجبهة ثقافية؟!
ضعف المعتقَدات خطرٌ يهدد أهمية الجهاد الثقافي وضرورته
إذًا لا بد من الجهاد وإيضاح هذه المسائل الأساسية قبل فوات الأوان، ولو أننا عُدنا إلى التقاعس ولو لمدة قصيرة أخرى فمن غير المعلوم أننا سنستطيع تدارك الأمر لاحقًا! فالجيل الجديد المشغول بشبكة الإنترنيت الحالية لا يُدرَى إن كان سيبقى معتقدًا بالإسلام والثورة! هذا هو وضعنا، شئنا أم أبَينا! فأطفالنا يكبرون مع هذه الوسائل. في الآونة الأخيرة كرّرتُ هذا الكلام عدة مرات ليكون له مصداق عيني. إن لنا قسمًا يتلقّى الأسئلة المكتوبة المرسَلة لنا، ونحن نجيب عليها. عادة يمكن أن يُفهم من لهجة المرسِل وطريقة كتابة السؤال أنه من أي صنف من الناس هو.
ذات مرة كتب لنا رجل، يُفهم من لهجته وأسلوبه أنه خريج جامعة، فقال: "هناك أعمال أعلَم أنها حسَنة، فأحاول جهدي فعْلَها على أحسن وجه، وأعمال أخرى أعلَم أنها سيئة، فلا أفعلها، وما عدا ذلك لا شأن لي إن كان هناك إله أو لم يكن، أو كان ثمة قيامة أو لا، فما شأن الله بي؟! من أجل ماذا يريد أن يرميني في نار جهنم؟!" هذه الرسالة وصلَتنا في العام الماضي.
ولا أنسى في العام 1953 في طهران، إذ كان هناك حوار بين شخصين، أذ قال أحدهم: "إن على المرء أن يكون متديّنيًا، ويكون، ويكون... لكي يَصلُح وضع المجتمع." وحين انتهى هذا من الكلام قال الآخر: "أنا أعتقد أن على المرء أن يكون إنسانًا صالحًا، سواء كان متديّنًا أو لم يكن! فالصلاح غير التديُّن؛ التديّن يعني أن تصلّي، وتردد الأذكار، وتكون إنسانًا خيّرًا، وتساعد الناس، وتقول الصدق، وتنجز عملك على أحسن وجه... هذا هو التدين." ما زلتُ أذكر هذا الحوار الذي دار بين شخصين في العام 1953 وكنتُ شاهدًا عليه. اليوم نرى أن هذا الرجل الخريج يقول الكلام نفسه؛ وهو أني أفعل الخير ولا شأن لي إن كان الله موجودًا أم لا! فليكن أو لا يكُن! أنا لا عداوة لي معه، فلماذا يأخذني إلى النار؟!"
إننا دومًا نُصر أن يعتقد الناس بالله، لكن هذا الرجل يقول: "أَفعَل الخير! فما الضير أن أقول في قلبي: الله موجود أو غير موجود؟!"
هذا الفكر يروَّج له من خلال الأفلام، والفديوهات، وألعاب الأطفال، وما إليها. على هذه الصورة سيصبح جيلنا القادم، ونحن نضرب على رؤوسنا دائمًا أنه: ما الذي فعلناه؟! كان المجال مفتوحًا أمامنا أربعين عامًا، ولم نقُم بعمل جذري! بماذا سنجيب الله تعالى إن سألنا؟! أربعون عامًا لم تكن مدة قصيرة؛ كان على رأسنا حاكم مثل الإمام الخميني، ثم استلم الإمام القائد دفّة الثورة من بعده ثلاثين عامًا، لكننا لم نُتح له المجال! وإذا ما قال شيئًا ما، أدخلناه من هذه الأذن وأخرجناه من الأخرى!
التحوّل الثقافي هو أساس الثورة الإسلامية
برأيي إنه يتوجب علينا نحن أن نعرف جيّدًا: ما هي الأمور التي تشكّل أساس الثقافة الإسلامية وجذورها؟ ثم أي جِذع تُنبت هذه الجذور، وأيّ أغصان رئيسية تعطي؟ حتى يصل الدور إلى الأغصان الفرعية والأوراق. فلو أني ركّزتُ اهتمامي على غصن واحد، فماذا نصنع بذاك الغصن الذي اصفرَّت أوراقه؟! ولنفرض أننا سقيناه بعض الماء، فنبتت منه بضع وريقات خضراء، لكن هذا لن يصلح الشجرة كلها! إن جذور شجرة الثورة هذه هي ثقافتها، وعقائدها، ومعتقداتها، وقِيَمها. هذا هو أصل الثقافة وأساسها. فماذا نصنع لتكون عقائد أجيالنا القادمة سليمة، وتكون الـمُثُل والقيم هي محور سلوكياتهم؟ كم عملنا في هذا المجال، وكم نحن ناجحون؟!
لو أن حرب الثماني سنوات لم تقُم، ولو أن الذين خاضوا ميادين الشهادة وبذلوا أرواحهم بسخاء فيها لم يُقْدِموا على ذلك فلربما ما كانت روح التعلق بالمعنويات وما وراء الطبيعة هذه لتبقى في أفراد مجتمعنا! وإن هذا القليل الذي نملكه منها اليوم هو رهن دماء الشهداء. وإنْ نحن تقاعسنا عن اتخاذ إجراء بطريقة معقولة أخرى أسهل، فلربما اقتضَت حكمة الله تعالى مرة ثانية أن تقوم حرب أخرى، لتُنفَخ في هذا المجتمع روحٌ جديدة! ما أدرانا؟! فلولا تلك الحرب، أكان سيظهر ذلك الفتى ذو الثلاثة عشر عامًا[5]؟! أمثاله كانوا يلعبون في الأزقة، حالهم حال باقي الأطفال. أكان سيظهر مثل أولئك الشهداء الذين يتوسلون، وهم في بداية المراهقة، أن ادعوا لنا بالشهادة؟!
لطالما صادف في أسفاري أن أتاني فتى لا يتجاوز الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من العمر فقال لي: "شيخنا، عندي كلام أود أن أقوله لك على انفراد"، وحين أنفرد به يقول: "ادعُ لي أن أموت شهيدًا!" طفل في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة! كم اشتغَلنا من أجل هذه الثقافة؟! هذا عمل الله تعالى. لقد فُتحَت لنا أبواب جبهات القتال، وقد أدارها الإمام الخميني (رضوان الله عليه) بما جعل مثل هذه الورود تَنبُت وتكبر، وإلا فلو تُرك الأمر لنشاطاتنا السياسية وأعمالنا الثقافية لما نشأ شيء من هذه الأمور!
أولًا علينا نحن أن نؤمن بأن الثقافة هي أصل الثورة. ومن ثم نتفحّص معتقداتنا وقيَمنا فإن وجدنا فيها نقصًا هنا أو هناك عمَدنا إلى ترميمه. ثم نفتش عن الطريقة التي ننقل بها هذه المعتقدات والقِيَم إلى المجتمع. بالطبع الأرضيات المطلوبة لهذا العمل موجودة، لكن لا بد من تلاقح الأفكار، بمزيد من الإخلاص، مع مَن نتوقّع أنه يمكن مساعدتهم في هذا المجال. نسأل الله تعالى بمعونته، ومن خلال التوسل بصاحب العصر والزمان (أرواحنا فداه) أن نتمكن من اجتياز هذه المرحلة بسرعة ونجاح، المرحلة التي هي روح بيان الخطوة الثانية للإمام القائد (حفظه الله).
أسأل الله عز وجل أن يضاعف لكم توفيقاتكم ويجعلكم ذخرًا لمستقبل هذه الثورة.
[1]. إشارة إلى البيان الذي وجّهه الإمام القائد الخامنئي (دام ظله) إلى الشباب في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران الذي عَدّ فيه أن إنجازات الثورة في الأربعين عامًا المنصرمة كانت الخطوة الأولى وأننا على اعتاب اتّخاذ الخطوة الثانية، وأسماه "بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية". [المترجم]
[2]. البقرة: الآية43.
[3]. النحل: الآية90.
[4]. محمد رضا شاه، آخر شاه لإيران قبل انتصار الثورة.
[5]. يقصد حسين فهميده، الذي نفذ عملية استشهادية برتل دبابات. [المترجم]