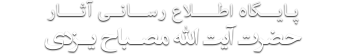قيمة هداية عباد الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهُمّ كُن لوليِّكَ الحجّةِ بنِ الحسن، صلواتُكَ عليهِ وعلى آبائِه، في هذهِ الساعَةِ وفي كلِّ ساعةٍ، وليًّا وحافِظًا وقائِدًا وناصِرًا ودَليلًا وعَينًا، حتّى تُسكِنَه أرضَكَ طَوعًا وتمتِّعَهُ فيها طويلًا.
أشكر الله تبارك وتعالى أن وهبَني الحياة وأفاضَ عليّ التوفيق لأن أكون في خدمتكم أيها الأعزة في هذه الأيام المباركة وهي ذكرى مولد النبي الخاتم (صلّى الله عليه وآله) وابنه الإمام الصادق (عليه السلام). وإني لأرى في حضور السادة والمشايخ هنا عيدِيّة أتحفني بها أهلُ البيت (صلوات الله عليهم أجمعين) وأرجو الله تعالى أن أُشمَل دومًا بدعواتكم في الخير.
الإنسان والغفلة هما من نِعم الله تعالى!
حين نَنعم نحن معاشر البشر بنعمة ثابتة فنأنس بها ونعتاد عليها، فإننا ننسى أهمية هذه النعمة. على سبيل المثال، إن أصل النعم هي نعمة الحياة، وهي أن نكون على قيد الحياة، لكن كم مرة خلال اليوم والليلة تخطر في بالنا هذه النعمة التي أنعمها الله علينا، وهي أننا أحياء؟! أنا نفسي لا يخطر في بالي أبدًا أن هذه نعمة من النعم التي يمُنّ بها الله علينا. ثم تأتي بعد نعمة الحياة نعمة السلامة؛ وهي أن كل عضو في بدننا، من الدماغ في الرأس حتى ظُفر إصبع القدم، هو عرضة لآلاف الآفات في كل لحظة لكن الله يدفعها عنا فنبقى سالمين. أي: ما عدا نعمة الحياة، فإن الله عز وجل يُفيض علينا في كل لحظة آلاف النعم، التي تشكّل بمجموعها سلامةَ البدن من غير أن نلتفت إلى أن الصحة والسلامة هي نعمة من النعم. فما إن نُصاب بالمرض حتى نقول: عجبًا! عجبًا! قبل بضعة أيام لم أكن هكذا أما الآن فهذه هي حالي! فكأنّ السلامة أيضًا هي شيء ما! ولعل الإنسان إذا طال مرضه يحدّث نفسَه أن: إذا شُفيتُ من مرضي فسأعرف قدر سلامتي وأَحذَر من الممارسات المضرّة بالصحة، أو سأفعل كذا وكذا. لكن ما إن تمر بضعة أيام على شفائه حتى يغيب ذلك عن باله فيعود إلى سابق عاداته! وهذه الميزة موجودة في أغلب الناس وهي أنهم ينسون أهمية النعم التي يُنعمها الله تعالى عليهم.
نِعَم تفوق النعم المادية!
ثم بعد النعم المادية تلك يأتي دورُ النعم المعنوية؛ وهي نعمة الإسلام نفسه، ومعرفة حقيقة الإسلام، والله، والرسول (صلّى الله عليه وآله)، والأئمة الأطهار (عليهم السلام) التي تضم كل واحدة منها مئات النعم. ونحن نَعُد هذه النعم جميعًا نعمةً واحدة تحت عنوان "معرفة الدين الحق" مع أنها تنطوي على مئات النعم الثانوية. متى ما خطَر ببالنا نقول: الحمد لله أنْ مَنَّ علينا بنعمة الإسلام. فحين نلتفت إلى أن المسلمين في العالم كثيرون ومختلفون في الملل والمذاهب، ثم نعرف أننا - نحن الذين تلطّفَ الله تعالى علينا، بعد الدين الحق، بالمذهب الحق وعرّفَنا به – نشكّل قِلّة بين مليارات البشر - حين نلتفت إلى هذا كله سنعرف أن هذه نعمة خاصة أسبَغها الله على طائفة من المسلمين هم الشيعة من بين مليارات البشر. أفلا تستحق هذه النعمة الخاصة شكرًا خاصًّا؟! فما خلا نعمتَي الحياة والسلامة التي وهبها الله لجميع البشر، مؤمنهم وكافرهم، فإن هذه النعمة؛ وهي أن نكون من الشيعة الذين يمثّلون نسبة قليلة من البشرية البالغة بضعة مليارات نسَمة - هذا إذا لم نأخذ السابقين واللاحقين بالحسبان – وأنّ الله سبحانه وتعالى قد مَنّ علينا بنعمة معرفة أهل البيت (عليهم السلام) والمذهب الحق – أقول: هذه أيضًا تمثل جانبًا آخر من النعم العظمى التي تفوق النعم المادية، بل لربما تحوّلَت سائر النِعَم إلى نِقَم في حالِ فقدان تلك!
تحوُّل النعمة إلى نقمة!
افترضوا لو أن نعمة الحياة التي ننعم بها كانت سببًا في عصياننا ثم دُخولنا نار جهنم، فأي نعمة هذه يا ترى؟! يقول تعالى: (أَلَم تَرَ إِلى الَّذينَ بَدَّلوا نِعمَتَ اللهِ كُفرًا وَأَحَلّوا قَومَهُم دارَ البَوار)،[1] فالإنسان أحيانًا قد يستبدل بنِعَم الله تعالى عذابًا! فإنّما تكون هذه النعم نِعمًا إذا تبلورَت كلّها بالإسلام والتشيع وإذا وظَّفناها للعمل بواجباتنا الإسلامية والشيعية.
نعمة تعلُّم معارف أهل البيت (صلوات الله عليهم أجمعين) وتعليمها
كم بالمئة من جميع شيعة العالم يوفَّقون لإمضاء سنين طويلة في تعلّم علوم أهل البيت (عليهم السلام)؟! فها نحن من بين أقل الأقلين، أي أقلّية من الأقلّيات قد وُفّقنا للانتفاع من نعمة أن نتمكن من قضاء سنين طويلة - البعض أقل والبعض طيلة العمر - في الحوزات العلمية في تعلّم علوم أهل البيت (عليهم السلام). فبأي مقدار ينبغي أن يزيد شكرُ هذه النعمة على شكر سائر النعم؟ ولربما غفلَ معظمُنا عن أن هذه نعمة، نعمة أعظم من جميع النعم، وتتطلّب شكرًا أجزلَ من كل شكر. بل لعلنا لا ننسى فحسب أننا مدينون لشكر هذه النعمة، بل نرى أننا نحن أصحاب الحق فنقول: "أجل، نحن نخدم الدين ولا بد أن يسجَّل لنا هذا امتيازًا!"
والآن، من بين الدارسين في الحوزات العلمية ومن أمضَوا خمس سنين أو عشرًا أو عشرين سنة في مراحل شتى يدرسون العلوم الحوزوية وينتفعون من معارف أهل البيت (صلوات الله عليهم أجمعين) كم بالمئة منهم يوفَّقون إلى نقل هذه المعارف إلى الآخرين؟! فهناك الكثيرون ممن بذلوا في الحوزة العلمية جهودًا جبارة، ودرسوا مدة أربعين أو خمسين عامًا، وبالَغوا بالدقة في تحصيل العلوم فغدَوا في نهاية المطاف مدرّسين في الحوزة؛ إنْ ترجّاهم أحدٌ بأن يعطوا درسَ "رسائل" أو "مكاسب" أعطَوه، وإن لم يطالبهم أحد بذلك فلا شيء، وكأنه ليس في أعناقهم واجب نقل هذه المعارف إلى الناس! أما الذين توصّلوا بأنفسهم إلى أن عليهم أن ينهضوا بهذه الـمَهَمّة، فراحوا يبلّغون الدين في ناحية أو قرية أو مدينة أو حي، وينشرون تعاليمه، فإن مقدار نجاحهم في هذا الطريق يعتمد على أنه كم من الناس يعرفونهم، ويعرفون قَدْرَهم فينتفعون من وجودهم.
توفيق الخدمة ضمن النظام الإسلامي
فلو كان لبعضهم مسؤولية رسمية حتى إذا دخلَ مدينةً ما قال الناس: فلان هو الذي يؤُمّ الجماعة في هذا الحي، فإن طرأَت للناس مشكلة يعرفون لمن يرجعون من دون ما حاجة إلى أن يبحثوا بأنفسهم ويفتّشوا فردًا فردًا ليتوصّلوا إلى عالم هذه المنطقة. فأن يكون للمرء منصب ومسؤولية فإن هذا يهيئ الأرضية لأن يرجع الناس إليه، وبطبيعة الحال فإن توفيقه إلى الخدمة لا يقاس بالشخص المغمور الذي اتّخذَ ركنًا قَصِيًّا، فمع أنه عالم ومؤهَّل للخدمة فإن الناس لا يعرفونه فلا يرجعون إليه. فمجرد أن يكون للشخص ضمن النظام الإسلامي مسؤوليةٌ رسمية مقدّسة يعرفه الناس بها فيلجؤون إليه في أمور دينهم تقرّبًا إلى الله وأداءً لواجباتهم الدينية فيستعينون به، ويكون في ذلك مقدمة لأدائه واجبًا ضخمًا ثوابه جزيل – أقول: أليس هذا بحد ذاته نعمة كبرى؟!
تخيّلوا أن يكون المرء عالمَ دين لكنه مجهول لا يعرفه الناس، ولا يرجعون إليه، ولذا لا يوفَّق إلى شيء؛ نعم، حصّلَ العلم، وأجرى أبحاثه، وهو مؤهَّل للعمل، لكن الناس لا يعرفونه؛ أي لم تشمله النعمة الإلهية المتمثّلة بكونه شخصية بارزة في جماعة من الناس بصفته خبيرًا في الأمور الدينية. فإن تولّي هذه المسؤولية الرسمية المقدسة بحد ذاته نعمة تفوق النعم جميعًا، فكم هي قيمة هذه النعمة؟!
قيمة عملية هداية العباد
وأود هنا التذكير بحديث شريف لا بد أنكم جميعًا قرأتموه وسمعتموه ونقلتموه. قصة الحديث أنه في أواخر حياة النبي الأعظم (صلّى الله عليه وآله)، وبعد عشرين عامًا من النبوة والرسالة، اعتنقَت جماعة من اليمنيين الإسلامَ، ثم نشبَت في اليمن بعد ذلك اضطرابات وقلاقل وفتن، فبعَث النبي (صلّى الله عليه وآله) أمير المؤمنين (عليه السلام) لحل الأزمة وإخماد الاضطرابات ودَرء الفتنة. وحين هَمّ (صلّى الله عليه وآله) بإرسال أمير المؤمنين (عليه السلام) وتوديعه قال له عبارات ليجعلها زادَ سفره، فإنّ من عادة كبرائنا إذا سافر أحد أن يزوّدوه بزاد لطريقه. ومن جملة ما رُوي أنه (صلّى الله عليه وآله) قال لأمير المؤمنين (عليه السلام)، ولعلّ نَقْلَه مستفيض إن لم يكن متواترًا: «يا علي لئن يهدي الله بك رجلًا خير لك من ملء الأرض ذهبًا تنفقه في سبيل الله». فإنني أبعثك إلى هناك لتُصلح أمور الناس، لكن اعلم أنك إن استطعتَ أن تهدي شخصًا واحدًا إلى سواء السبيل فإن لذلك من الأهمية والقيمة، أي من الثواب والنتائج المعنوية لك ما يفوق ثواب أن يكون لك ملء الأرض ذهبًا ثم تنفقه كله في سبيل الله عز وجل!
تخيّلوا أن يكون هذا المكان فقط مليئًا بالمسكوكات الذهبية فكم ستكون؟ ملء الأرض ذهبًا يعني جميع البوادي والسهول و... مملوءة ذهبًا ثم تَعمَد أنت، يا علي بن أبي طالب، إلى كل هذا الذهب فتنفقه في سبيل الله. لا أن يكون كل هذا الذهب ذا قيمة عندك، بل أن تكسب ثواب إنفاقه كله، ولو جمعتَ ثواب كل هذا ووضعتَه في كفة ميزان ووضعت في الكفة الثانية ثواب هداية شخص واحد فسترجح الكفة الثانية على الأولى! «لئن يهدي الله بك رجلًا خير لك من ملء الأرض ذهبًا تنفقه». ومع أن هناك فرقًا كبيرًا جدًّا بين إنفاق علي بن أبي طالب (عليه السلام) وإنفاقنا نحن فإنه على الرغم من كل ما للإمام علي (عليه السلام) من الإخلاص في الإنفاق يقول: إن هداية شخص واحد إلى الحق أفضل من كل هذا!
على أية حال، هذا مجرد فرض يستحيل تحققه أصلًا؛ فلا هناك أرض مليئة ذهبًا، ولا هناك هذا الكَم من الفقراء والمحتاجين لينفَق عليهم هذا المقدار كله، لكنه افتراض على أية حال، فلو استطعتَ أن تحسب هذا وتترجم تلك الكميات الضخمة إلى أرقام رمزية، فاعرف أن إرشاد شخص إلى الحق أفضل من كل ذلك.
لكن هل هذا الثواب خاص بالإمام علي (عليه السلام)؟ أهو خاصية هذا العمل عمومًا؟ أيُكتب هذا الثواب إذا كان الهادي هو علي (عليه السلام) فحسب؟ أم أن في هداية عباد الله تعالى مثلَ هذا الثواب وأنك يا علي لو قمتَ به لحصلتَ على الثواب ذاته؟ نقول: يبدو أن الأمر ليس بمعنى أن الله قد جعل إمكانية هداية العباد حكرًا على الإمام علي (عليه السلام) شخصيًّا ولا غير، بل هو مصداق لقاعدة عامة؛ وهو أن عملية هداية الناس لها مثل هذه القيمة. بالطبع نحن لا نكون الإمامَ علي (عليه السلام)، ولا هدايتنا تضاهي هدايته، كما أن مقدار إخلاصنا لا يناهز مقدار إخلاصه، لكنّ عملًا كهذا هذه ماهيته وهو ينطوي على مثل هذه القابلية، وكلما رفَعنا من عزائمنا أكثر استفدنا منه أكثر واغترفنا المزيد من بحر رحمة الله هذا المترامي الأطراف، حتى وإن لم يَبلُغ مجموعُ ثوابِ كل ما نقوم به، مهما اجتهَدنا، إذا رُكِم بعضُه فوق بعض، قيمةَ شعرةٍ من شعرات الإمام علي (عليه السلام)، فحساب هذا الأمر على حدة، لكنّ المراد - على أية حال – أنه إلى هذا الحد حسناتُنا الأخرى تختلف عن عملية هداية الآخرين؛ فلو جمَعنا ثواب كل ما نقوم به من صلاة، وقراءة قرآن، وتلاوة دعاء، وترديد ذِكر، وإقامة مأتم عزاء، وكل عمل لا ينطبق عليه عنوان هداية عبدٍ إلى الله تعالى – لو جمَعنا ثواب كل هذا لكان ثواب هداية إنسان واحد إلى الله أعظم منه.
الغفلة عن إرشاد الآخرين
أنتم ملتفتون إلى أنه كم هناك من إمكانية أمامنا للقيام بهذا الأمر كل يوم؟ منذ أن حظينا بهذا التوفيق إلى الآن كم من الناس كان بإمكاننا أن نهديهم؟ وكم انتفعنا من هذه الفرصة؟ بالطبع الهداية لها درجات، كما أن الأشخاص مختلفون، وإن لسلوكنا وقابلياتنا وقدراتنا البدنية والعلمية ومهاراتنا العملية وما إلى ذلك أيضًا درجات، لكن هذه ماهيّتها وهي تنطوي على هذه القابلية ونحن غافلون! فإن الروتين اليومي لحياتنا الشخصية وأعمالنا اليومية الروتينية تجعلنا نسهو عن أن لنا مثل هذه القابلية؛ فلقد وفّقنا الله تعالى إلى مثل هذا التوفيق وهيّأ لنا مثل هذه المؤهّلات والإمكانيات ونحن نفرّط بها مقابل لا شيء ولا ننتفع منها! فمرحى للذين أفادوا ولو بمقدارٍ يسير من مؤهلاتهم هذه؛ (طُوبَى لَهُم وَحُسنُ مَآبٍ).[2] نسأل الله تعالى ببركة الطيبين وببركتكم أنتم أيها الصالحون أن يوفّقنا نحن أيضاً إلى الانتفاع من بحر رحمة الله الواسع هذا.
اعتمادًا على هذه الرواية من اللائق أن نفكر جميعًا بشكل خاص في الموضع الذي نحن فيه والأرضية المهيَّأة لنا لنرى ما الذي بإمكاننا فعله لجعل أفراد أكثر ينالون درجات أعلى من الهداية؛ أي أن يتّخذ أفراد أكثر من حيث (الكَم) سبيلَ الرشاد، وأن يكون رشادُهم وهدايتهم أكبر قيمة من حيث (الكيف). وكيفية هذه الهداية نسبية، إذ ينتفع منها كل امرئ بقدره. ولقد وهَب الله تعالى بعضَ أوليائه توفيقات لا بد لنا من التحسّر عليها. على أن الله جل وعلا ليس بخيلًا، وإن علينا أن ندعوه ليتلطف علينا بمثلها.
الإمام الخميني (رضوان الله عليه) نبراسُ نهج الهُدى
ولقد تلطّف الله عز وجل في زماننا بمثل هذا التوفيق على رجل كالإمام الخميني (رضوان الله عليه)، وهو رجل مثلنا. ففي زمان من الأزمنة كانت معلومات الإمام الراحل في حدود معلوماتنا؛ كان طالبًا حوزويًّا شابًّا، وشيئًا فشيئًا أصبح (الإمام الخميني)! فهو لم يولَد إمامًا، بل كان في البدء طالب علم بسيط يدرس العلوم الحوزوية في مدينة أراك. وحين انتقل سماحة الشيخ عبد الكريم الحائري (رحمه الله) إلى قم هاجَر عدد من طلبة العلم أيضًا إليها وكان منهم الإمام الراحل، فتتلمَذ على المرحوم الشيخ الحائري وبعض الأساتذة الآخرين في قم، حتى أصبح هو أستاذًا. حين قَدِمتُ أنا إلى قم قبل حوالي ستين ونيفًا من السنين كان الإمام (رضوان الله عليه) يلقي درسًا في الأصول أوقاتَ العصر في مسجد (تقاطع المتحف)، الذي هو الآن مُلحق بمبنى المرقد المعصومي الطاهر. كان تلامذته قلة، لكنهم أخذوا يزدادون عامًا بعد عام حتى أخذَت قاعة الدرس تضيق بهم وصاروا يقفون في الشارع مُصغين إلى الدرس، مما اضطر الإمام (رضوان الله عليه) إلى نقل صفه إلى (مسجد السلماسي). قصدي أنه (رحمه الله) كان واحدًا من بين عدة أساتذة حوزويين بقم، ولم يكن أمثاله فيها قلّة، بل لعل بعضهم كان له امتيازات أكثر من جهاتٍ خاصّة. فعلى سبيل المثال، في ذلك الحين كان المرحوم السيد محمد محقق الداماد، صهر سماحة الشيخ الحائري، يلقي في مسجد الإمام درسًا، وكان من بين تلامذته المعروفين السيد الشبيري، والشيخ مكارم الشيرازي، والسيد الموسوي الأردبيلي، والشيخ المشكيني، وكان يحضر درسه أيضًا عدد كبير من طلاب العلم، فكان صفه مُكتَظًّا جدًّا. كان درسه يقام في قاعة المسجد المسقَّفة الواقعة أعلى السرداب ويحضره جمع يُعتَد به من أبرز فضلاء الحوزة العلمية آنذاك. وكان من بين المتتلمذين في درس الإمام الخميني (رضوان الله عليه) فضلاء أيضًا، أشهرهم الشيخ جعفر السبحاني، الذي كان يكتب تقريرات درس الإمام (رحمه الله).
من حيث عدد الفضلاء الذين كانوا يحضرون درس الإمام كان حُضار درس السيد الداماد أضعاف أولئك وقد غدوا جميعًا مراجع تقليد؛ مثل السيد الموسوي الأردبيلي، والشيخ المشكيني، والسيد الشبيري الزنجاني، والشيخ مكارم الشيرازي. إذًا كان الإمام الراحل (قدس سره) أستاذ حوزة من هذا الصنف. مرادي أنه لم يكن في ذلك الحين مميَّزًا عن سائر الأساتذة. لكن كان لدرسه خصوصيات معينة، ومن هذه الخصوصيات - التي كانت تجعلنا أحيانًا ندرك أنه يختلف عن باقي أساتذة الحوزة – هي أن الأمثلة التي كان يطرحها لا تقتصر على "غُسالة الماء القليل" وما شابه، فحين كان يريد أن يسوق للمسائل الأصولية مثالًا كان يأتي به من الأحداث الاجتماعية. أَذكُر أني سمعتُ منه بضعَ مرات، ولعل بعض تلامذة درسه سمع أيضًا، أن المثال الذي كان يسوقه سماحته في الدرس بخصوص مسألة ولاية الفقيه ووجوب طاعة الفقيه الواجد للشرائط هو "إذا قال لي: يجب أن تتبرّع بعباءتك هذه في سبيل الإسلام، فإن من الواجب عليَّ أن اتبرّع بها!" متى كان يسوق هذا المثال؟ قبل حوالي سبعين عامًا! كان يطرح مسائل أصولية، والظاهر أنه ما من مسألة أصولية ترتبط بشكل خاص بمثال واحد، لكن المثال الذي كان يذكره هنا هو: "طاعة الولي الفقيه الجامع للشرائط واجبة، فلو أمرَني بأن: يجب عليك أن تتبرع بعباءتك هذه في سبيل الإسلام وجبَ عليَّ التبرع بها." أي كان منذ تلك الأيام يلقي الواجبات الاجتماعية والمسائل والأحكام الاجتماعية وكذا الأحكام السياسية في الأذهان. وكان يتبادر إلى أذهاننا، نحن طلبة العلوم الدينية، منذ ذلك الحين تساؤل أنه: ما الذي يجعل الإمام الراحل (قدس سره) يطرح مثل هذا المثال؟ حتى أدركنا من خلال ذلك خطورة هذه القضية. وشيئًا فشيئًا كلما كانت تطرأ مناسبة أخرى كان يضرب أمثلة أكثر وضوحًا، حتى آن أوان "الثورة البيضاء" التي تعرفونها جميعًا، فكانت هذه الانطلاقة الأولى لنهضة الإمام الراحل (رضوان الله عليه). هذه كانت خصوصيات الإمام الخميني (رحمه الله) ونمط فكره وطريقة تدريسه.
كما كان له في نمط معاشرته للآخرين تصرفات مدروسة يلتفت إليها أصحاب الدقة في الأمور. تخيّلوا أن شخصًا ذا شأن، أو مرجعَ تقليد، أو أستاذًا كبيرًا يسير في الطريق فيقترب منه تمليذ ويسأله سؤالًا، ثم يقترب تلميذ آخر، أو يرافقه في الطريق حين عودته من الدرس بضعة طلاب يسألونه عن مسائل تخطر ببالهم فيصبحون مجموعة من خمسة طلاب أو ستة، أو أكثر أو أقل. وهذا أمر طبيعي، حتى للطلبة الناشئين، أما للأساتذة البارزين فيحصل بكثرة. لكن طالما شاهَدنا أن الإمام الخميني (رحمه الله) إذا اقترب منه وهو في الطريق تلميذ ليسأله عن مسألة كان يتوقف عن المسير ويصغي إلى سؤاله ويجيبه، ثم يقول له: "تفضّل"! فلأجل أن لا يرافقه أحد وهو يَسير أو يتبعه من خلفه في الطريق كان يتوقّف ويجيب عن السؤال ثم يشير بيده قائلًا: "تفضل"، حتى إذا انصرف الطالب عنه يبدأ هو بالمسير ثانية. وما كان يخبر أحدًا أنه: "لماذا أنا أفعل ذلك"، لكن أصحاب النظر الثاقب كانوا يدركون أن هذه ميزة أخلاقية قوامها الرغبة في التواضع اجتنابًا للابتلاء بحب الجاه.
حتى إذا توفّي السيد البروجردي (رحمه الله)، ولعلكم جميعًا تعلمون كم من الأشخاص كان لهم الدور الحاسم في وفود السيد البروجردي من بروجرد على قم؛ فكان أحدهم السيد الخميني، والآخر هو الشيخ روح الله كمالوند من محافظة لرستان. واللرستانيون يعرفونه بالتأكيد. كان الشيخ كمالوند يقوم عادةً بدور الوسيط بين السيد البروجردي والبلاط الملكي؛ فحين يكون لسماحة السيد رسالة يريد إبلاغها إلى الشاه والبلاط كان الشيخ كمالوند هو من يذهب إلى الشاه لإبلاغ الرسالة. كان شخصية من هذا الطراز. على أنه كان في محافظته محط احترام أهل لرستان جميعًا، وكان رجلًا نبيلًا للغاية. وقد قال أحد العلماء الأعلام ذات مرة: "إن للسيد البروجردي روحَين؛ أحدهما السيد روح الله الخميني، والثاني الشيخ روح الله كمالوند." قلتُ هذا لتستوعبوا مكانة هذين الرجلين من السيد البروجردي.
فحين رحلَ السيد البروجردي عن الدنيا أقام له جميع العلماء والكبراء مجلس فاتحة، وكان الإمام الخميني (رحمه الله) يحضر جميع هذه المجالس لأداء واجب العزاء. أما هو فلم يُقِم مجلسَ فاتحة، حتى اجتمع نفرٌ من أصدقائه وقالوا له: "سواء أشئت أم أبيت نحن سنقيم غدًا مجلس فاتحة باسمك أنت!" يعني أنه كان يأبى، ولو بهذا المقدار، أن يخطو خطوة واحدة نحو الشهرة، ليقول الناس: "أقامَ فلانٌ فاتحة على روح السيد البروجردي بعد ثلاثين أو أربعين من العلماء الآخرين!" كان يأبى أن يقدم نفسه للناس حتى بهذا المقدار، ولم يكن يسعى إلى الشهرة.
ومن التقاليد في الحوزة التي كانت تحصل في العام مرة أو مرتين إبان تعطيل الدروس الحوزوية أن يلقي الأستاذ في حصة الدرس الأخيرة على مسامع تلامذته مواعظ أخلاقية، وكان السيد البروجردي ملتزمًا بهذه السُنّة وكان يوصي الآخرين بأن إذا أرادوا السفر إلى ديارهم عند تعطيل الدروس أن يعظوا الطلبة ببعض المواعظ الأخلاقية. سماحة الإمام الخميني (رحمه الله) أيضًا كان أحيانًا يعظ تلاميذه وكانت مواعظه ذات وقعٍ كبير ومثارًا لانقلاب كبيرٍ في النفوس. على أني لم أدرك ما كان قبل ذلك الحين، فلقد جئت إلى قم سنة 1953، أي قبل أكثر من ستين ونيفًا من السنين. وكان سماحته يلقي درس أخلاق في المدرسة الفيضية قبل مجيئي أنا إلى قم، ولا أدري منذ أي سنة بدأه. بعد ذلك عطَّل الإمام درس أخلاقه لبعض الأسباب.
ذات مرة حَكى لي أحد تجار السوق ممن كان يحضر أحيانًا درس سماحة الإمام في الأخلاق، قائلًا: "كنتُ أحضر بنفسي درس أخلاق الإمام في الفيضية، وقد رأيت ذات مرة أن بعض التلاميذ غُشي عليهم من شدة البكاء وهرع البعض الآخر إليهم لإعادتهم إلى وعيهم! فدرس أخلاقه أيضًا كان بهذه الصورة. إذًا كانت له مثل هذه الميزات على أية حال؛ كان بعض الطلاب أو الكسَبة المتدينين يَبلُغون في درس أخلاقه من البكاء والتأثُّر ما يُغمَى عليهم! أرأيتم شخصًا يُغشى عليه من شدة البكاء؟ أنا شخصيًا لا أذكر أني رأيت مثل ذلك، ولو كان فهو من الحالات النادرة جدًّا، لكن هذا كان يحدث كرارًا في درس أخلاق الإمام الخميني (رحمه الله). شخصٌ محترم ساعاتي هو الذي نقل لي أنه كان حاضرًا في درس سماحته الأخلاقي وشاهد ذلك.
رجل كان هذا سلوكه، وهو أنه ما كان يسمح بأن يرافقه طالب أو يسير خلفه وهو يمشي، وكان هذا تصرفه من أجل اجتناب الجاه والشهرة إلى درجة أنه أبى أن يقيم مجلس فاتحة على روح السيد البروجردي حتى أقام تلامذته هذا المجلس؛ ويبدو لي أن الشيخ الخزعلي والشيخ الجنّتي كان لهما الدور الأساسي في إقامة المجلس باسمه، وكانا حينها من تلامذة سماحة الإمام البارزين.
الإمام الخميني (رضوان الله عليه) وعالمية الهداية
إن لله تعالى عبادًا كهؤلاء يهيئ لهم أرضية مليوينة للهداية، فإن خطَبوا لا يسمع الشعب الإيراني كله خطابهم فحسب، بل تسمعه شعوب باقي بلدان العالم أيضًا.
قد تستغربون ولا تصدقون، لكن إن حسبتموني صادقًا فإن هذه القصة التي سأحكيها لكم أنا نفسي شاهد عليها: سافرتُ في أوائل أيام انتصار الثورة في رحلة إلى بضعة بلدان منها الصين، ثم ذهبت من هناك إلى سنغافورة وماليزيا أيضًا. والتقينا في سنغافورة بتاجر من تجار السوق فدعانا في منزله على وجبة فطور. لم أكن أعرف الرجل لكن طاقم السفارة كانوا يعرفونه. قالوا لي: "يُفضَّل أن تقبَل دعوته." فذهبنا إلى منزله تلبية للدعوة وكنا شخصين وبضعة أفراد من طاقم السفارة. كان مكانكم خاليًا، فقد تناولنا عنده فطورًا عامرًا.
التفتُّ إلى صاحب الدار بعد الفطور قائلًا له: "نحن ضيوفك فاسمح لي أن أوجّه إليك سؤالًا."
قال: "تفضل."
قلت: "من أين عرفت الإسلام والتشيع والثورة والإمام الخميني؟ ولأيّ داعٍ دعوتَنا إلى منزلك؟ تاجر من سنغافورة، وأنا طالب علم حوزوي قَدِم إلى هنا من قم! فما مناسبة دعوتك إيانا؟!"
قال: "دعَوْتُك لأنّك ترتدي زِيّ الخميني."
قلت له: "أنت من أهالي سنغافورة، فمن أين تعرف الخميني؟!"
قال: "إذا خطبَ الخميني يترجم تلفزيون بلدنا خلاصة خطابه وينقله." ثم أضاف من باب المقدمة: "كنتُ سُنّيًا ومعاديًا للتشيع، بل أرى أن الشيعة هم سبب الفُرقة في العالم الإسلامي. فهم مجرد أقلية! فليتّحدوا معنا نحن المسلمين؟! لقد خلَقوا حالة من الشقاق والفُرقة أساسًا! بهذه الصفة كنت أعرف الشيعة، وكنتُ أبغضهم. لكن أخبار الإذاعة والتلفزة هناك كانت تبُث أحيانًا خلاصة كلام رجل من إيران فعل كيت وكيت، فتنقل بضع جمل من كلامه، وكنت بين الحين والآخر أصغي لترجمة بعض كلماته التي ينقُلها التلفاز لنا، فأشعر أنه يمتلك روحًا أخرى، وأحس أن كلامه يختلف عن كلام الآخرين، كان قريبًا إلى القلب جدًّا. فكان هذا سببًا دفَعني إلى البحث والتفتيش للحصول على جميع خطاباته ومطالعتها. قصَدتُ سفارة إيران وقلت لهم: "إن أمكن نريد أن ننتفع من نصوص خطاباته."
وأضاف: "حين سمعت كلامه رأيت أن الدين الحق والإسلام الحق هو هذا. ليكن شيعيًّا أو سُنّيًا أو تابعًا لأي مذهب كان! ومنذ ذلك الحين عشقت الإمام الخميني بدافع معرفة الإسلام الحقيقي."
رجل سني من سنغافورة يسمع ترجمة بضعة جمل من كلام الإمام الخميني (رحمه الله) فيتشيع، ويكُفّ عن العداء للتشيع، بل يتحول إلى داعية للمذهب هناك! كان تاجرًا لأجهزة الحاسوب في سنغافورة، وقتَ كانت إيران حديثة العهد بالحواسيب ولم تكن قد انتشرت فيها بكثرة بعد.
الإخلاص، سر نجاح الإمام الخميني (رضوان الله عليه)
كان هذا مجرد مثال مفاده أن الشخص المؤهَّل، والذي وقَع على السر الحقيقي للنجاح، وهو الإخلاص والعمل لله تعالى، سيُؤتيه الله أجره بهذه الكيفية في هذه الحياة الدنيا! فالإمام الخميني (رحمه الله) لم تكن له قرابة مع الله، بل كان عبدًا من عبيده، أحسَنَ العبودية له، وراح يفعل كل ما يراه من واجبه وكل ما أمره الله جل وعلا به، من دون أن يحسب حسابًا للآخرين، أو ينظر إن سَرَّهم هذا الفعل أم لم يَسُرّهم. وإن نحن أتْقَنّا هذه الوصفة وعملنا بموجبها ولو بمقدار واحد بالمئة فسنرى نتائج ذلك في هذه الحياة الدنيا أيضًا من جهة، وستكون لنا ذخرًا حسَنًا لآخرتنا من جهة أخرى. وفقنا الله وإياكم.
نسأل الله تعالى أن يشملنا بدعواتكم وأن يوفقنا نحن أيضًا ببركة دعواتكم هذه إلى الدعاء لكم ولأمثالكم.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين