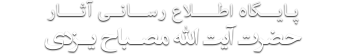الخطوة الثانية للثورة وتنشئة الشاب الثوري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهُمّ كُن لوليّكَ الحجة بنِ الحسن، صلواتُك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعةِ وفي كلِّ ساعة، وليًّا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعَينًا، حتى تُسكِنه أرضَك طَوعًا وتُمتِّعه فيها طويلًا.
مقدمة
أشكر الله تعالى أن مَنّ عليّ بطول العمر لكي أتمكّن اليوم من التشرُّف بالحضور بينكم أيها الأعزة، يا أمل مستقبل البلاد والثورة، ويا مَن يُولِيكم الإمام القائد الخامنئي (حفظه الله) ويُولي أمثالكم اهتمامًا خاصًّا في عملية الثورة، وأستفيد من أفكاركم وآرائكم وسلوكياتكم وسجاياكم. زاد الله عز وجل في توفيقاتكم يومًا بعد آخر، وأدام الإمام القائد الخامنئي خيمةً على رؤوسنا ليَمُدّنا باستمرار بإرشاداته وهَديِه، ويذكّرنا في كل زمان بكل قضية يراها أكثر ضرورة ويتوجّب علينا التنبُّه إليها، وأن يمُنّ علينا بالتوفيق للعمل بما يرشدنا إليه [الإمام القائد] ولشُكر هذه النعمة أكثر فأكثر.
كلنا تقريبًا، مع بعض الاختلاف في الدرجة، مُطّلِع على أحوال مجتمعنا والظروف التي نعيشها، ونعلم أن في المجتمع نقائصَ، إمّا في شريحة مهنيّة مُعيّنة، وإما في خواص المجتمع ونُخَبه، وإما في المسؤولين الرسميين، وإما في عموم الشعب. وإن الالتفات إلى هذه النقائص يبعث فينا دافعًا أفضل للنشاط والعمل ولتوجيه هذا النشاط بالوِجهة الصحيحة. فحين نعلم أن الحاجة إلى العمل في موضعٍ معيَّن هي أكبر، أو أن خطرًا أعظم يتَهَدّدُنا من هذا الموضع فسيُشَد انتباهُنا أكثر وسنركز قوانا وجهودنا على هذا الموضع ونضعه في الأولوية.
الصلة المباشرة بين القدرة والمنفعة والمسؤولية
هنالك آفات عامة تصيب الجميع وهي أحيانًا تؤثّر على سلوكنا من دون أن نعي ذلك؛ منها أن المراهقين، ولا سيما في زماننا حيث تنتشر بينهم وسائل التواصل الاجتماعي، غالبًا يتوقعون من المجتمع أشياءَ، ويؤمنون بأن المطالبة بها هي حق من حقوقهم المشروعة؛ فإن شاهدوا نقاط ضعف في أشخاصٍ ما أدانوهم، وبرَّؤوا أنفسهم بشكل غير مباشر، بذريعة "أننا حديثي العهد بالدخول في المجتمع، وأن على المجتمع أن يهيّئ لنا أسباب الدراسة، ومن ثم وسائل العمل، وفي المرحلة التالية لا بد للحكومة أن تَرصُد ميزانية لتهيئة ما نحتاجه من أدوات، و...إلخ. وأينما شاهدوا نقصًا ألقَوا باللائمة على المسؤولين، فكأنّهم مُبَرَّؤون من ذلك، ويرون أن القصور هو من جانب مسؤولي البلد والآباء والأمهات. وهذا الحكم، إذا نظرنا إليه من منظار واسع، هو طبيعي؛ ففي هذا العمر عندما يخرج اليافع من أحضان والديه ويترك أجواء الأسرة ويدخل المجتمع يتوقع من أفراد المجتمع جميعًا أن يرحّبوا به هم أيضًا ويُهَيّئوا له أسباب الراحة، فإن رأى أن هذه الأمنية لم تتحقق ينتابُه القلق. فالمراهقون يبذلون بعض الجهد، فإن لم يبلغوا أهدافهم، يخيب أملُهم شيئًا فشيئًا.
وكلنا يعلم أن هذا النمط من التفكير خاطئ؛ فإن الله تعالى لم يخلُق فئةً من الناس للخدمة، وفئةً أخرى للاستغلال وجَني المنفعة. فالناس جميعًا نَمَو في أرحام أمهاتهم قبل أن يولَدوا ثم وُلدوا في ظروف خاصة. وفي أوائل حياتهم هم غير قادرين على فعل شيء، وإن على الأم أن ترضعهم. ثم يَقوون شيئًا فشيئًا فيبدؤون بإنجاز بعض الأعمال بأنفسهم. ثم يبلغون سن المراهقة، وفي هذا السن يصبح الإنسان أكثر فَهمًا، وأزيَد توقّعًا، وأكبر قابلية على العمل. فإن كان من المقرر أن تستمر في المراهق حالةُ الركون إلى حضن الأم إلى النهاية – إذا صَحّ أن نشبّه الأمر بحضن الأم – فهذا ليس من الواقع في شيء! إذ إن الله عز وجل لم يخلق الناس لتكون فئة منهم أمهات لا دور لهن إلا الحنُوّ على الطفل ورضاعته وفئة أخرى أطفالًا يعيشون في أحضان أمهاتهم ولا يتحمّلون أي مسؤولية، بل إن ثقافتنا العامة – ولا أريد أن أتناول الأمر من الناحية العقلية – هي: «كُلّكم راعٍ وكلّكم مسؤولٌ عن رَعِيَّته»؛[1] أي إن كل فرد فيكم مسؤول، وإنكم ستُسألون عن الأشخاص الذين يَسمعون كلامكم ويُصغون إليكم.
فمتى ما اكتسب المرء شخصية يُعتَد بها، وأصبح – بحسب التعبير الدارج في ثقافتنا – إنسانًا بالغًا تبدأ مسؤولياته، فإن سن البلوغ والنضج وسن تحمل المسؤولية هما واحد؛ وكلما كانت قدرة المرء أعظم كانت مسؤوليته أكبر. وإلى جانب المنافع التي يجنيها من الطاقات الطبيعية والاجتماعية والعقلانية والسياسية لمجتمعه، تترتب عليه هو مسؤوليات يتعين عليه أداؤها. فلا يكون المجتمع ناضجًا ومطلوبًا إلا إذا أعطى كلُّ فرد فيه للمجتمع بمقدار ما يأخذ هو من هذا المجتمع، أي أن يكون ثمة توازن بين الأخذ والعطاء. فإن على كل فرد أن يحسب مستوى انتفاعه من المجتمع فيقدّم هو للمجتمع نفعًا بالمقدار نفسه. فإن كنا نتوقع فقط أن يعمل الآخرون لمصلحتنا، فهذا توقُّع فارغ، إذ إن الإنسان لم يُخلق بهذه الصورة.
الإعطاء بمقدار الأخذ
إن أول ما يُتوقَّع منكم - أنتم الشباب الذين بلغتُنم مَبلَغ الرجال، وارتقَيتم في ظل الثورة، ولله الحمد، إلى مستوى من النضج يفوق التصوُّر حتى أصبحتم محط أمل الإمام القائد الخامنئي (دام ظله) - هو أن تكونوا نافعين للمجتمع بالمقدار نفسه. قَلّما يَتّفِق أن نسمع للإمام القائد خطابًا لا يؤكد فيه على الشريحة الشابة، وهذا إنما يؤشِّر على أن هذه الطاقات نمَتْ نمُوًّا عظيمًا. فلم يكن الأمر هكذا في السابق. لا ينبغي أن تسيطر على هؤلاء الشباب مثل هذه الروح؛ وهي: "أنّ من واجب الآخرين العمل، أما نحن فنجني ثمار عملهم!" ثم يتذمّرون دومًا من كل عيب ونقص؛ من أنه: "لماذا أسباب دراستنا مُتدَنّية؟! كم أدوات أبحاثنا قليلة؟! لماذا أداء الجماعة الفلانية ضعيف؟! لماذا ترصد الحكومة ميزانية قليلة؟! ...إلخ. فإن دأَبوا على طرح هذه الانتقادات فلا بد أن يقال لهم: "وما دوركم أنتم؟! أخُلِقتم لتنتفعوا من جهود الآخرين فحسب؟!"
إن هذه الروح لا تنسجم مع الشخص القوي البالغ القادر على بناء مجتمعه وتحمّل مسؤوليته أمام شرائح هذا المجتمع المختلفة وأمام ربه. فمع نضج الإنسان ونموّه لا بد أن يَقوى فيه إحساسُه بالمسؤولية، وهذا ما يتوقعه الإسلام من الإنسان حين حدّدَ له سنًّا للبلوغ؛ فحين يقال في الشريعة: إن المراهق مكلَّف من الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة فصاعدًا، فهذا يعني أنّ عليه أن يخدُم مجتمعه حاله حال أي إنسان بالغ. عندما نشعر أن في أنفسنا أو في أصدقائنا مواطن ضعف فإن أول ما ينبغي لنا أن نفعله هو أن نتدارك هذا الضعف، وإلا أصبَحنا عاطلين وعالةً على الآخرين، ونتوقع فقط أن يعمل الآخرون فنقطف نحن ثمار عملهم! فمن البديهي أن مجتمعًا كهذا لن يرى وجه السعادة.
إن أول ما يجب عليكم أيها الشباب فعله هو أن تُعزّزوا في أنفسكم هذه الروح وتنقلوها إلى الآخرين؛ وهي أنّ واجبَنا إزاء المنافع التي نحصل عليها من الغير هو – على الأقل - أن نخدم هؤلاء الغير بمقدار ما يخدموننا. بالطبع، إذا كان المرء ذا فضيلة أعظم، وضحّى بمنافعه الشخصية، فهذا نور على نور؛ وإلا فإن علينا – على أقل تقدير – أن نعطي للمجتمع بمقدار ما نأخذ منه.
سن البلوغ هو بداية مسؤولية الشاب
لكن متى تصبح هذه المسؤولية على عاتق الإنسان؟ تصبح على عاتقه منذ سن بلوغه وتكليفه؛ «كُلّكم راعٍ وكلّكم مسؤولٌ عن رَعِيَّته».[2] إنه لَضُعفٌ يهدّد أجيالَنا المستقبلية أنْ يغدو جيلُنا القادم جيلَ بطالة وكسل، يتوقّعون فقط أن ينجِز الآخرون الأعمال وهم يجنون المنفعة، وإن وسائل التواصل والإعلام المعادي يحاول تقوية هذه الروح في الشباب. فهذه الروح هي شيء خاطئ، وإن بداية تبلور مثل هذه الروح ستشكل بداية سقوط المجتمع وانحطاطه.
مبدأ تقسيم العمل في أداء المهام
أما إذا بنينا أمرَنا على أن نعرف واجبنا ونؤديه، فماذا يجب أن نصنع؟ أيتسنى القول: يقَع على الجميع، في الوقت الواحد، نوعٌ واحد من المهام وإن عليهم جميعًا أن يؤدوا العمل ذاتَه؟ على سبيل المثال، إذا كان هناك نقص في محصول معيّن في مجال الزراعة فهل على الجميع أن يتوجّهوا لمزاولة الزراعة؟! أَلِأَنّ العصرَ عصرُ صناعة وأنّ على المجتمع أن يكون صناعيًّا وأنْ تتركّز النشاطات الاقتصادية في المجال الصناعي أكثر فإنه ينبغي للجميع أن يصبحوا صُنّاعًا؟ إذًا مَن سيزاول الزراعة؟ ومَن سيُنتج المواد الأولية التي يحتاج إليها المجتمع؟ أوَهذا أمرٌ ممكن؟ أمن المعقول أن تُركَن إدارة المجتمع، والتخطيط للأعمال وتوجيهها، والعمل على الفصل في النزاعات، وهو ما يجعل المجتمع بحاجة إلى قوات حفظ النظام وسلطة قضائية – أن تُركَن كل هذه الأمور جانبًا ويتوجّه الجميع إلى مزاولة الزراعة أو الصناعة؟ هل سينال مجتمعٌ كهذا السعادة؟
إذًا المبدأ الثاني الذي ينبغي وضعه في الحسبان هو أن من المحال أن يؤدي أفراد المجتمع جميعاً مَهَمّة واحدة، وأنه لا بد من تقسيم الأعمال. وهذا يذكّرنا بالمقولة الشهيرة التي مفادها أن "أُس الحضارة تقسيم العمل". فإن رغب مجتمعٌ ما في التطور فلا بد أوّلًا من تحديد الأعمال التي يحتاجها أفراده، وتصنيفها، وتقسيمها، ثم أن يَتوَلّى كل شخص أو جماعة قسمًا منها؛ بدءًا من الأعمال البسيطة، مثل الخِبازة والقصابة، ووصولًا إلى الأعمال الحِرَفية في المستويات العالية. وأيُّ نقص يعتري أيَّ مستوى فإنه سيضُرّ بمستقبل المجتمع.
اختلاف المهام بين الظروف العادية والاستثنائية
المبدأ الثالث الذي لا بد من وضعه في نظر الاعتبار هو أن الظروف الاجتماعية ليست ثابتة في كل زمان ومكان؛ فقد تقتضي الظروف الاجتماعية لمجتمعٍ ما، في زمنٍ ما، أشياءَ خاصة ثم تتغير لأسباب معيَّنة. على سبيل المثال: ربما تتغير ظروف الحياة الاجتماعية على خلفية أسباب طبيعية، مثل الجفاف والزلازل، أو بسبب التطور الصناعي والتقني، أو لأي سبب آخر، وفي الظروف الاستثنائية يتحتم على أفراد المجتمع كافّة أن يشاركوا – بشكل من الأشكال – في أعمال معيَّنة؛ وإن لم نقل "جميعًا" فلنقل: إن على معظم أصحاب المِهَن وشرائح المجتمع أن يشاركوا في نوع من النشاط. إذ ربما تستجد ظروف لم تكن موجودة من قبل، وتقتضي أمورًا ما كانت الظروف الطبيعية تقتضيها، وفي هذه الحالات الاستثنائية الخاصة ينبغي على البعض أن يكُفّوا عن أعمالهم الروتينية ويتولّوا أعمالًا جديدة. مثلًا: في أيام الحرب المفروضة حينَ شَنّ حزب البعث في العراق هجومًا على إيران بدعم من دول العالم الإلحادية، لو أراد كل شخص حينذاك أن يواصل ممارسة حياته كما كان يمارسها في الظروف الطبيعية لما كان بالإمكان إدارة الحرب أبدًا. فلطالما أكد الإمام الراحل (رحمه الله) حينذاك بالقول: "اِملَؤوا الجبهات!" فماذا كان مراد الإمام من ذلك؟ وبأيّ صنف من الناس كان يجب أن تُملأ الجبهات؟ أكانت هذه مَهَمة الجنود فقط؟ لكن الجنود كانوا موجودين دائمًا. بل كان لا بد لشرائح أخرى أن تضحي بنفسها، وتهب للتدريب العسكري، والتوجه إلى جبهات القتال. فهذه الظروف الاستثنائية تحصل، ولا يُدرى كم ستدوم، فلا يمكن التنبؤ بمدتها؛ فهذه الأخيرة تعتمد على الظروف المتغيّرة للمجتمع نفسه، والمجتمعات الأخرى ذات الأثر على هذا المجتمع. ثمانِ سنوات طالت حرب الدفاع المقدس. كان الأعداء يظنون أنها ستطول ستة أشهر، بالحد الأقصى، ثم ينتصرون، ويطيحون بالنظام الإسلامي، لكن مقاومة الجماهير أدَّت إلى إطالة الحرب، وهزيمة المعتدين، لتخرج الجمهورية الإسلامية من الحرب منتصرة بعد ثمانية أعوام. في بداية الحرب ما كان أحد ليتنبّأ كم سنةً من المقرر أن تدوم الحرب. إذًا أيام الحرب المفروضة كانت ظروفًا استثنائية، وفي ظروف كتلك كان لا بد أن يكون في الناس الاستعداد للمشاركة فيها. وهذا الأمر له مستلزماته؛ فلو كان كل فرد في المجتمع يحمل فكرة أنه لا بد أن ينعم دائمًا بعيش مريح، ولا تخطر ببال أحد أبدًا فكرة أنه ينبغي الذهاب إلى الجبهات والقتال حتى الموت، وأن تخامر الجميعَ فكرةُ: "أني إنما خُلقتُ لأستمتع بالحياة، وأنّ على الآخرين الوقوف على خدمتي، وأنا أنتفع، بل لماذا ينبغي أساسًا أن أُقتَل ولا يُقتَل غيري؟!" فإن مجتمعًا كهذا لن يرى وجه السعادة. فروح المشاركة هي ثقافة، ولا بد أن يكون في المجتمع أشخاص يعلّمون الآخرين هذه الثقافة ويُشِيعونها. يجب إيجاد أرضيات لنشر مثل هذه الثقافة لكي تُغرَس في جيلنا الشاب فكرةُ: "أنّ عليَّ أحيانا أن أفدي مجتمعي بنفسي!"
الحلول المختلفة للمجتمعات للتأهب للظروف الاستثنائية
كيف تتولد مثل هذه الروح؟ جميع أقطار العالم تقريبًا تعلم بأن ظروفًا استثنائية كهذه يمكن أن تطرأ لها، وهي تتأهب لذلك بالتخطيط لأنواع التدابير. حكومات بعض الدول لا ترى نفسَها من أهل الحروب، بل تقدم نفسَها بصفتها سلمية بشكل مطلق، ومن المعروف أن مثل هذه النزعة شاعَت في سويسرا بعد الحرب العالمية فأصبحَت جنيف، عاصمتُها، مركزًا لجميع النشاطات الدولية. فقد ادّعى زعماء سويسرا أن لا عداء لهم مع أحد ظانّين بأنهم بهذا التوجُّه سيهدأ بالُهم من أزمات الحروب. حكومات أخرى قالت: "لابد أن نُكرِه أفراد المجتمع بقوة السلاح على المشاركة بالحروب ونعلن أن المشاركة في الحرب إلزامية، وأنه يجب على أبناء المجتمع أن يتوجّهوا إلى ساحات القتال متى ما دعَت الحاجة إلى ذلك، فإن أبَوا كان مصيرهم القتل! وأكثر ما ساد هذا الطراز الفكري في الدول الماركسية. دول أخرى تعالج هذه المشكلة بطريقة مختلفة؛ فهي – مثلًا - تتخذ من الطبقة الفقيرة، سواء في بلدها أو في بلدان أخرى، مرتزقة وتدفع لهم مالًا لإرسالهم إلى جبهات القتال ليقاتلوا. وترون كيف أن العربية السعودية اليوم تستأجر مرتزقة من السودان ودول أفريقية أخرى يتقاضون - بسبب عوَزهم - مبلغًا من المال ليشاركوا في الحرب؛ وهذه سياسة من السياسات.
البعض الآخر يعالج هذه المشكلة من خلال تقوية النزعات القومية والترويج لشعار: "نحن الشعب الأفضل وإن على الآخرين أن يكونوا تبعًا لنا!" وهذا يشبه ما حصل في ألمانيا – خصوصًا - ثم في إيطاليا في الحرب العالمية الثانية؛ ففي بداية الحرب ائتلف البلَدان (ألمانيا وإيطاليا) معًا وزعموا أنهم العِرْق الأسمى، وأن على باقي الدول أن يصبحوا تبعًا لنا، وقد أحرزوا أيضًا بعض التقدم في هذا المجال؛ فإن ما فعل هتلر كان على أساس هذا الفكر القومي والعرقي ذاته؛ إذ كان يقول لشعبه: "لا بد أن تُضحّوا ذودًا عن عظَمة عِرقنا! إن عليكم حفظ هذا العرق! وكان يروَّج لهذه التعاليم العنصرية في هذه المجتمعات بطرق شتى.
الطريقة التي يتبناها الإسلام لإعداد أشخاص مضحين
لكن من بين هذه الأمم والنزعات المختلفة جاء الإسلام بمنطق مختلف أساسه أننا جميعًا عباد الله تعالى، وأن كل ما نملك فهو منه، وأن علينا أن ننفق ما نملك بإذن الله عز وجل وفي سبيله، وإن عزنا في الدنيا والآخرة يَكمُن في هذا. فإن أردنا الدنيا وطلَبنا حفظ سيادتنا فإن علينا أن نجاهد إذا آن أوان الجهاد، وإن رجونا مرضاة الله وسعَينا لنيل ثواب الآخرة، كان علينا أن نجاهد أيضًا. هذا هو الأساس والمنطق الإسلامي، وهذا كان السبب الرئيس وراء انتصارنا في حرب الثماني سنوات، وهو ما روَّج له إمامُنا الراحل (رضوان الله عليه) وتلامذته وأتباعه، وسرعان ما أعطى ثماره. على أساس هذا المنطق اندفَع المراهق ذو الثلاث عشرة سنة فرمى جسده أسفل الدبابة ليُوقِف تقدّم العدو؛ المراهق الذي لم يهنأ من الحياة الدنيا بشيء، بل لم يبلغ الحلُم، لكنْ قَوِي فيه هذا الفكر، وهو أن الجهاد قيمة يحبّها الله، وأن دنيانا وآخرتنا رهنٌ بهذا الشيء، وأن استمرار حياة شعبنا وحفظ عزّته قوامها هذه الحركة، ولهذا وذاك اقتنع بتنفيذ هذه العملية.
وعليه فمن أجل ضمان أَمنِنا في الداخل والخارج، وصَد هجمات أعادينا الأجانب، الذين وضعوا نُصبَ أَعيُنهم تدمير حياتنا والنيل من عزّنا وإيقاف تطوّرنا، فلا بد أن يَنصَبّ تفكيرنا في أن تبلغ أجيالُنا المستقبلية هذا المستوى من الـمَنَعة والمقاومة وتُقَوّى فيها روح الجهاد. وإن أفضل سبيل لتحقق ذلك هو سبيل المعتقَدات والقِيَم الإسلامية؛ فإن تعزيز هذين العنصرين يفوق جميع العوامل أهمّيةً، وهو سيجعل من العوامل الأخرى كافّة أدواتٍ في متناول يده. وإن العبودية لله تعالى هي فوق العوامل جميعًا، وليس ثمة فَخر يفوق هذا الفخر.
كيف لنا أن نوجِد هذه العقيدة ونعززها؟ فالخبّاز والقصّاب والبقّال يختارون مِهَنهم انطلاقًا من العوامل الاجتماعية الطبيعية، فيجتذبون الزبائن، ويكسبون الرزق، ويُلَبّون احتياجًا من احتياجات المجتمع. فالعامل الطبيعي هنا هو الذي يولّد الدافع لممارسة مثل هذه المِهَن، أما أن يُعِدّ المرءُ نفسَه ليُقتَل، ويَغُض الطرْفَ عن وجوده وحياته، وينتزع حب الأب والأم والدار والزوجة والولَد من قلبه، فيتوجّه إلى جبهات القتال مستعدًّا للشهادة، فهذا بحاجة إلى عامل أقوى. ونحن نشاهد في مجتمعنا المسلم هذا كيف أن البعض يطالب الآخرين بأن يدعوا له بالشهادة!
وإن تلامذة هذه المدرسة وهذه الثقافة يَبلُغون مستوًى لا يكونون فيه على استعداد لأداء واجبهم الضروري فحسب، بل يرجون الشهادة أيضًا! وقد لا يمر بنا يوم لا نواجه فيه أشخاصًا، من الشيوخ والشبّان ومن طلبة العلم وغيرهم، يسألوننا أن ندعو لهم لنيل الشهادة. ومثل هذه الروح لا تتولّد من أعماق النفوس تلقائيًّا، وهي لا تشبه الاحتياجات الطبيعية؛ بأن يشعُر المرء بألم في بطنه فيستيقظ صباحًا ويقول: "لا بد أن أستشهد لأعالج ألم بطني!" بل إن منشأها فِكْر وقيمة آمَن وتعلَّق المرءُ بهما فصارا عنده من الأهمية ما جعَله على استعداد لأن يفديهما بنفسه أيضًا!
لكن كيف لهذه القيمة أن تتولّد في المجتمع؟ وهذا السؤال يَدُلّنا على أنه مضافًا إلى الفئات المجتمعية التي تعمل على تلبية الاحتياجات الطبيعية لأفراد المجتمع لا بد من وجود فئة تؤَمِّن لهم احتباجاتهم المعنوية والروحية والإلهية. ثقافات عديدة وبلدان كثيرة غافلة عن أمثال هذه القِيَم، أو لا يؤمنون بها أساسًا، ويعتقدون أن بإمكانهم سَد هذه الحاجة عن طريق المال واستئجار المرتزقة. لكنكم تشاهدون إلى أيّ مدًى ثَبُت نجاح هؤلاء من الناحية العلمية وعلى مستوى التجربة العملية؟!
تركيز الأعداء على ضرب ثقافة الطاعة عند المُوالين
تجربتنا في الثورة الإسلامية، وفي الحرب المفروضة التي امتدَّت لثمانِ سنين، وفي العمل الطوعي الذي يبادر إليه الأعزّة من حُماة المقدسات اليوم تكشف لنا عن آثار هذه القيم ونتائجها. إيران التي كانت ذات يوم مستعبَدة لأمريكا وكان عليها أن ترسل أبناءها جنودًا إلى عُمان للقتال لصالح "جبهة تحرير ظفار"[3] مجانًا، أصبحت اليوم منافسًا تحسب لها الولايات المتحدة حسابًا أكثر من العالم كله، بل تعتقد أن إيران تشكّل خطرًا لها، وتحسب للإمام القائد الخامنئي (دام ظله) نفسه حسابًا يفوق أي شخص غيره، معتقدةً بأنه ما دام هذا الرجل في السلطة فإنه ليس بإمكانها تحقيق أي تقدم! وإن كل خُطَطهم لإسقاط النظام الإسلامي تتركّز على سَلب الإيرانيين هذه الطاعةَ للسيد القائد، إذ سيتمكّنون حينَها من تحقيق أهدافهم. فلقد جرّبوا الطرق جميعًا؛ بما فيها المال، وكذا الطرق الأخرى التي جرّبوها في باقي البلدان، وهم يعلمون أنه ما دام هذا القائد موجودًا، وما دامت هذه الطاعة له باقية فلن تتحقّق أهدافهم.
أعظم واجب في عنق الثوريين
ولكي يتحلى جيلُنا القادم أيضًا بهذه الروح فإننا بحاجة إلى التربية وإلى التعليم معًا، وفي هذه المقولة إشارة إلى النقطة ذاتها التي يجري التأكيد عليها، وهي أن أعظم واجب في عنق كوادر الثورة اليوم هو أن تعمل على إعداد الشباب إعدادًا ثوريًّا. وكيف يتحقق ذلك؟ يتحقق من خلال منهجية إسلامية سليمة في التربية والتعليم. لكن هل علينا حقن الأشخاص بهذه المنهجية؟ أفي وسعنا اختراع مادّةٍ نحقن بها الناس ليكتسبوا هذا النمط من التربية والتعليم؟! فلو كان هذا ممكنًا لفعله الأنبياء من قبل! ولو كان هذا متاحًا لما برَزَ أبو عبد الله الحسين (عليه السلام) إلى ميدان الشهادة! إن هذه الروح لا تُكتسب إلا باصطناع النهج الإنساني في التربية والتعليم، وعلى يد مُرَبّين صالحين.
بالطبع، هنا أيضًا أؤكّد على أن هذه القاعدة ليست عامّة ومن دون استثناءات، فقد تطرأ على المجتمع ظروف استثنائية تُحَتّم على هؤلاء المربّين أيضًا أن يتركوا أعمالهم من أجل عمل أكثر ضرورة؛ على سبيل المثال، قضية الدفاع قد تُفرض بصورة يتحتّم معها على الجميع أن يشاركوا. فنحن لا نُلغي أمثال هذه الظروف.
النهوض بالاقتصاد والثقافة هو مقتضى ظروف مجتمعنا الاستثنائية
بالرجوع إلى كلام الإمام القائد الخامنئي (دام ظله) فإن لدينا جبهتين الوضع فيهما استثنائي. ففي "بيان الخطوة الثانية للثورة"[4] هذا نفسه يؤكد سماحتُه على هذين العنصرين بشكل بارز. بالطبع قد يُرَجّح البعض – من خلال العقلية الخاصة التي يحملها – أحد العنصرين على الآخر، أو أنه لا يبصر إلّا هذا العنصر، لكن الحقيقة هي أن روح البيان تؤكّد على عنصرين لا ينفصلان؛ الأول هو العنصر المادي، وهو الإنتاج والاقتصاد المقاوِم، والثاني يتمثل في قضية ثقافية تتصل بإعداد جيل ثوري، ومُسلمين ثوريّين. معظم التأكيد في كلام سماحته في هذا البيان يَنصَب على هذين العنصرين، وعليه فإن كل امرئ، مهما كان عمله ومهنته – ولا بد أن يكون له عمل أو مهنة، وإلا اختَلّ وضع المجتمع – فإن عليه أن يخصص جزءًا من عمله ووقته لهذين الوضعين الاستثنائيين الـمُلِحَّين الطارئين في عصرنا هذا. فإن كان لأناسٍ الاستعداد لتولي قطّاع الاقتصاد فإن عليهم أداء واجبهم في هذا المضمار. وقد يوجد عند البعض في مجال الاقتصاد قابليات؛ مثل التحصيل الدراسي، والتجربة، والذوق، والموهبة الذاتية أو الربّانية، ...إلخ ولذا يتحتم عليهم النهوض بواجبهم في هذا المجال. ومن الناحية الأخرى ربما تتوافر عند البعض الآخر مؤهّلات ثقافية أكثر من غيرها، فإنّ عليهم أن يهتموا بهذا الجانب. لكن علينا أن نعلم أن أيًّا من هاتين الفئتين لا تكون خليفة للأخرى. فالمجتمع الذي تعيش أكثريته في وضع قريب من الفقر أو تحت خط الفقر لا يُتوقع منه الذهاب إلى جبهات القتال، والأب الذي يعود ليلًا إلى بيته من دون أن يستطيع شراء رغيف خبز يشبع به عياله كيف يُتوقع منه التوجُّه في غده إلى القتال؟! اللهم إلا أن يذهب للانتحار؛ وإلا فهو لا يذهب بدافع شخصي، فقد يكون وصلَ إلى حالة من ضنك العيش ما يجعله يقول: "فلأذهبْ إلى الجبهة حتى أُقتل هناك وأرتاح من هذا الوضع!" هذه حقيقة لا يمكن التغاضي عنها.
أستاذ الجامعة والباحث أيضًا ليس له القول: "شغلي هو العمل البحثي، ولا شأن لي بهذين العنصرين!" فهذا الكلام صحيح في الظروف الطبيعية، أما الآن فالظرف استثنائي، وأمثال هؤلاء أيضًا عليهم أن يخصصوا جزءًا من أعمالهم لهذا الشأن، وإن أقلّ ما يمكن لشخص كهذا أن يفعله هو أن يرصد بعضَ دخْله لهذه الأمور. على سبيل المثال، أن يخصص جزءًا من دخله للاستثمار في مشروع صناعي أو عمل إنتاجي مُربح. بل في بعض المواطن هناك حاجة للاستثمار في قطاع الزراعة أيضًا، وليس باستطاعة الحكومة رصد الميزانيات اللازمة له. ففي مثل هذه الأمثلة ليس لي أن أقول: "عملي هو البحث العلمي، ولا أستطيع تولّي أعمالًا أخرى!" "حسنٌ، إن متوسط ما تحتاجه يوميًّا للعمل البحثي هو ثمان ساعات، إذًا فاجعل ست ساعات منها للبحث العلمي، وخصص ساعتين لهذا العمل! فإن لم تستطع تخصيص ساعتين لهذا العمل يوميًّا، خصص له ثلاثة أشهر من السنة، أو تفرّغ له أيام العُطل! فإن الاقتصاد المقاوم هو أحد العناصر المهمة للمجتمع."
العنصر الضروري الآخر هو العنصر الثقافي؛ أي العمل على بناء روح المقاومة، وروح الإحساس بالمسؤولية الدينية والاجتماعية، والعواطف الإنسانية، ...إلخ. فإن مَن لا دين له أيضًا لا يستطيع الوقوف أمام الظلم موقف المتفرّج؛ فأنَّى لإنسان مُتّزن أن يستطيع مشاهدة الناس رازحين تحت الظلم والجور والضغط الاقتصادي والحصار؟! أبإمكان إنسان كهذا أن يقول: "ما لي وهذه الأمور؟!" الإنسان المتزن لا يستطيع أن يعيش بهذه الصورة، فما بالك بالمتدين! وما بالك بالشيعي! وما بالك بمن يتّبع سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)!
إن على كل فرد أن يقيّم قابلياته ويرى لأي العنصرين يَصلُح؟ أهو ناجح أكثر في النشاط الاقتصادي أم في العمل الثقافي؟ لكن ليختار أحد المجالين بصورة عمل إضافي، أو ساعات عمل إضافية، أو يخصص – على الأقل – بعض ساعات عمله الأصلي لهذا الشأن؛ كأن يخصص له ربع ساعات عمله (أي ساعتان من ثمان ساعات مثلًا). فلو طلبنا من شرائح المجتمع جميعًا أن يخصصوا كل أوقاتهم لهذا العمل فلا شك أن الأعمال الأخرى ستختل. ففي حالة الحصار التي نعيشها من المستحيل أن نقول: "ليتوجّه الجميع إلى مزاولة الأعمال الثقافية، والعمل الجهادي، والحرب العسكرية." ففي النهاية ليس بإمكان الجميع أن يتحملوا الجوع؛ الأطفال الصغار لا يستطيعون تحمّل مثل هذه الظروف، إذ في هذه الحالة سيموت يوميًّا آلاف الأطفال من الجوع والمرض وغياب الممرضين. فنحن مضطرون إلى مزاولة الأعمال الأخرى أيضًا.
النتيجة
إذا النتيجة التي خرجنا بها من بحثنا هذا هي أن علينا مسؤوليات في مقابل المنافع التي نجنيها من المجتمع، وأن علينا أن نقدم للمجتمع خدمة. مقتضى هذه المسؤولية في الظروف الطبيعية هو أن تضطلع كل جماعة وفئة من المجتمع بمسؤولية خاصة وتنفق كل وقتها فيها. لكنّ ظروفًا استثنائية تطرأ أحيانًا يتحتم معها على كل جماعة وصنف من المجتمع أن يمدّوا يَد العون للفئات من أصحاب القطاعات الأخرى.
الظروف الخاصة التي يعيشها مجتمعنا هي – من ناحية - الحصار الاقتصادي، ومن ناحية أخرى مخاطر الآفات الدعائية والإعلامية المكثَّفة التي لا نظير ولا سابقة لها في الخمسين عامًا الأخيرة. فلو أنصَفنا القول: في أي زمان رأينا هذه الجوّالات في أيدي أولادنا؟ وفي أي زمان تعيش الجمهورية الإسلامية ليلَ نهار تحت وطأة كل هذه الدعاية الإعلامية للدول الأجنبية؟ فلا في زمان الشاه كان الوضع هكذا ولا في أوائل أيام انتصار الثورة، بل لم تكن أمثال هذه الأجهزة قد اختُرعت بعدُ أصلًا. أما اليوم فنجد أطفالًا بعمر سبعة أو ثمانية أعوام منشغلون بجوالاتهم حتى وقت إيوائهم إلى الفراش في ساعات متأخرة من الليل! فلا ينبغي أن نغفل عن التخطيط والمنهَجة لأمثال هؤلاء. لا يستطاع الوقوف بالكامل أمام هذه الظاهرة؛ فالجوالات معروضة في السوق وبإمكان كل امرئ أن يشتريها ويستعملها، هذه الأجهزة منتشرة في المجتمع، شئنا أم أبَينا! لكن لا بد من الاهتمام بالقضية وعمل برامج وتطبيقات لمستخدمي الجوالات تكون جذابة من جهة، وتعطي نتائج معنوية مَرْضِيّة عند الله تعالى من جهة أخرى. وهذا أمر قلّما نفكر فيه، وإنّ منتهى الإنجاز الذي نُحسنه هو أن نرى ما هي احتياجاتنا الروتينية اليومية ونعمل على تلبيتها، أما بعد عشرة أعوام، فليس لنا منهاج وخطط خاصة! فحين ينزل هؤلاء المراهقون إلى مضمار العمل فكيف وبأي أخلاق وسجايا سينزلون؟ وما الأهداف التي سيرمون لتحقيقها؟ أسَيوجَد بينهم مَن لا يأبى أن يرمي نفسه تحت دبابة العدو لإيقاف تقدّمه؟ المراهق الذي لا شغل له طيلة ليله ونهارة غير اللذة والتسلية؛ إما لذات البطن والجنس الطبيعية، أو اللهو الممتِع، ولا يعرف شيئًا آخر غير ذلك، متى سيكون مستعدًّا لجهاد العدو وبَذل روحه في سبيل الإسلام والثورة والإنسانية؟! وهذا خطر يستفحل في العالم كله باطّراد، ولا سيما في بلدنا الذي اتّحدَت ضده دول العالم أجمع في سبيل الإطاحة بنظام الحكم فيه.
كانت هذه أجوبة عامّة كان بإمكاننا عمومًا إعطاءها لهذه الأسئلة. أما الأجوبة التفصيلية فلا بد أن تصدر من الشبّان المتوقِّدي الفكر ممن ينعمون بسلامة المزاج، ولديهم الوقت الكافي والمعرفة اللازمة بالقضايا الاجتماعية، ولديهم التجربة الكافية، فيعطون – عبر الإفادة من كل هذا - أجوبة وافية.
أسأل الله تعالى أن يُبقيكم ذخرًا نفيسًا لمستقبل الإسلام والثورة، ويهيّئ لكم - أكثر من ذي قبل - أرضيات النضج والتكامل.
وأن يجعلنا جميعًا عارفين بقَدْر نعمة القائد! ويُلهمنا التوفيق لفهم أوامره، وأداء التكليف الذي تمليه هذه الأوامر علينا، لنعلم أي الأوامر تتصل بنا فنهتَم بها أكثر، والتوفيق لاستنهاض العزائم لتوظيف قوانا وطاقاتنا وقدراتنا لهذا العمل للخروج منه بالنتائج المرجوة.
وفقَنا الله وإياكم إن شاء الله
والسلام عليكم ورحمة الله
[1]. المجلسي، بحار الأنوار: ج72، ص38.
[2]. المصدر نفسه.
[3]. جبهة تحرير ظفار: ظهرت في ستينات القرن العشرين في إقليم ظفار جنوب عُمان ضد حكومة سلطنة عمان آنذاك والاستعمار البريطاني. (المترجم)
[4]. الخطوة الثانية للثورة: إشارة إلى البيان الذي وجّهه الإمام القائد الخامنئي (دام ظله) إلى الشباب في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران الذي عَدّ فيه أن إنجازات الثورة في الأربعين عامًا المنصرمة كانت الخطوة الأولى وأننا على اعتاب اتّخاذ الخطوة الثانية، وأسماه "بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية". (المترجم)