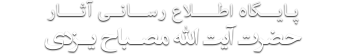الشرط الضروري لتحقق أهداف الخطوة الثانية للثورة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهُمّ كُن لوليّكَ الحجة بنِ الحسن، صلواتُك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعةِ وفي كلِّ ساعة، وليًّا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعَينًا، حتى تُسكِنه أرضَك طَوعًا وتُمتِّعه فيها طويلًا.
حلول شهر رجب المبارك هو في الحقيقة حلول عيد أعظم للمؤمنين، وهو بحد ذاته يتطلب شكرًا لله عز وجل وتبريكًا لبعضنا البعض أن وفّقَنا الله تعالى مرة أخرى لإدراك هذا الشهر الفضيل، ونسأله أن يوفّقنا للانتفاع من فيوضاته. ولادة الإمام محمد الباقر (صلوات الله عليه) هي ذريعة أخرى لتهنئة الأعزة، حيث أغتنم فرصة تصادُف هذا اليوم مع ميلاد هذا الإمام العظيم لأبارك لأصدقائه ولا سيما الحضور الكرام، مضافًا إلى الأعياد القادمة في هذ الشهر الفضيل؛ «المولودَين في رجب»؛ ومنها الثالث عشر منه ولادة الإمام علي (صلوات الله عليه). وأخيرًا السابع والعشرين منه عيد المبعث النبوي الشريف، حيث قد لا نجد شهرًا من أشهر السنة يضُم كل هذه البركات والفرص التي يسعنا الإفادة منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفّقنا جميعًا لإدراك الأعياد القادمة أيضًا بأحسن صورة والانتهال من فيوضاتها أكثر من ذي قبل.
كما أشكر الله عز وجل أن وفّقنا لفرصة اللقاء ببعض الأصدقاء ممن لم نلتق بهم لأكثر من عام لكي نجدد العهد، وأسأل الله أن تكون هذه فرصةً ليستغفر الإخوةُ الأعزة للشيوخ العاصين [من أمثالي] وأن أنتفع من دعواتهم.
ضرورة المقارنة بين خطوتَي الثورة
المناسبة التي تُطرح هذه الأيام في كل محفل وُدّي، ولا سيما أمام العناصر التي تشعر بالمسؤولية وتطمح إلى تقدّم الإسلام والمسلمين، هو الالتفات إلى أننا نَلِج في الأربعينية الثانية للثورة، أو – على حد قول الإمام القائد الخامنئي (دام ظله) – "الخطوة الثانية للثورة". وأشعر أن من المناسب أن نجري دراسة في الفوارق بين الخطوتين الأولى والثانية للثورة؛ وهو أنه ما المشاكل التي كانت قائمة أثناء الخطوة الأولى وتراجعَت الآن، وما البركات التي حظينا بها في الخطوة الأولى والآن نحن محرومون منها. ومن ثَم ما هي أرضيات الخير التي تهيّأَت لنا آنذاك وهي الآن غير موجودة، وما أرضيات الشر التي كانت موجودة في الأولى ولا بد الآن أن نتوقّعها – نوعًا ما – ونُعِد أنفسنا لمواجهتها، وما النعم التي وهبنا الله إياها في الخطوة الثانية بعد أن كنا محرومين منها في الأولى، مما يحتم علينا شكرَها لكي تزداد.
على أية حال إن مقارنة هذه المرحلة بالأربعينية السابقة تفتح لنا أبوابًا للمزيد من الفكر والمعرفة بظروف الحياة وبواجباتنا، والتي أظن أن من المستحسن أيضًا أن يفكر المرء فيها ويتحدث حولها.
جيل اليوم والخطوة الثانية للثورة
من وجهة نظري إن الفرق الأكبر بين هذه الخطوة والخطوة الأولى هو أن جيل هذه المرحلة يختلف عن الجيل السابق. ففي المرحلة الأولى الأشخاص الذين كانوا أيام انتصار الثورة الإسلامية في سن المراهقة، ترَبَّوا ونُشِّئوا أثناء السنوات العشر من وجود الإمام الراحل (قدس سره)، وقد حصلَت في تلك الحقبة حوادث بنَت شخصياتهم وصقلَت نفوسهم. لكن ذلك الجيل - على أية حال - أيًّا كان أفراده فإنهم - غالبًا - لم يعودوا في سن يسمح لهم بأن يكونوا عناصر ناشطة ومبتكِرة. بالطبع ثمة استثناءات، فهناك من الـمُسنّين ممن يقومون بأنشطة جادّة ومؤهَّلون لأعمال كبيرة، وهم ينجزونها.
واليوم حَلّ محَلّ ذلك الجيل جيلٌ لم يَر الإمام الخميني (رحمه الله) ولم يسمع كلماته وتوجيهاته، ولم يُدرك ظروف تلك المرحلة. كما أنه لم تتهيأ لهذا الجيل ظروف الإنضاج والصَقل التي تهيّأت للجيل السابق؛ فهم لم يدركوا مِحَن العهد الشاهنشاهي، بل فتحوا أعينهم على بيئة فيها نِعَم جَمّة. بالطبع قد لا يَتّفق في أيّ زمان من هذا العالم أن يعيش قومٌ في ظروف كلها نِعَم ولا تمُر عليهم أي محنة أو معاناة. فطبيعة هذا العالم أصلًا ليست هكذا؛ يقول تعالى: (لَقَد خَلَقنَا الإِنسانَ في كَبَد)،[1] فهو موطن آلام ومكابَدة. لكن الظروف التي يعيشها جيل اليوم من المراهقين والشباب تفوق كثيرًا ظروف السنين الأولى بعد انتصار الثورة من حيث النعم المادية، والأمن، والتطورات العلمية، وتوافر عوامل النمو والتكامل.
وليس الوقت الآن متاحًا لعمل مقارنة، وإعطاء أمثلة على مدى اختلاف الأرضيات بين المرحلتين. وقد يُشار، بين الحين والآخر، في الصحف والإذاعة والتلفاز، وما إلى ذلك، كما كانت هناك إشارة في كلام الإمام القائد (دام ظله)، في بيان الخطوة الثانية هذا بالذات، إلى أن جيلنا اليوم قد فتح عينيه في وقتٍ وأجواءٍ النِعَمُ فيها تفوق ما كان عليه الجيل السابق بكثير. ومن الطبيعي أنّ العيشَ في مثل هذه الظروف يدفع الشباب إلى المزيد من المطالبات، إذ يصعب عليهم تحمّل العيوب التي قد يشاهدونها هنا أو هناك. فإن الإنسان الذي يتربّى وسط النِعَم يفقد صبره أمام أول محنة يمُرّ بها، وإن كانت بالنسبة إلى الآخرين أمرًا عاديًّا. فلأنّ هذه النعم تهيّأت لنا على مدى أربعين عامًا يتخيّل الشباب أنه لا ينبغي حصول أي عيب أو نقص، فيتعيّن على الجميع أن يؤدّوا واجباتهم على أحسن وجه، ولا يجوز لأي امرئ أن يمارس الاستغلال، أو يختلس المال، ولا ينبغي أن تكون هناك رشوة، ولا أن يحصل غلاء، أو تضخّم. بل إنهم إن صادفوا إشكالًا صغيًرا فسيرونه كبيرًا جدًّا. وهذا أحد الفروق بين جيل اليوم وجيل الأمس. لكن في مقابل ذلك، كان فيما مضى نِعَم معنويّة أخرى لم تَعُد الآن متوافرة بذلك المقدار.
البركات المادية والمعنوية أيام الخطوة الأولى للثورة
بحسب الظاهر إننا نَعُدّ أحداث زمان الثورة، من اشتباكاتٍ بين الجماهير وسلطات الشاه، وسجونٍ وتعذيب وما إليها - نعُدّها بلايا ومحنًا ومصائب، ولقد كانت كذلك فعلًا. ثم ما تلا ذلك من اضطرابات داخلية وقلاقل افتعلَها الإرهابيون بصوَر شتّى، من زُمَر يسارية مختلفة، وما اصطُلح عليهم "مجاهدو خلق" ...إلخ، كانت كلها في غاية الصعوبة، لكنها حملَت بركات جمة؛ وهو أنها ضاعفَت الإقبال على الدين والروحانية. على سبيل المثال حين يشاهد المرء يوميًّا جنازةَ شهيد يؤتَى بها من جبهات القتال وتُشيَّع، وينظر إلى التضحيات التي قدّمها هذا الشهيد في الجبهة، وكيف تصنع عائلتُه، وأُمّه إذ تخاطبه: "أُمّاه، لن أبكيك يا ولدي، بل أنا فخورة بك!" وأمثال هذه الصور، هذه كلها عوامل تربوية تعمل على إنضاج المجتمع. ذلك الجيل لم يكن يترصّد ما إذا غلا الخبزُ أو رَخُص، أو فُقدَت السلعة الفلانية من السوق أو توافرَت.
فحين فُرض الحظر الأمريكي علينا ونُفّذ كانت الناس تهتف: "قاطعوا البضائع الأمريكية". في ذلك الحين لم نكن آيِسين من أن يمُدّوا لنا يد المساعدة فحسب، بل كنا لا نشتري منتجاتهم أصلًا، كنا نحن من يفرض عليهم الحظر، ...وما إلى ذلك، وإن أمثال هذه العوامل هي التي قادت إلى أن يفكر الناس بتطوير أنفسهم مادّيًا في مجال الصناعة والعمل، حتى بلوغ حالة الاكتفاء الذاتي، وإن معظم الصناعات التي نمَت والاختراعات التي حصلَت كانت بسبب هذا الحظر الاقتصادي. فلولا تلك الصعاب والمضايقات لكانوا استوردوا البضائع من الخارج، وأخذوا يبيعون ويشترون، ولما تحقّقَت يومًا هذه التطورات العلمية. فتلك الأزمات كانت – في الحقيقة – عاملًا للنمو المادي والنضج المعنوي على حَدّ سواء؛ فلقد كانت – من جهة - تدفع الناس إلى النشاط والتطور العلمي والاقتصادي والاكتفاء الذاتي، وتُلفِت انتباههم - من جهة أخرى – إلى أن الأمور الدنيوية لا قيمة لها؛ انظروا كيف يتراكض الشباب إلى الجبهات بشغف ويستشهدون! وكيف يستقبلهم آباؤهم وأُمّهاتهم، ويفخرون بهم! فهذه المشاهد كانت تؤثر في الآخرين أيضًا.
إذًا هذه الحرب حملَت لنا منافع مادية، مثل النمو العلمي والاكتفاء الذاتي من جهة، ونُضجًا وتكاملًا معنويًّا – من جهة أخرى - على مستوى قطع التعلُّق بالدنيا، والتأسّي بعوائل الشهداء، إلى جانب كلام الإمام الراحل (رحمه الله) وخطاباته، وكل ذلك كان دروسًا مُرَبّية تُوحى للجميع.
وكانت هذه الأمور ترمِّم الضعف الذي قد يوجَد عند بعض الشرائح الفَتِيّة. كان هذا هو ما جعل الأعادي يفشلون طيلةَ الأربعين عامًا المنصرمة في ارتكاب أي حماقة مهما حاولوا مع أنهم كانوا يظنون أنهم سيقرؤون الفاتحة على روح الثورة خلال سنة، بل خلال ستة أشهر! حتى اعترفوا بهزيمتهم في نهاية المطاف. وهذا الأمر لا يحصل عبثًا ودفعةً واحدة، بل هذه كانت أسبابه.
تحديات الخطوة الثانية
أ- أشكال التطور المادي والتعلق بالدنيا
لكن العوامل أصبحَت اليوم معكوسة؛ فمن ناحية إن وجود النِعَم المادية يزيد من مطالبات الجماهير لاستكمالها. ثِقوا أنني – أحيانًا - حين أمُرّ من بعض شوارع مدينة قم، خصوصًا تلك التي فُتحَت حديثًا، لا أصدّق في البداية أنني في قم! فزمانَ جئنا إلى قم لم يكن فيها منزل واحد جدرانه أو واجهته من الآجُر أو الطوب. أفضل المباني في ذلك الزمان كان المبنى الذي يشغله الآن "مكتب الإعلام الإسلامي"، وكان من الآجر. وأفضل منزل كان المنزل الذي يقيم فيه آية الله السيد البروجردي (رحمه الله) وكان حائطه مبني من اللِّبْن وخليط الطين والتبن. أساسًا لم يكن هناك مبنًى فخم أو من عدة طوابق أو واجهته من الرخام. أما الآن فتشيَّد مبانٍ يشك المرء حقًّا إذا رآها إن كان بباريس أم بقم! وهذا التطور المادي يزيد من توقعات الشباب، فيقولون: "لِمَ فلان عنده وأنا ليس عندي؟! لا بد أن أملك أنا أيضًا ما يملك هو!" وإن حصل خطأ في موضع ما، وُضع تحت المجهر وقيل: "لِمَ هذا الاستغلال؟! لماذا لم يُؤَدِّ فلان واجبَه؟!" أي عوضًا عن نموّ حالة قطع التعلق بالدنيا، حالة التعلّق بالدنيا هي التي تنمو! هذا من ناحية. فمن الطبيعي أن تكون ردة فعل الأجيال القادمة تجاه التطورات المادية من هذا القبيل.
ب- قلة عوامل النضج المعنوي
من ناحية أخرى، تلك العوامل التي تبعث على النضج المعنوي، من تلك التي ذكَرنا، لا تتوافَر بتلك القوة. فمنجزات الحرب نفسها كانت عوامل تعزّز الجوانب الروحية، على وجه الخصوص كلام عوائل الشهداء وأقاربهم، وكلام أكابرنا، ولا سيما الإمام الخميني (رضوان الله عليه). هذه القضايا لم تعُد الآن موجودة، وفي الوقت ذاته إذا اتّفقَ وجود نقص أو عيبٍ ما في موضعٍ ما فإنه يُضخَّم بشكل كبير.
ج- الغزو الثقافي والحرب الناعمة
من ناحية ثالثة، في ذلك الزمان كان الأعداء يتوقعون أنهم سيُنهون الثورة بإشعال حرب عسكرية أو تحريض اضطرابات داخلية أو ما شاكل؛ فكان مما يضعونه في جدول أعمالهم مساعدةُ الزُمَر الإرهابية والتهديد، من أننا سنهجم، أو سنفعل كيت وكيت، وكان البعض أيضًا يصدّق. أما الآن فبعد مضي أربعين عامًا، وبسبب الخبرات التي تراكمَت عندهم رأوا أن هذه الأمور لا تجدي نفعًا، فقرّروا التحوّل من كل هذه الأعمال إلى الحرب الناعمة. فركزوا خبراتهم على كيفية الإفادة من الحرب الناعمة لإفراغ الأجيال الجديدة للثورة من الداخل، وجعْلِهم عديمي الإرادة والعزيمة، ومحبّين للدنيا، ومُتَّبعين للشهوات والأهواء، ولاهثين وراء الرفاهية والمسرات، ثم – شيئًا فشيئًا – ضَعْف الحجاب والرقص وما إلى ذلك. فانصَبّت كل نشاطاتهم على مثل هذه الأمور، وهي ثقافية مئة بالمئة. بالطبع هذه الحرب كانت قائمة في ذلك الزمان، لكنها كانت في المرتبة الثانية والثالثة من الأولوية، حيث كانت القضايا العسكرية والاقتصادية تحتل المرتبة الأولى، أما الآن فبات العداء بالدرجة الأولى يُترجَم بالحرب الناعمة.
التطور التقني أداة العدو في الحرب الناعمة
وإن ما يساعدهم في هذا المجال التطور التكنولوجي واختراع الأجهزة التي هي اليوم في متناول جميع أبنائنا ويستطيعون بها، بكل سهولة، وبالضغط على بضعة أزرار التمتع بجميع الإمكانيات، والإفادة منها، أو الفساد بسببها!
القصة التي سأحكيها لكم الآن قصصتها سابقًا بضع مرات للإخوة، ومن المناسب أن أحكيها لكم الآن أيضًا، ولربما ستسمعونها مني مرة أخرى. سافرتُ أوائل انتصار الثورة إلى أمريكا. في ذلك الحين كان الدكتور كمال خرازي ممثل إيران في الأمم المتحدة، وكان صادق خرازي مسؤول مكتبه هناك. كنتُ مسافرًا بمفردي وقد دخلت أمريكا لوحدي، البلد الذي لا أعرفه أبدًا ولا أعلم عنه شيئًا أصلًا.
جاء السيد خرازي من مكتب الأمم المتحدة إلى المطار لاستقبالي وأخذني إلى مكتب الأمم المتحدة أو المكان المهيّأ لإقامتي.
ونحن في الطريق قال لي السيد صادق خرازي: "أتريد الاتصال بقم؟"
قلت: "أجل."
قال: "أتريد التكلم مع أحد هناك؟"
قلت: "التكّلم! أولَسنا في نيويورك؟! كيف لي أن أتكلم مع قم؟!"
قال: "هاتفيًّا."
قلت متعجّبًا: "هاتفيًّا! وهل ثمة أسلاك موصولة من هنا بقم؟!" آنذاك لم أكن أتصور أبدًا أنه يمكن التكلم تلفونيًّا بلا أسلاك.
كان هناك جهاز هاتف أمامه. قال لي: "أعطني رقم المنزل."
أعطيته رقم المنزل وأنا أظن أنه يمزح.
اتّصل على الرقم وقال: "ألو.."
عرفتُ أنها العائلة فعلًا، وهذا صوت زوجتي. فبقيتُ فاغر الفم من التعجّب! هاهنا أمريكا، فكيف لنا التحدث إلى قم هاتفيًّا؟! حتى في مدن إيران لم يكن في الميسور آنذاك الاتصال بهذه السهولة والسرعة. لم أكن أعلم أصلًا أنّ جهازًا من هذا القبيل اختُرع. كانت هذه الأجهزة جديدة في أمريكا ولم تكن قد دخلت إيران بعد. أن يستطيع المرء استعمال جهاز بهذه الصورة كان لي أشبه بالمعجزة، أما الآن فقد أصبحَت هذه الأجهزة في متناول أطفالٍ بين الثالثة والرابعة من العمر يلهون بها!
مظاهر نجاح العدو في الحرب الناعمة!
إن العدو يستخدم هذا الجهاز على أوسع نطاق لينفّذ خططه بكل سهولة، ودونما تكلفة كبيرة؛ يكفي أن ينتجوا برنامجًا ويبثّوه ليعبثوا، كما يحلو لهم، بأنفس أفراد العوائل وقلوبهم. ومع أنه لم يمضِ وقت طويل على دخول هذه التقنيات نشاهد – مع الأسف - أن نتائجها السيئة بدأت تظهر على العوائل.
فهناك عوائل لم تعد العلاقة فيها بتلك القوة بين الأبناء والوالدين؛ إذا صار وقت الطعام قال الابن: "هاتوا لي الطعام!" وإذا دخل البيت رمَى كتبه وأغراضه جانبًا وجلس على الجهاز.. وإن تكلّمتَ لا يسمع ما تقول أبدًا! إلى متى؟ حتى مُنبلَج الصبح! من دون تعب. الضيف يأتي ويذهب؛ عمه، ابن عمه، بنتَ خالها، يكتفي (أو تكتفي) بتحيّة باردة. عواطف الوالدين وتأثير تربيتهما على الأبناء و...إلخ، أصبحت منسية تمامًا. وهذا أول الطريق. ولو استمر الوضع على هذا المنوال إلى أين ستؤول الأمور برأيكم؟!
هذه صورة إجمالية عن اختلاف الأوضاع الاجتماعية بين زماننا وزمان بداية انتصار الثورة. في ذلك الزمان كانت تسلية الأولاد أساسًا الحضور في المسيرات، وكانوا يحضرون فيها بكل نشاط وسرور. أوَيمكن الآن أخذَ الطفل إلى مسيرة؟! يجلس في المنزل متلهّيًا بمشاهدة فلم، أو باللعب، لا يكترث لشيء، حتى إن انقلبَت الدنيا رأسًا على عقب!
هذا إذا لم يكن هناك أيّ شيء إضافي آخر، ولم يكن ثمة أي مانع أو أمور سيّئة أو بذيئة، فإن هذا الانشغال واللهو نفسَه يكفي للحرمان من تقوية العلاقات العاطفية مع العائلة ومع الأصدقاء والأقرباء، وتعلّم أمور من المحيطين به، وما إلى ذلك. أما إذا اقترن بإشاعة المفاسد الأخلاقية، فسيزيد الطين بلّة!
الاختلاف الأساسي بين الخطوتين الأولى والثانية للثورة
هذا أحد الاختلافات الأساسية بين الخطوتين الأولى والثانية للثورة. فمن ناحية أصبحَت هذه التقنيات على جانب من الانتشار بحيث إنها تُشيع الفساد بكل سهولة. ومن ناحية أخرى تعلّم الأعداء أنه لم يعُد هناك داعٍ للذهاب نحو الأعمال العسكرية وما شابه، وأن بإمكانهم تخريب أفكار الشباب وجيل المستقبل عن هذا الطريق. ومن ناحية ثالثة، فإن ذلك الجيل الذي ربَّته الثورة وصقلَته أحداث السنوات العشرة الأولى بعد انتصارها سلّموا المهام إلى جيل لم يعِش تلك الشدائد، ويسعى أبناؤه فقط لتحقيق مطالبهم.
إذًا، الأرضية مهيَّأة، والعامل المقوّي والـمُنَمّي للروحانيات ضعيف، وأسباب بَثّ المفاسد والأفكار والـمُلهيات الضارّة ونموّها مُعَدّة، والعدو أيضًا صَب كل جهده وتركيزه على هذه الحرب الناعمة. هذه هي الفوارق الأساسية بين هاتين المرحلتين.
الـمَهَمّة الأهم في الخطوة الثانية للثورة
الـمَهَمة الأهم التي كانت على عاتق الشباب المتديّن والفئة المحبة للثورة والحريصة عليها، في السنين العشرة الأولى من انتصار الثورة، كانت تهيئة الشباب للذهاب إلى جبهات القتال وإسنادها. كانت هذه القضية هي قضية البلد الأولى. فطيلة العشرة الأولى تقريبًا كانت قضيتنا الأهَم هي الحرب؛ ثمان سنوات من الحرب ليست مزاحًا، وكنّا فيها صفر اليدين! فكان كل شيء محظورًا علينا؛ حتى الأسلاك الشائكة ما كانوا يبيعونها لنا. كان كل اهتمامنا، بل كانت القضية الأولى في البلد آنذاك هو: ماذا نصنع لتلبية احتياجاتنا الداخلية، بأي صورة؟ من جهة، وإعداد الشباب للذهاب إلى الجبهات والقتال من جهة أخرى. وهذه الظروف لم تدُم يومًا واحدًا، ولا يومين، ولا عامًا ولا عامَين. كان من الطبيعي، بعد كل سنة تمضي، أن تضعُف العزائم، لكنّ الله سبحانه وتعالى لطف بنا، وكان الشباب – ببركة تلك النوايا النقية، والإخلاص – يزدادون جهوزية للذهاب إلى جبهات القتال حتى خيّبوا آمال العدو.
فهل يتوجّب علينا اليوم أن نفعل الشيء نفسَه؟! أي: هل قضيّتنا الأهَم اليوم هي القضية العسكرية؟!
من ناحية يمكننا القول: إنّ القضية الأولى اليوم هي الاقتصاد، لأنّ الأمور التي يطالب بها الشعب والشريحة الشابّة لا تنسجم مع المشاكل الاقتصادية التي نعيشها، وأنّ علينا أن نفعل ما يحسّن وضعَهم المعيشي، ويجعلهم ينعمون برفاهية أفضلَ نسبيًّا. وتلاحظون كيف أن تأكيد المسؤولين، على مختلف المستويات وبصور شتّى، يتركّز على الملف الاقتصادي. فلنفترض أن الاقتصاد انتعش بشكل كبير، ولم يعُد لدينا في البلد نقص من الناحية الاقتصادية، وتوافرَت النِعَم، وانتعشَت المِهَن والأرزاق، وعلا الدَّخل، وتحسّن العيش، فهل ستُحَل مشاكل النظام والثورة حينئذ؟! وعلى العكس، إذا بقي ضنَك العيش والصعوبات المادّية فهل ستفشل الثورة ولن تتطور؟!
نصرة الله أجر المؤمنين الصابرين
لنلقي على تاريخ الإسلام نظرة ونتساءل: أعَبر الرفاهية الاقتصادية تقدّم الإسلام أم عبر المشاكل الاقتصادية؟ منذ أن أصبحَت دعوة النبي (صلّى الله عليه وآله) علنية كان المسلمون قلّة، وقد أخرجهم أهلُ مكة من المدينة، فلاذوا بوادٍ جَدْب لا ماء فيه ولا زرع اسمُه "شِعْب أبي طالب". وكان موضعًا لا تمُرّ عليه طريقُ تجارة، ولا فيه دَخل، ولا زراعة، ولا أي شيء! ولم يذهب المسلمون إلى هذا الشِعْب باختيارهم، بل إنّ قريش هي التي طردتهم من مكة. أقامَ المسلمون في شعب أبي طالب، رجالًا ونساءً، شيبًا وشبابًا، أطفالًا ورُضّعًا، مدةَ ثلاث سنين. كان صراخ الأطفال يتعالى أحيانًا من شدة العطش فلا يجدون الماء، وكان على البعض أن يتسلل ليلًا في الخفاء لجلب بضع قِرَب من الماء من مكة أو من بئر زمزم أو من مكان آخر كي لا يموت الأطفال عطشًا أثناء النهار!
بهذه الحال بدأ الإسلام. حتى انتهى الأمر إلى الهجرة، فهاجر النبي (صلّى الله عليه وآله) وأسَّس في يثرب دولة، وأقام مسجدًا، وساعده أهل يثرب، وأصبح للإسلام أنصار، فانتشر. وأخذ المسلمون الذين كانوا يعيشون في مكة تحت الضغوط بالمهاجرة إلى المدينة. كان بعض مَن أتى إلى المدينة من المسلمين لا يملك لباسًا طاهرًا يصلّي به! كان لكل بضعة أشخاص ثوب واحد للصلاة، فكان يصلي به الشخص، ثم يخلعه ويعطيه لشخص ثانٍ ليصلّي. ولم يكن لهم سكَن. كان أمام المسجد مِنَصّة اسمها "الصُفّة" كانوا يعيشون عليها، ولذا فقد سُمّوا بـ"أصحاب الصُفّة". كانت هذه حالُ عددٍ لا بأس به من المسلمين ممّن هاجر من مكة إلى المدينة. أحيانًا يتّفِق أن يتبرّع شخصٌ بطبَق من التمر مثلًا أو يشتري خبزًا ويوزّعه بينهم. ما كان لهم عمل، ولا رأسُمال، ولا سكَن، ولا حياة أُسرية تجعلهم يأنَسون فيها مع زوجةٍ وأولاد، بل كانوا مهاجرين انقطعوا من كل شيء، لا يملكون حتى ثوبًا للصلاة!
استقامة هذا الصنف من المسلمين وثباتهم جعلَت الإسلام يَذيع صيتُه، ولم يمضِ طويل وقت حتى أركَعوا إمبراطوريّتين عالميتين كبيرتين [فارس والروم]. لماذا؟ لأنّ الله تعالى نصرَهم؛ كان لهم إيمان بالله من جهة، كما أنّ الله أخبرهم - من جهة أخرى - بأنكم إن بذلتُم ما بوسعكم ولم تُقَصّروا فإني سأسُد نقصَكم؛ (وَلَقَد نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدرٍ وَأَنتُم أَذِلَّة)،[2] (إِذ تَستَغيثونَ رَبَّكُم فَاستَجابَ لَكُم).[3] يقال إن المسلمين جميعًا كانوا 313 نسَمَة، فأنزل عليهم الله عز وجل في مرّة من المرات ألفَ ملَك، وفي مرة أخرى ثلاثة آلاف ملَك لنصرتهم، فانهزم الأعداء وعادوا خائبين.
السؤال هو: لو كان وضعُ المسلمين الاقتصادي والمالي آنذاك جيدًا أكانت الأمور ستجري بهذا الشكل؟ لا يُدرَى. لو أن حالهم الاقتصادية كانت جيدة فلرُبّما كانوا انشغلوا بالمعاصي والنزوع نحو الدنيا أكثر. بالطبع نحن لا نقول: لا بد من حالة الفقر لكي ينتشر الدين ويقوى! كلا، بل ما نقصده هو أنّ هناك أصنافًا مختلفة من الامتحانات؛ (وَنَبلوكُم بِالشَّرِّ وَالخَيرِ فِتنَة)،[4] (وَبَلَوناهُم بِالحَسَناتِ وَالسَّيِّئات).[5] وفي آية أخرى يبين الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بلامِ القسَم ونون التوكيد الثقيلة: (وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٍ مِنَ الخَوفِ وَالجُوعِ وَنَقصٍ مِنَ الأَموالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرين).[6]
الحظر الاقتصادي أداة لاختبار المسلمين
إن كان هذا هو القرآن، وإن كنا نؤمن بهذا الدين وهذا الكتاب وهذا النبي وهذه السنن، فلا بد أن نستعد لمثل هذه الاختبارات. ولا يعني هذا القول أنّ علينا أن نخلق حالةَ الفقر بأنفسنا، فالله تعالى لم يُعطِ أمرًا بهذا على الإطلاق، لكن المقصود أنه إذا تحقّقَت ظروف الامتحان فلا بد أن نكون متأهّبين لها.
إن إحدى أدوات هذا الامتحان هو ما نعيشه من أنواع الحظر الاقتصادي. وهذا الحظر ليس وليد اليوم والبارحة، بل إن أشكال الحظر هذه بدأت وتفاقمَت منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة، وعلى وجه الخصوص منذ الاستيلاء على وكر التجسس الأمريكي. وكل تطوّر علمي وتقَني جرى في البلد إنما حصل في هذه المدة. والعز الذي نحن نعيشه اليوم هو حصيلة ما تحمّله الجيل الأول للثورة من الصبر والاستقامة في الأعوام العشرة الأولى. فإن أخذَتنا الغفلة وصرنا نميل إلى حب الدنيا واتّباع الهوى، وانصَب هدفُنا على الرفاهية والدَّعَة المادية وأمثال هذه الأمور فليس هناك ما يضمن استمرار هذه النصرة الإلهية، فإنما جاءت هذه النصرة على خلفية: (لَئِنْ صَبَرتُم)،[7] و(إِنْ تَصبِروا وَتَتَّقوا)[8]؛ عندذاك سينصركم الله تعالى. أما إذا انصرفتم نحو الأهواء، ونسيتم الله، وتوجّهتم إلى ما يتوجّه إليه الكفار فإن الله لم يُعطِ أي ضمانات بأنه سيساعدكم وينصركم.
الخطوة الثانية للثورة ومكانة إيران المميزة في المنطقة
لكننا ننعم في هذه المرحلة بنِعَم لم نكن ننعم بها في تلك؛ وهي ما نشهده من تطوّر مادي، وعلمي، وسياسي، والمكانة التي تحظى بها إيران في المنطقة اليوم. إنه ليشُق على المرء أن يصرّح بها، لكنّ الحقيقة هي أن المنافسة اليوم هي مع أمريكا، القوة الكبرى! اليوم إن أرادت أمريكا الإشارة إلى بلد ما بصفته عدوًّا لها فستشير إلى إيران! لم تَعُد تقول: روسيا أو الصين أو الدولة الفلانية؛ فهذه الدول متصالحة أو منسجمة مع أمريكا بشكل من الأشكال. لكن متى ما جرى الخطاب للتعريف بعدوِّ أمريكا يكون هذا العدو هو إيران، وهذا بادٍ في خطابات رؤساء أمريكا، وسيناتوراتهم، وغيرهم من مسؤوليهم. وإيران هذه هي نفسها إيران التي كانت أيام الشاه عميلًا ضعيفًا وخادمًا ذليلًا لأمريكا. لعلكم تذكرون كيف أنه في عُمان (وما محلُّ عُمان من الإعراب في المنطقة أصلًا) اندلعَت فتنة تُدعى "فتنة ظَفار" على يد حزب ماركسي معارض[9]، وقد أمرَت أمريكا شاه إيران في حينها بأن يرسل جُنده لإخماد الفتنة. قال الشاه: "وما شأني أنا؟ ما علاقة عُمان بإيران؟! هناك اندلعَت فتنة، فما شأننا نحن؟! أنتم تريدون هزيمتهم، فلماذا يذهب جنودنا ليُقتلوا هناك؟!" إنها الأوامر! أوَكان أحدٌ يجرؤ على الاعتراض؟! كانت إيران خادمَ سُخرةٍ لأمريكا. فإن كانوا يبيعوننا السلاح فليس لسواد أعيننا، بل لكي ينهبوا في المقابل أضعافًا مضاعفة من نفطنا! هذه كانت مكانة إيران آنذاك، وانظروا إلى مكانتها السياسية والدولية اليوم إلى أين وصلت؟!
المكانة الخاصة للشؤون الثقافية في الخطوة الثانية للثورة
والآن ما خارطة الطريق التي علينا تبَنّيها في المستقبل؟ ففي يوم من الأيام كانت القضية الأولى في بلدنا هي القضية العسكرية، وكان لا بد من التدريب العسكري. تذكرون أنه كان عليكم الخضوع لدورة تدريبية لأربعين يومًا في الجبهة، وكان على أهل البيان والقلم أن يعملوا على تقوية الجبهة لكي لا تخلو من المقاتلين. الإمام الراحل (قدس سره) نفسه كان يوصي بذلك.
أما اليوم فإن قضيتنا هي القضية الثقافية. لاحظوا هذا الضعف على المستوى الثقافي، الذي تبدو مظاهره في المجتمع، وفي مدينة قم بالذات، في جوار مرقد السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها)! كل من يشاهد ذلك يدرك إلى أي مدى هذه المظاهر تنتشر. هذا ونحن في قم! مركز الدين والحوزة والثورة. ولكم أن تُخمّنوا اعتمادًا على ذلك ما الذي يجري في باقي المدن؟!
علماء الدين مسؤولون عن حفظ الدين وتنشئة جيل متدين ثوري
السؤال: أفي رقبتنا [نحن علماء الدين] تجاه هذه القضية واجب أم لا؟ أينبغي أن نكتفي جميعًا بالقول: يجب أن نحسّن اقتصاد الشعب، ونساعد على تحسين وضعهم المعيشي قليلًا، وكفى؟! أليس في رقبتنا أيّ مسؤولية أخرى؟! فلو كان من المقرر تقسيم الأعمال أيضًا فإنّ متخصصي الاقتصاد في البلاد هم من يجب عليهم تحسين الاقتصاد. هذه العِمّة التي نضعها على رؤوسنا هي علامة الدين، وعلينا أن نفكّر في دين الناس. فهناك تجّار متديّنون، وإنّ عليهم أيضًا واجبًا في هذا المجال. وهناك الصُنّاع كذلك، وهؤلاء واجبهم التفكير في الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة. أفَيكون واجبنا نحن أيضًا أن ننفق كل طاقاتنا في هذا المجال نفسه؟! فإن لم يكن واجبُنا هذا فماذا علينا أن نصنع؟ ماذا نفعل لينشأ الجيل القادم مؤمنًا، ويَحفَظ تراث الثورة، بل يُنَمّيه كذلك؟ من أين علينا أن نبدأ؟ وعبر أي طريق؟ وما العوامل التي يجب أن نوظّفها؟
يحتاج هذا المشروع إلى أطروحة، إلى مشورة، إلى نقاش، إلى منهاج.. مناهج ربما تكون طويلة الأمد. لا بد من التخطيط مدة عشر سنين لكي نقطف الثمار بعد انتهائها، لكننا إن لم نفعل اليوم شيئًا فلن نقطف الثمار بعد عشر سنين!
تصوُّري هو أن أهمية هذا الموضوع بالنسبة إلينا واضحة، وهو أنه إن كان في رؤانا نحن نقصٌ ما حول القضايا الاجتماعية والإسلام والدولة الإسلامية وولاية الفقيه فلا بد لنا أولًا من ترميم رؤانا نحن كي لا يكون فينا نحن نقص. ومن ثم نحاول نشر ذلك بين الآخرين، وتدعيم ركائزه، وأن نَعُد هذه الـمَهَمّة واجبَنا الأول بصفتنا علماء دين؛ أي أن يكون واجبنا الأول هو صيانة دين الجيل القادم، وتربيتهم متديّنين ثوريين.
وفّقنا الله وإياكم
والسلام عليكم ورحمة الله
[1]. البلد: الآية4.
[2]. آل عمران: الآية123.
[3]. الأنفال: الآية9.
[4]. الأنبياء: الآية35.
[5]. الأعراف: الآية168.
[6]. البقرة: الآية155.
[7]. النحل: الآية126.
[8]. آل عمران: الآية125.
[9]. جبهة تحرير ظفار.